كتب الدكتور بول طبر
حكم الطوائف في لبنان مسألة ينبغي دراستها بدقة عالية وتفصيل سعياً لفكفكة المنظومة الرمزية التي تحيط بها والتي تعطيها شتى انواع التبريرات لبقائها اساساً للنظام السياسي في لبنان وقاعدة للانتظام الاجتماعي. ولا يبغي الكلام على الطائفية في لبنان المساهمة في وعي الظاهرة فكرياً وحسب، وإنما توظيف هذا الوعي لاجتراح الموقف السياسي والحلول السياسية المناسبة لتجاوزها.
علو مصلحة الطائفية السياسية
يتضح لمن يراقب الوضع السياسي في لبنان أن كل طائفة رئيسية في لبنان تتبنى “قضية وطنية” أساسية وترفع رايتها دفاعاً عنها متجاهلة في الوقت نفسه “قضايا وطنية” أخرى، لا يصح إغفالها في قاموس بناء الأوطان بالمعنى الحديث للكلمة. وهذه الانتقائية في اختيار مكوِّن من مكوِّنات الوطن دون غيره (كاختيار السيادة دون الاهتمام ببناء دولة قادرة على الدفاع عن حدودها في وجه العدوان الاسرائيلي، أو العكس كما في حالة حزب الله وحلفائه) ليست اعتباطيةً. فهي أساساً تشير إلى اعتبار أن تحقيق السيطرة الطائفية هو الأساس، والقضية المرفوعة هي ثانوية ورافعة لتلك السيطرة. ففي صراع الطوائف على اكتساب الموقع المسيْطر في وجه الطوائف المنافِسة، تتقهقر، لا بل تتعطل المفاعيل الموحِّدة والموحَّدة للقضايا الوطنية. وتكون بالتعريف مصلحة الطائفة كمشروع سيطرة هو السقف الذي تنضوي تحته كل القضايا الاخرى. فتمسي السيادة على يد الطائفة التي تتسلح بها من العُدة التي تستخدمها لشد عصبية أبنائها، وليست شعاراً عاماً يجتذب إليه أبناء الوطن كافة، وتصبح مقاومة العدو الإسرائيلي شأناً يخص أبناء الطائفة التي تتبناه، وعاجزاً عن أن يتحول إلى خيار وطني عابر للمناطق والطوائف كلها. النظام الطائفي ومنطق الصراع الذي ينتجه لا يفرز وطناً ومواطنين، بل يوِّلد عصبيات عضوية-أهلية متنازعة يسعى كل منها لتحقيق أعلى درجة من النفوذ والمنافع بالعلاقة مع العصبيات المواجهة له. وتخضع في هذا السياق جميع القضايا الوطنية والسيادية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحتى الشخصية منها، لخدمة هذا المنطق لا غير.
العصب الأهلي والفسحة الضيِّقة لتجاوز نظام الطائفية
غالباً ما يفتخر أنصار الطائفية السياسية في الوسط المسيحي بأنهم أكثر تطوراً من الناحية الإجتماعية والثقافية مقارنة بالطوائف الاسلامية. فالمسيحيون بالنسبة إلى أصحاب هذا الرأي هم أقرب الى الثقافة الغربية “المتحضرة”، ما يجعلهم متفوقين على شركائهم المسلمين، وذلك لأن غالبية الطوائف الإسلامية ترفض الإقتداء بالثقافة الغربية لتناقضها مع القيم الإسلامية التي يؤمنون بها.
ليس المطلوب في سياق هذا المقال إجراء نقد لما سبق من كلام وأحكام، أقل ما يقال فيهما أنهما غير علميين، وإنما المطلوب هو التأكيد للمرة الثانية كيف أن الطوائف (والمقصود هنا هو الطوائف المسيحية) في سياق تنازعها على السلطة والنفوذ، تستخدم كل ما بحوزتها من علاقات وأفكار، وإن كانت مغلوطة، لتقدم ذاتها على أنها “الأفضل والأرقى”. وبالتالي تريد أن تضفي الطابع الشرعي على تمايزها ونفوذها (أو سعيها لكسب هذا النفوذ إذا ما كان متراجعاً) بالعلاقة مع الطوائف المنافسة لها في حقل التمايزات والنفوذ الطائفي. وحتى لو سلمنا جدلاً بالمواصفات الحديثة والمتطورة للعديد من المجتمعات الغربية، فإننا نجد أن محاكاة الطوائف المسيحية لـ “الغرب” لا تتعدى المظاهر، لا سيما على الصعيد الشكلي والإستهلاكي، بينما تبقى تلك الطوائف بعيدة كل البُعد عن خصائص الحداثة والتنوير التي تسمو بالمجتمعات الغربية (رغم قصور هذه المجتمعات عن تحقيق العديد من قيم الحداثة والتنوير لغاية الآن). ففي لبنان يتحول النظام الديموقراطي السائد في المجتمعات الغربية إلى ديموقراطية الطوائف، وحقوق الأفراد المتساوية أمام القانون إلى “حقوق” غير متساوية وتمييزية. أما مبدأ فصل الدين عن السياسة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من حرية المعتقد، فإننا نجد ما هو عكس هذا الأمر في لبنان، حيث الطوائف تتحكم منفردة بالأحوال الشخصية للبنانيين، وتشكل القاعدة الأساسية لانتظام الدولة والمجتمع. وعلى صعيد الأفراد، فإننا نجد الفجوة كبيرة بين القيم والممارسات التي يتمتع بها الفرد في “الغرب”، والقيم السائدة في أوساط المسيحيين. ففي الحالة الأولى، نجد ثقافة المواطنة والحرية الفردية والوعي المدني. أما في الحالة الثانية، فإن القيم والثقافة الأهلية-العضوية هي السائدة (العائلية والجهوية والطائفية)، رغم هجانتها في بعض الأحيان لاختلاطها ببعض القيم الليبرالية الغربية، إلخ.
والأهم في هذا السياق، أنه كلما كانت تتشكل في الوسط المسيحي ظواهر وتجمعات ثقافية وسياسية ناقدة للنظام في لبنان مستفيدة من الثقافة الغربية الحديثة، كما هي في البلدان الغربية (مثقفين ومجموعات ليبرالية وإصلاحية ويسارية)، كان الوسط المسيحي المسيطر يتصدر القيام بمحاربتهم، وحتى طردهم من عملهم ومواطن سكنهم حين كانت الأزمات السياسية والإجتماعية تحتدم (لاحظ ما حدث للتجربة الشهابية، ومصير “حركة الوعي” ورموز “كنيسة من أجل عالمنا” كالمطران غريغوار حداد، وأخيراً، مصير اليساريين وحتى الليبراليين في المناطق المسيحية مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975). وعكس ما يذهب إليه البعض في هذه الأيام بالقول بأن لبنان كان أفضل حالاً أيام سيطرة المارونية السياسية، بالمقارنة مع لبنان ما بعد إتفاق الطائف، حيث تراجعت تلك السيطرة وتقدَّم نفوذ الطوائف الإسلامية، ناسبين هذه الأفضلية إلى خصائص تعود للسياسيين الموارنة والمسيحيين بالذات، ففترة ما قبل الحرب وما حملته من حريات فكرية وسياسية وإعلامية وثقافية (فن ومسرح إلخ.) كانت نتيجة لعاملين أساسيين لا علاقة لهما بنظام الطائفية السياسية، ولا بالطرف المسيحي المسيطر عليه (هناك عوامل إقليمية وعالمية لا نتناولها في هذا السياق). إن تلك الفترة والجوانب الإيجابية التي أفرزتها تعود إلى قناعة القيِّمين عليها (من مثقفين وفنانين وحركات نقابية وعمالية وزراعية وأحزاب ومجموعات سياسية) بضرورة نقد وتجاوز نظام الطائفية السياسية وثقافته. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن نظام الطائفية السياسية الخاضع لسيطرة المارونية السياسية وقتئذٍ استولد نقائضه، ليس فقط داخل الطوائف المسيحية رغم اطباق الزعماء المسيحيين على أبناء هذه الطوائف المعترضين، وإنما أدى إلى استنهاض أبناء الطوائف المستضعفة والمهمَّشة ولجوئهم إلى كل ما نرى فيه الآن من مظاهر إيجابية في فترة ما قبل انفجار الحرب الأهلية عام 1975. وما سهَّل على أبناء تلك الطوائف اللجوء إلى الثقافة الليبرالية الإصلاحية والإنتماء إلى الأحزاب والإيديولوجيات اليسارية والقومية الحديثة (أي اللجوء إلى بعض جوانب الإرث الثقافي الغربي النقدي) كان رخاوة العصب الطائفي، وضعف الأحزاب والمؤسسات الإسلامية وعدم قدرتها في تلك الفترة على ضبط أبناء طوائفها تحت سقف “المصالح” الطائفية التي تتساوى مع مصالح ونفوذ باقي زعماء الطوائف لا أكثر.
نستنتج على ضوء ما سبق أنه من منظور دولة المواطن والحقوق المتساوية، لا فرق بين سيطرة طائفة وأخرى أو سيطرتهم أجمعين بحصص متفاوتة. أما “الزمن الجميل” الذي يشير إليه البعض والذي يعود إلى فترة ما قبل العام 1975، فمرده ليس أفضلية العيش في ظل سيطرة “المارونية السياسية”، وإنما يعود لإنتاج هذه السيطرة، دون قصد المستفيدين منها، لظروف أكثر مؤاتية لثقافة وسياسة ناقضتين للنظام السياسي الطائفي.
أما الآن ومع تعميم تسييس الطوائف وتطييف السياسة، لا داعي للإستغراب من دخولنا النفق المظلم الذي يفرضه علينا زعماء الطوائف أجمعين وأجهزتهم العنفية والرمزية. فمع اشتداد العصب الطائفي لدى جميع الطوائف الرئيسية في لبنان، يمسي المجتمع اللبناني أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المكوث تحت سقف الطوائف وحصد المزيد من الدمار. وإما الاستفادة من الفرصة التاريخية التي قدمتها انتفاضة 17 تشرين الأول العام 2019، والانطلاق منها لبناء مجتمع مدني ودولة مواطن ومواطنة وعدالة إجتماعية مخترقين بذلك جميع السقوف الأهلية والطائفية.


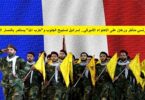





Leave a Comment