كتب محرر الشؤون العربية
عاد الانقلاب الذي نفذه “رئيس مجلس السيادة” الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالسودان سنوات طويلة إلى الوراء. وأعاد تذكير السودانيين والعرب والعالم بتاريخ مديد من الانقلابات العسكرية التي عرفتها البلاد، وقادت إلى استنزاف مقدراتها وتفكيك وحدة ترابها، من خلال ما جرى فرضه عليها من توجهات عسكرية قمعية وسياسات مدمرة، تحتاج معها إلى سنوات طويلة لتجاوز آثارها. والواقع أن الانقلاب الذي شهده السودان مؤخراً وأطاح بالحكومة المدنية التي يرأسها عبد الله حمدوك، لم يقتصر على إطاحة السلطة التنفيذية رئيساً ووزراء واعتقالهم. إذ شمل فيما شمل موظفي الفئة الأولى، الذين جرى تعيينهم منذ قرابة عامين في أعقاب الانتفاضة، وإبعادهم عن الجهاز الإداري للدولة. وانسحب هذا المنحى ليصل إلى حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات المهنية. ما يعني تعطيل كل آليات الحياة السياسية والنقابية، لا سيما مع غياب السلطة التشريعية التي كان من المقرر أن تتم انتخاباتها قبل النصف الأول من العام المقبل. ويتأكد أن ما جرى لم يكن مجرد انقلاب في مراتب السلطة العليا، بل إن هدفه الأبعد هو الانقضاض على كل ما جرى تحقيقه من مكتسبات كرستها الانتفاضة التي أسقطت حكم الرئيس عمر البشير في العام 2019 ، وانتهت إلى حل انتقالي يقضي بتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين. وهو الحل الذي لم يرض طموح العسكريين الذين أدمنوا حكم البلاد خلال عقود متلاحقة. علماً أن هذه الصيغة المزدوجة نجحت في رفع البلاد عن قائمة الدول الراعية للارهاب، وأعادت علاقات السودان العربية والدولية إلى سابق عهدها. كما أنجزت العديد من الاصلاحات، وأبرزها دون منازع على المستوى الداخلي فتح قنوات الحوار مع القوى التي تحمل السلاح في الاقاليم، بهدف الوصول إلى صياغة حلول سلمية لمعضلات البلاد العديدة.
وصورة المشهد في العاصمة الخرطوم ومدن الاقاليم اليوم تبدو أكثر تعقيداً من مجرد انقلاب في ظل أوضاع متأزمة على أكثر من صعيد. وهي أوضاع تحمل مخاطر كبرى، أقل ما يقال فيها أنها قد تفتح أبواب البلاد على مصراعي الحرب الأهلية التي لم تبرأ منها بعد. والواقع أن تحضيرات التوجه نحو تنفيذ الانقلاب كانت واضحة للعيان في الايام والأسابيع السابقة على تنفيذه. من خلال ما شهدته الموانئ في المناطق الشرقية على البحر الاحمر من اقفال وعزل البلاد عن الخارج، وكذلك محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من العسكريين في ايلول الماضي، والتي كانت عبارة عن تحريض للعسكريين على الانقلاب على السلطة المدنية، وتحميل مسؤولية تراجع دور الجيش للبرهان دون سواه. يضاف إليها التظاهرات التي تم تحريكها مؤخراً، وتطالب بحكومة عسكرية بديلاً للحكومة المدنية اللتي تتولى مسؤولية إدارة الدولة. وخلال هذه التطورات كان البرهان يُلمح إلى ضرورة التخلص من الحكومة المدنية برئاسة حمدوك كمدخل لحل الأزمات، علماً أن ما أقدم عليه يمكن وصفه بأنه قمة الأزمات ومنتهاها.
وما عزَّز المنحى الانقلابي ما شهده “تحالف قوى الحرية والتغيير” من انشقاق وضع المنشقين عليه في موضع المتناغم مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، في محاولة لايجاد واقع سياسي جديد، بحيث التقت طروحاتهما من أجل صياغة مستقبل العملية السياسية، سيما مع اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي. فقد طالب “تحالف الميثاق الوطني” المنشقّ عن “تحالف قوى الحرية والتغيير” بإسقاط الحكومة الانتقالية التي يقودها عبدالله حمدوك، وتوسيع القاعدة السياسية للسلطة بغرض تقليص وزن “تحالف قوى الحرية والتغيير” سواء داخل المجلس الانتقالي، أو الحكومة. وبما يجعل من الغلبة في قراراتهما للمكوّن العسكري، وليس لـ “تحالف قوى الحرية والتغيير”. خصوصاً وأن الوثيقة الدستورية نصّت على تشكيل المجلس التشريعي من ثلاثمائة مقعد تتوزّع بواقع 165 مقعداً لقوى “الحرية والتغيير” بنسبة 55%، و75 مقعداً للحركات الموقعة على اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بنسبة 25%، و60 مقعداً للقوى الثورية الأخرى التي لم توقّع على إعلان الحرية والتغيير بالتشاور بين قوى التغيير والمكون العسكري بنسبة 20%. ويتقاطع هدف التلاعب بهذا الاتفاق تماماً مع هدف المكوّن العسكري في مجلس السيادة الانتقالي الذي يدفع بقوة لإقصاء “تحالف قوى الحرية والتغيير”، من خلال إعادة رسم خريطة المشهد السياسي الخاص بالمكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي، لإيجاد حاضنة سياسية موالية للعسكر، وبما يتيح له إحكام القبضة على مفاصل مؤسسات السلطة في البلاد.
والواضح من القرارات التي أعلنها البرهان مباشرة بعد تنفيذ الانقلاب، وعلى طريقة ما سبق وعرفته المنطقة العربية والدول الافريقية منذ الخمسينيات إلى السبعينيات من اجراءات، أنها شملت حل المؤسسات السياسة والإدارية والنقابية ضمن أوهام بإعادة السودان إلى نظام ديكتاتوري أسقطته الانتفاضة الشعبية منذ عامين، ومعه من تحلق حوله من قوى اسلاموية، ساهمت من خلال القمع الذي سلطته على القوى المعارضة في تأزيم أوضاع البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية والمعيشية. وأطلقت التناقضات والصراعات الأثنية والجهوية من عقالها. لذا لم يكن من قبيل الصدفة أن يخرج عشرات الألوف من المواطنين السودانيين بناءً على دعوة القوى الديموقراطية والمهنية المعارضة قاطعين الطرقات ومتظاهرين سلمياً في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى، رفضاً للانقلاب مطالبين بتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتأكيد على العودة إلى الحكومة المدنية والحياة السياسية الطبيعية، وعلى رأسها صيانة الحقوق بالحريات العامة من صحافة وتأسيس نقابات عمالية واتحادات مهنية. وحق التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي المختلف، وهي المقومات التي لعبت دوراً رئيسياً في الانتفاضة. والواقع أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون واعلانهم الاصرار على حماية “ثورتهم”، مرددين أن لا عودة الى “دكتاتورية” أو حكم عسكري في السودان فـ .”الجيش جيش السودان، لا جيش البرهان”، تحمل إشارة واضحة لمدى الوعي الذي يملكه الجمهور السوداني لمدى مخاطر المنحى الديكتاتوري للبرهان وفريقه. والواقع أنه منذ لحظة انطلاقة التظاهرات عمدت القوات المسلحة ليس إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع، بل اطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وكان رئيس الحكومة حمدوك الذي قاد التظاهرات السلمية الاولى قبل اعتقاله قد كتب قائلاً:”إن “المتظاهرين أثبتوا اليوم تمسكهم بالسلمية وبالتحول الديمقراطي”. وجدد تعهده بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، مؤكدا ألا تراجع عن أهداف الثورة. وهو ما ضاعف من استشراس العسكريين بزعامة البرهان.
ويعاني السودان من مسلسل أزمات تبدأ من سد الجيش الأفق أمام حلول سياسية للمعضلات التي تعاني منها الاقاليم، والتي دفعت ببعض القوى إلى مواصلة العصيان والكفاح المسلح وتشكيل وحدات عسكرية مناطقية شبه نظامية. يضاف إليها أزمة اقتصادية مستفحلة تعكسها نسبة تضخم خيالية تصل إلى 400 في المئة، في بلد غني بمناجم الذهب وبالأراضي الزراعية الخصبة كونها توصف بـ “سلة غذاء إفريقيا”.
ويقوم مجلس السيادة السوداني الذي تشكل باتفاق بين المدنيين والعسكريين في آب/أغسطس 2019، مقام السلطة التنفيذية ويضم عسكريين ومدنيين. وينص الاتفاق الذي جرى توقيعه بعد مفاوضات عسيرة على أن تنتقل الرئاسة إلى مدني في نيسان/أبريل 2022، على أن يلي ذلك تنظيم انتخابات تتسلم بموجبها البلاد سلطة مدنية فائزة بأصوات السودانيين. وخلال الأشهر المنصرمة تمسك العسكريون بالسلطة ورفضوا التخلي عما يعتبرونه من مكتسباتهم. وهو ما تصوروا أنه بات من حقهم بعد أن جرى فض اعتصام القيادة العامة في 3 حزيران/ يونيو 2019، والذي أسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل من المتظاهرين وجرح أكثر من خمسمئةٍ آخرين برصاص قوات الأمن. والواضح أن المؤسسة العسكرية كانت تضمر منذ ذلك الحين تجريد قوى المعارضة من مقومات القوة، ما يتيح لها التلاعب بالمرحلة الانتقالية على النحو الذي قامت به في تنفيذ مغامرتها الهوجاء. صحيح أن العلاقة بين المدنيين والعسكريين وشراكتهما لم تكن على ما يرام، لكن دافع الاستئثار بالحكم، وتوهم القدرة على إملاء الشروط والذي قاد إلى عرقلة متابعة الاصلاحات والسير نحو حل المشكلات المستعصية، هو الذي انتهى بأصحاب المطاف للقيام بهذه الخطوة الخطيرة.
على أي حال يمكن القول إن الانقلاب السوداني اصطدم بجدارين أولهما داخلي من خلال التظاهرات السلمية التي عمت البلاد، ووقوف القطاعات وشرائح المجتمع إلى جانب الحكومة المدنية، ومن ضمنها أكثر من عشر سفراء للبلاد في الخارج. وثانيهما في الموقف الدولي الذي عبر عن نفسه بأشكال من التضامن مع الحكومة المدنية والحياة السياسية ومطالبة بالافراج عن المعتقلين. الأمر الذي لم يعد بمكنة الدول التي تقف إلى جانب البرهان تغطية فعلته التي أعادت السودان إلى مربع الأزمة الأول والتي تهدد برجعته عقوداً إلى الوراء على الأصعدة كافة.
إن تنفيذ الانقلاب في هذا الوقت بالذات هدفه منع انتقال السلطة إلى المدنيين، وتحويل تشكيل المجلس التشريعي إلى مجرد حدث فولوكلوري لصالح العسكريين ومن يتبعهم من قوى متضررة من الانتفاضة. وهو ما ينطبق على المفوضيات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية. ونختم بالتحذير من مغبة انزلاق السودان إلى مستنقع نزاع مسلح أوسع، لا أحد يستطيع أن يحدد مداه ونتائجه ومتى تكتب خاتمته، لا سيما مع وجود ثمانية جيوش على أرضه، وتوافر من يمكن أن يمدها بتدفقات في السلاح والعتاد، والتي تتغذى من وقائع ونزعات انفصالية وتصدّعات إثنية وجهوية ومناطقية، معطوفة على أزمة اقتصادية تطحن البلاد وأهلها.


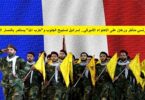





Leave a Comment