الدكتور بول طبر
السؤال الذي يطرحه الراغبون في اصلاح النظام في لبنان أم في تغييره هو التالي: لماذا هذه المهمة تبدو وكأنها شبه مستحيلة؟ مع عدم الاغفال بأن العديد من هؤلاء قد استسلموا للأمر الواقع، كل بطريقته. وبالتالي تخلوا عن الإنخراط والمساهمة في المهمة الاصلاحية أو التغييرية من الأساس.
الجواب على هذا السؤال هو موضوع هذا المقال، وسوف اقوم بصياغته من باب الكلام على السلطة وأحزابها والنظام من جهة، ومن باب مناقشة مقاربة الراغبين في التغيير ومواقعهم الإجتماعية وادواتهم الفكرية -السياسية والاطر التي ينتظمون في داخلها. ولا تستقيم هذه المقاربة من دون النظر في تفاعل هذين العامليْن وتأثير كل منهما على الآخر.
عندما تطالب الفئات المعارضة بتغيير النظام، وقد تكون فئات شعبية عريضة، أو قوى سياسية منظَّمة مدعومة من فئات أجتماعية ذات وزن، أو الإثنتين معاً، فهدفها يكون عادة تعديل جزئي أو تغيير كلي للنظام السياسي، والدعوة لإقالة القوى السياسية التي تتولى حكم البلد وإخضاعه لقراراتها المتعلقة بشؤونه السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية. أما تحقيق هذا الهدف، فيتوقف في جانب أساسي منه على طبيعة النظام والوسائل المستخدمة من جانب القوى السياسية الحاكمة دفاعاً عنه.
فما هي الخصائص التي تميِّز النظام في لبنان، وكيف تتصرف القوى السياسية الأساسية في لبنان في سياق الدفاع عن وجودها ومصالحها بالإستناد إلى البنية الأساسية للنظام اللبناني؟
أولاً، النظام السياسي في لبنان هو نظام ديموقراطي، وإنما ديموقراطيته تجمع بين إعطاء حقوق مشتركة للبنانيين كأفراد، وبين منحهم حقوق غير متساوية كجماعات طائفية متنوعة. وعلى هذا المستوى الحقوقي – السياسي، يؤسس النظام السياسي في لبنان لديناميكية سياسية كفيلة بأن تنسف الحقوق المشتركة للبنانيين واللبنانيات (عن طريق تكريس حق كل طائفة في رعاية الأحوال الشخصية لأبنائها وبناتها والتمييز بينهم في الحقوق السياسية. وأن تستنفر العصبيات الطائفية في وجه بعضها البعض، وصولاً إلى الإنزلاق إلى نحو إندلاع حروب أهلية “ساخنة”، خصوصاً عندما يتسنى لإحدى القوى السياسية للطوائف الأساسية في البلد، أو لتحالف ممثلي أكثر من طائفة، أن تطالب بتعديل حصتها في السلطة. كما حصل خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1989، أو كما يحصل ولا يزال على مستوى التأويل والتطبيق السياسي لدستور الطائف، وذلك منذ الشروع بتطبيقه عام 1990 (بدعة الترويكا والثلث الضامن بعد اتفاق الدوحة عام 2008).
من المفيد أن نطلق على ما أسميناه بالمستوى الحقوقي-السياسي للنظام السياسي في لبنان تعبير “حقل الدولة” تمييزاً له عن “الحقول” الأخرى ومنها “الحقل السياسي”. و”الحقل” بحسب كتابات بورديو هو كناية عن فضاء شبه مستقل يتكون من علاقات ومواقع غير متساوية بين أفراد ومؤسسات يتنافسون باستمرار فيما بينهم لامتلاك حصة من “الرأسمال” العائد إلى الحقل (في حالة حقل الدولة، فهو “الرأسمال الدولتي”، ويكون الشخص الذي يحتل الموقع الأقوى في مؤسسات الدولة هو الطرف الأقوى في علاقاته مع الأشخاص الذين يحتلون مواقع تمنحهم نفوذاً أقل). وكذلك يمكن لهذا التنافس أن يطال محدِّدات هذا الرأسمال سعياً وراء إعادة تعريفه، وجعله الأقوى بين “الرساميل” الأخرى في مجال تحديد علاقات السيطرة في المجتمع المعني، من جهة أخرى (في حالة لبنان، يسيطر “الرأسمال الدولتي الطائفي” و”الرأسمال السياسي الطائفي” في تحديد الشكل الطائفي الطاغي للدولة وللقوى السياسية وممارساتها. وكذلك فإن قوة ونفوذ الشكل الطائفي لهذيْن الرأسماليْن تجعل من الطائفية مبدءاً أساسياً في انتظام جانب أساسي من جوانب الحقل الإقتصادي والحقل الإجتماعي، كما سنوضح ذلك لاحقاً).
“حقل دولتي طائفي” و”حقل سياسي طائفي” يستحضران (وفي الاستحضار صياغة وتكوين لِـ) مجموعات طائفية متصارعة، لها رهاناتها كمجموعات وكأفراد. ولكي تبرع هذه المجموعات والأفراد في آداء الأدوار واحتلال المواقع المتوفرة في الحقل المعني، لا بدّ لهم من أن يكونوا متمرسين في كيفية التصرف المناسب حسب قواعد اللعبة المتاحة في كل حقل. ويصل هذا التمرس إلى أعلى درجة من الإتقان والإحتراف عندما يستبطن اللاعب (واللاعبة) قواعد اللعبة لدرجة أنها تتحول إلى جزءٍ مكونٍ من “الهابيتوس” الذي يمتلكه. عندئذٍ تتخذ الأفكاروالسلوكيات والتوقعات (الطائفية بالطبع) مكانة لا يرقى إليها الشك، ولا يدنو منها التساؤل حول صفتها “الشرعية” ولا من كونها “تحصيل حاصل” وتحمل صفة البداهة. بهذا التوصيف لحقل الدولة وللحقل السياسي نكون قد كشفنا مساهمتهما في تأمين غلبة الإنتظام والولاء الطائفييْن في عمل الدولة وسلوك من يديرون مؤسساتها وفي العمل السياسي والفاعلين فيه، الهادفين كل من موقعه للوصول إلى الدولة والإحتفاظ بالسيطرة عليها.
ولمزيد من توضيح دور هذين الحقليْن في رسوخ ومناعة الإنتظام الطائفي، لا يجوز إغفال “المنافع” التي توفرها “الدولة” لرعايا الطوائف، ويوفرها السياسيون الذين يصلون إلى مراكز السلطة ومواقع النفوذ عبر آليات العمل السياسي الطائفي. هناك أولاً، الوظائف التي توفرها الدولة في القطاع العام والقطاع المشترك بين الدولة والمؤسسات الخاصة. أضف إلى ذلك حصة السياسيين النافذين من الوظائف التي يؤمنها القطاع الخاص، وهي حصة ونفوذ لا يستهان بهما كما بيَّنت الأبحاث الميدانية التي أجريتها (نفوذ السياسيين يطال الترقية الوظائفية أيضاً، وأنا لا أتناول في هذا السياق حصة السياسيين من الأرباح).
هذه الوقائع تثبت سطوة “الرأسمال الطائفي” وغلبته نسبة إلى الرساميل التي تنتمي ليس فقط إلى حقل الدولة والحقل السياسي، وإنما أيضاً إلى الحقل الإقتصادي (ليس المجال متاحاً في هذه المقالة لبرهنة غلبة “الرأسمال الطائفي” أيضاً في تحديد بنية الحقل الإجتماعي والحقل الثقافي، خصوصاً التربوي).
في ضوء هذه الوقائع يقفز السؤال عن شروط التغيير والقوى صاحبة المصلحة في التغيير والقادرة على تحقيقه. إن طغيان وسطوة الرأسمال الطائفي المشار إليه يجعل من خلق هذه الشروط والقوى التغييرية الملازمة لهذه الشروط ليست سهلة المنال (ولكن غير مستحيلة). غلبة الرأسمال الطائفي كما أشرنا سابقاً تعود أيضاً إلى قدرته على امتصاص الأزمات التي يولدها باستمرار، وذلك تحت عناوين أصبحت مألوفة لدى اللبنانيين ولكن مقبولة في الوقت نفسه: ألأزمة بسبب طغيان طائفة على طائفة أو طوائف أخرى، غياب الميثاقية، حقوق الطوائف ووضع حد لشعورها بالغبن أو الإستعلاء على الطوائف الأخرى. ومع امتلاك الطوائف (زعمائها) الوكالات الحصرية لمكونات الوطن، تتحول أزمة النظام الطائفي إلى “انتهاك السيادة” من قبل هذا الطرف أو “غياب الوطنية” لدى الطرف الآخر. أسوق هذا الكلام لأوضح أن مصدر قوة الرأسمال الطائفي يعود ليس فقط إلى سيادته في معظم الحقول التي يتألف منها المجتمع اللبناني، وإنما أيضاً إلى قدرته على حل أزماته المتناسلة بالطريقة التي لا تعرِّض وجوده لخطر الزوال.
في هذا السياق، يصبح من الضروري النظر في كيفية تحويل ضحايا النظام الطائفي من فئات ترى في الطائفة “الأخرى” وخياراتها السبب الأهم في أزمتها وفي أزمة النظام ككل، إلى فئات تسعى لحل أزمتها بالخروج على منطق “الرأسمال الطائفي” والشروع في العمل لإحلال منطق “رأسمال المواطنة” بديلاً عنه. هنا تنتصب أمامنا عوائق عديدة أهمها، الضعف البنيوي للرأسمالية في لبنان، وبالتالي هشاشة وتشرذم القوى الإجتماعية التي تفرزها (مثلاً، أغلبية القوى العاملة في لبنان تعمل في مؤسسات لا يتجاوز عدد العمال فيها أصابع اليدين)، والتي تملك المصلحة في تجاوز اللعبة الطائفية والإنتظام طبقياً وحقوقياً في سعيها لإيجاد الحلول لمشاكلها. إلى ذلك، نجد أن سوق العمل (كما فرص الاستثمار) التابع للرأسمالية اللبنانية يخضع للإعتبارات الطائفية والأهلية -عائلية ومناطقية- كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فالرأسمالية العاجزة عن بناء خطوط مواصلات تربط المناطق اللبنانية كما تفعل سكك الحديد والقطارات في البلدان الرأسمالية المتطورة، تكون عاجزة عن فرز الفئات الإجتماعية القادرة على بناء الوطن والمواطنة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن فئات واسعة من الطبقة الوسطى ذات المصلحة في تجاوز النظام الطائفي قد أفرزتها الرأسمالية اللبنانية، لا سيما منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه بدلاً من أن تتحول هذه الفئات إلى قوة سياسية وازنة تدعو إلى التغيير وتجاوز الطائفية حلاً لمعضلاتها، خصوصاً عندما تتقلص فرص العمل في السوق اللبناني ويدخل لبنان في أزمة مستعصية كما حدث منذ تشرين الأول من عام 2019، نجدها تهاجر لبنان بأعداد ضخمة، الأمر الذي يؤدي فيما يؤدي إليه إلى امتصاص قدرة هذه الطبقة على تغيير النظام وغياب العدد المطلوب لتحقيق ذلك. وفوق ذلك، يقوم المهاجر بمد الرأسمالية اللبنانية بشريان حيوي آخر يتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي يرسلها إلى لبنان سنوياً. تقوم هذه التحويلات بدعم النظام بطريقتين: ألأولى تتمثل بتوفير الدولار الأمريكي (العملة الصعبة) لرأسمالية تعاني من عجز دائم في ميزان المدفوعات، والثانية باعتماد المقيمين على تلك التحويلات الى الحد الذي يجعلهم يتجنبون مشقة العمل على تغيير النظام السائد.
أخيراً لا بدّ من ذكر أن القوى والمجموعات التي أفرزتها إنتفاضة 17 تشرين (وأنا هنا أتجنب الكلام على دور أحزاب اليسار ودورهم في استحالة تحقيق التغيير المنشود، فهذا يتطلب مقالاً خاصاً)، تعكس في تكوينها الإجتماعي والتنظيمي، وفي الوعي السياسي الذي تمتلكه، الكثير من المعضلات البنيوية التي ذكرتها أعلاه. فهي في معظمها شبابية تنتمي إلى فئات الطبقة الوسطى. وهي مجموعات وقوى لم تتمكن من جذب فئات من الطبقة البرجوازية أو الطبقة الكادحة إلى جانب دعوتها للتغيير (الأولى ضعيفة التكوين الصناعي-الإنتاجي ومنتفعة من النظام الطائفي، والثانية هشَّة ومشرذمة ومخترقة بالعلاقات الطائفية). وحتى أنها عجزت عن اجتذاب معظم أفراد الطبقة التي تنتمي إليها وراء دعوتها لتغيير النظام وإصلاحه. ويعود هذا العجز أولاً، إلى انتظام البعض في الأطر الطائفية التي أمنت لها وظائفها. وثانياً إلى انتشار ثقافة “الأن جي أوز” NGO>Sفي التغيير وأدواته في أوساطها، وهي ثقافة مستوحاة من بلدان مؤسسات الدولة والمواطنة فيها مترسخة سلفاً، وثالثاً، لأن هذه الطبقة عانت من هجرة متصاعدة لأبنائها، كما جرت العادة في أوقات الأزمات المستفحلة.
بدأنا المقال بطرح السؤال عن الأسباب التي تجعل من تغيير النظام في لبنان مهمة شبه مستحيلة، وحاولنا أن نقدم بعض العناصر الأولية للإجابة على السؤال. والإستنتاج الأساسي لما تقدم هو أنه من دون وعي الصعوبات التي تواجه قوى التغيير في لبنان، نكون قد أضفنا عنصراً آخرَ من عناصر استعصاء التغيير في لبنان نحو المواطنة والحرية والعدالة الإجتماعية.


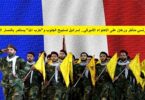





Leave a Comment