كتب طارق متري
المدن ـ يوم الجمعة ـ 11 حزيران 2021
لسنا بحاجة إلى ذكر الأمثلة، وهي كثيرة، لنبيّن أن طائفية الطائفيين تحمي فساد الفاسدين. بطبيعة الحال، الفساد مشكلة أخلاقية ومسألة سياسية. وكذلك هي الطائفية، أي التعصب لجماعة، أيا كان من حرارة الالتزام بقيم دين او مذهب. بهذا المعنى، كما في المصطلح السياسي-الحقوقي اللبناني، تشتمل الطائفية على ما صار يسمى المذهبية بلغة شائعة تستخدم الكلام في غير موضعه. والطوائف عندنا جماعات أهلية، كأنها عائلات ممتدة او عشائر كبيرة، وهي ايضا “جماعات متخيلة” يعيد النظام السياسي انتاجها كيانا اجتماعيا وحقوقيا. ولا يخفى اذاً تأثير الطائفية في نواحي الحياة كلها. لذلك فإن القول بمكافحة الفساد مرشّح دائما للخضوع لما تأمر به الحسابات الطائفية والمصالح السياسية المتصلة بها، أي انه محكوم بعلاقات الخصومة. فقليلاً ما نرى جهة سياسية تخاصم أخرى لأنها فاسدة، فيما نجد جهات كثيرة لا تتردّد في وصم خصومها بالفساد. وكأن الخصومة هي الأصل. أما الموقف من فساد الآخرين فهو لاحق لتلك الخصومة ويتغيّر بتغيّرها. وتقع الخصومة، وهي كثيراً ما تكون طائفية، في قلب دوافع البعض حين يجاهرون بمكافحة الفساد ويستعجلون استثمارها في الصراع السياسي.
تختلف هذه القضية وسبل معالجتها، جملة، عند المعارضين أو الثائرين على القوى السياسية برمّتها. فالدعوة إلى محاربة الفساد هي أولى دعواتهم وهي بمثابة المدخل إلى مشاركتهم في الحياة العامة ومنطلق تجمّعهم وائتلاف بعضهم، مها كانت الدوافع المختلطة. وهي تفسّر التبنّي الباكر وشبه العفوي للصرخة الرائجة “كلّن يعني كلّن”. وهذه الأخيرة إدانة لا تنقصها المبرّرات وتشمل القوى السياسية والسياسيين كافة، أي من دون تمييز بينهم. وهي توحي برغبة صادقة في إنهاء حكم الحكام وسيطرة الزعماء والأحزاب، في اتفاقهم وافتراقهم. وبالسعي الى تكوين بديل منهم.
الحرج الطائفي وغيابه
غير ان صرخة البعض لا تخلو من الالتباس، وهو صنو الخلط والتعميم. فليس الكل بريئاً من الحذر الطائفي المضمر. فمحاربة الفساد تبدأ بتسمية الفاسدين وكشف مواضع فسادهم ووقائعه المثبتة ومحاولات اخفائها. صحيح أن المعارضين والثوار سمّوا البعض وسعوا إلى فضح سلوكه. لكنه صحيح أيضاً أن الصرخة التي تأخذ الكل بما فعله الجزء، وإن كان كبيراً أو كبيراً جدّاً، تعفي فئة من مطلقيها من صعوبات التدقيق والتخصيص. كما ترفع عنها شيئاً من الحرج الطائفي. ذلك إن المعارض أو الثائر إذا سمّى فاسدين من طائفته تعرّض لاتهامه باستسهال الهجوم على من يشاركه الانتماء الطائفي والتوجّس من مواجهة الفاسدين من طوائف أخرى. وإذا هاجم فاسدين من طائفة أخرى نسبت اليه بواعث طائفية. وفيما يتعدى الفساد بمعناه الضيّق، نلاحظ عند البعض ترددا في الذهاب بالمعارضة السياسية الى ابعد خوفا من ان تتحول عند الآخرين استفزازا طائفيا خبيثا فيردون عليه بهجوم طائفي صريح.
ليس القصد، معاذ الله، التقليل ممّا شهدناه من وعي لأهمية قيم المواطنة اللاطائفية، والتي كثيراً ما تنعت بالمدنية، ورسوخها في قلوب وعقول الشابات والشبان الذين خرجوا بصورة تلقائية من انتماءاتهم الضيّقة وتحرّروا من العصبيات الطائفية وألقوا بذورا في حقول السياسة. إنما القصد هو الإشارة إلى ان غياب الطائفية السافرة لا يلغي وجود قدر من الارتباك الطائفي عند بعضهم، فهو ما زال مقيماً بيننا. أضف اليه العجز، حتى الآن، عن تشكيل قوى سياسية جديدة لا تضم متشابهين فحسب بل تتسع فعلاً لانتماءات متنوّعة وتعلو على الفوارق الطائفية في الاجتماع والسياسة والثقافة، ما ظهر منها وما استتر.
يكاد الارتباك الطائفي الحالي عند فئة من المعارضين للسلطة يشبه ما كان بالماضي أقرب إلى الخجل الطائفي، حين كانت الطائفية تنعت بالبغيضة لا عند المفاخرين برفضها فحسب بل أيضاً عند من تلوّن سلوكه بها مختاراً، أو مضطراً حسب ظنّه، وقبل بها قبوله لقدر لا فكاك منه.
بالمقابل، لم تعد الطائفية محرجة عند الكثيرين، لا في حماية الفساد ولا في مختلف مجالات الحياة العامة. فلا تضطر عند البعض إلى ارتداء الأقنعة، او تغطية المطالبة الطائفية بالقضايا الوطنية الكبرى. وزادت النعرات. وطغت سياسات الهوية في تصارعها على الدولة وفي تقوّيض وحدتها، أيا كانت الحجة، وفي محاولة استتباع مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى. في حقيقة الأمر، تراجعت فكرة المواطنة. وباتت الشراكة في القيم بوصفها شرط المواطنة أكثر تأزماً. ذلك ان القيم المشتركة لا تبدو راسخة حتى تمنع دون تحوّل الاختلاف الى تناقض جذري ينذر بالعنف ويوقظ الفتنة. وظهر انها غير قادرة على انتاج معايير وأعراف تسمح بتعامل عقلاني مع التعارض في المواقف. بعبارة أخرى، باتت المواطنة في مواجهة العصبيات المتجددة، او بالأحرى التي يعاد اختراعها. وتضاعفت المشقة في تغليب المصيريات على الصغائر. ورأى عدد من الشابات والشبان ان هذه المشقة طالت.
الانتماء الطائفي وجذور المواطنة
لم يكن لبنان، مثله كمثل الكثير من الدول الحديثة، وليد ارادة ابنائه في العيش معا. تألف من جماعات طائفية مقيمة على ارض واحدة ومتجاورة، في تقارب مرة وتباعد في مرة أخرى. جاءت تلك الجماعات من التاريخ العثماني. وفيما بدّدت نشأة لبنان شيئا من الحيرة والمخاوف التي اعترت البعض، انضم البعض الآخر اليه، او ضمّ، من دون حماس يذكر وأقام طويلا على التردّد وازدواج الموقف. لم تخرج الجماعات كلها من مرحلة الإنهيار العثماني وهي مطمئنة الى مستقبلها. غير ان المجتمعات الأهلية، ومن سادها او قادها من ورثة الزعماء والوجهاء الجدد، رضيت مختارة او مضطرّة الى اقامة علاقات جديدة فيما بينها وان لم تفارقها، الّا جزئيا، ذاكرة الحذر المتبادل والأحكام المسبقة. ونمت هذه العلاقات الجديدة بفعل الإختلاط والجيرة، في السكن والعمل، والإشتراك في حياة سياسية اولية واكتساب طرائق عيش متقاربة. لم يصنع الخروج من العوالم التقليدية بقوة ذاته مواطنين لبنانيين. صحيح ايضا ان أهل لبنان باتوا لبنانيين، وان لم تكن لبنانيّتهم واحدة في السياسة والثقافة. ألّفوا، كل على طريقته، بين الهوية الوطنية وبين الانتماء الى الجماعة الطائفية، اي بين وعي للذات الجمعية أقرب الى الرخاوة وآخر يبدو أكثر صلابة. وحال النظام السياسي القائم على التوازن بين الجماعات وتوزيع المناصب بين ممثليها دون تحقيق ما كان يدعى انصهارا او اندماجا وطنيا. بقي اللبنانيون متأرجحين بين النزعة الى المساواة بينهم ووحدة الأهداف الوطنية وبين الدفاع عن جماعاتهم الخاصة ومصالحها المفترضة. وفي الأعم الأغلب، تواصل ذهاب اللبنانيين وإيابهم بين قطبي الوطن والطائفة. وحاول عدد غير قليل منهم التوفيق بين الإنتماء الى كليهما. ورغم الخلافات والسجالات حول الهوية اللبنانية، اتسع نطاق العيش معا وانفتحت أمام الأفراد عدة مجالات للاستقلال عن الجماعة.
لم تصبح المواطنة حقيقة ظاهرة وفاعلة في ظرف محدّد او مناسبة بعينها. لكن جذورها نبتت في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، الى ان عصفت بها الحروب اللبنانية والملبننة منذ سنة 1975. فعاد الإنتماء الى الرسوخ في أرض الجماعات. واقترن الفعل السياسي، فضلا عن المواجهات العسكرية، بتفوّق الانتماءات الطائفية على المواطنة المستجدّة. ومما زاد في الطين بلّه عجز اللبنانيين عن التلاقي حول بنى ورموز وطنية توحّد بينهم، فضلا عن لجوئهم، طوعا او كرها، الى طلب الحماية الفعلية او المعنوية من طوائفهم، اي من القوى المسيطرة عليها والمستبدة في تدبير شؤونها.
غير انه وبفعل اشتداد النزاع على السلطة، ومعه مشكلات التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتلاقي التدخلات الخارجية مع الرغبة في الاستعانة بها، جاءت تفجّرات لبنان طائفية بمقدار كبير، وخاصة بعد عام 1975. فبات الكثيرون يردّون على الطائفية بالطائفية وكأنها داء ودواء في الوقت عينه. وفي ظنهم، صارت وكأنها حامية ضحاياها. لكن فئة أخرى نظرت اليها، لا سيما في جولات الصراع المسلح، وكأنها تفترس ابناءها.
الطائفية واعاقة الديموقراطية
ومع التسوية التي وضعت حدا للحروب، ظهر الحنين للدولة الواحدة والنفور من الغلو الطائفي والتطرف السياسي. وبدأنا نلحظ بروز لبنانية مستعادة هي ثمرة تصالح بين الانتماءات المتنوعة.
غير ان فئات واسعة من اللبنانيين لم تر ان مواطنة الفرد لا تنسجم مع قواعد العضوية في جمهور متجانس، أصنعه الانتظام الاجتماعي أو السياسي أو العداء لجمهور آخر أو الخوف من منه أو الصراع معه على السلطة. أكثر من ذلك، لم تلق مواطنة الفرد وعدم التضييق عليه في هويته الطائفية قبولا واسعا. وعلى السنة الكثيرين، أضحى العيش المشترك، حسب المصطلح الذي يحلو للبنانيين ترداده حتى أنه وضع في نص الدستور، كناية للحديث عن تقاسم السلطة بين الطوائف أو بالأحرى بين القوى ذات التمثيل السياسي الأوسع لها. وألبس تارة لبوس الوحدة الوطنية او الميثاقية وحسب طوراً يحسب رديف الديموقراطية التوافقية. غير أن العيش المشترك، بوصفه لقاءاً بين مواطنين يقوم على احياء الرغبة في البقاء معاً، يفترض اختلاطاً وتبادلاً وتفاعلاً في الاقتصاد والاجتماع والثقافة. ويقتضي أيضاً شراكة في القيم. تعزّزها ممارسة الديموقراطية. ولو أن نفس الإنسان الأمارة بالسوء، لا سيما سوء الاستئثار والاقصاء، كثيرا ما تهدّد الديموقراطية او تتلاعب بها، ولكنها رغم ذلك، او بسبب منه، تجعلها ضرورة.
فالعصبيات التي تتنازع الدولة، ولا تؤمن فعلياً بالمساواة السياسية والقانونية بين المواطنين، تتصارع على الغنيمة من جهة وتتلاعب بالدستور والقوانين وتستحوذ على المؤسسات. وهي في مواجهة دائمة مع الوعي الديموقراطي. وما الإصرار على توافقية الديموقراطية إلا اعتراف بأولية تلك العصبيات التي تسعى دائماً لتوكيد اولية الهوية الطائفية والتي تضيق بالتنوع داخل الجماعات. فسياسات الهوية الرائجة ما تنفك تسعى الى تحقيق اللحمة بين ابناء الجماعة وتأمين الانصياع الى زعامات الجماعات، التقليدية او الناشئة، طريقا الى ضمان وجودها والحفاظ على حقوقها المفترضة. وبظل التشديد على تمثّل قوة كل جماعة والحؤول دون استضعافها من الآخرين ورفع الخلافات إلى مستوى وجودي، تصبح ممارسة الحرية في التمايز عن المواقف الجمعية عيبا او حطا من قدر الذات الجمعية.
ولم يخضع الصراع الاجتماعي والسياسي والعلاقات بين الجماعات للقواعد الديموقراطية الا بنسبة محدودة. ويعيدنا هذا الواقع الى بداهة القول ان المواطنة تقوم على وعي أكبر بالمساواة بين الناس الذين يعيشون على أرض واحدة والى تحقيق استقلال الدولة عن السلطة، سلطة الجماعات المتواجهة او المتنافسة. فمن يمثلون الطوائف اللبنانية في الدولة مهتمون اولا بالصراع عليها ويقيم بعضهم دولة داخل الدولة وخارجها. ولهم سياساتهم في كثير من نواحي الحياة وعلاقاتهم الخارجية، بما تحتمله من ولاءات وانحيازات. كما لهم منظماتهم الأهلية وحصصا فيما يطلق عليه جملة نعت “المجتمع المدني”. ويتصرفون، إذا اقتضى الأمر، كأصحاب سلطان اشداء يهدّدون ويردعون ويحرّمون ويخوّنون.
وبفعل ذلك زادت الدولة الضعيفة ضعفا ومعها الهيئات غير الطائفية والحديثة التي تأسست على مبادئ تتعالى على العصبيات التقليدية وضمت في صفوفها لبنانيين من طوائف ومناطق مختلفة. وتحولّت فئة من وسائل الاعلام، التقليدية والجديدة، عن وظيفتها الأولى لتصبح ادوات للدعاية والتعبئة وشيطنة الخصوم والتحريض ضدهم.
هل من سبيل الى تجاوز الطائفية؟
واليوم، ما زالت المثابرة في نقد الطائفية مقتصرة على اعداد من الشباب ومن اهل الثقافة. فهم يدركون الحاجة اليه، ربما أكثر من سواهم. بطبيعة الحال ليس من مواطنة حقيقية في لبنان من دون تكوّن كتلة كبيرة من المواطنين الآتين من كل الجماعات. لكن التحرر من عصبيات الجماعات ومن الولاءات لزعمائها في مد وجزر متواصلين. وتبقى الهوة كبيرة بين الاقتناع المبدئي والانزلاق الى ما خلّفته في الأنفس الصور والأحكام التي صنعتها العداوات والمخاوف.
لا شك ان مجالات جديدة انفتحت امام الحرية والمبادرة واللقاء والتعاضد في فضاءات بعيدة من الإنقسامات الطائفية. وبعد عقود من الإنشغال بصناعة العداوات وبالقتال وعبادة الأصنام والزعماء رأينا فئة آخذة بالإتساع تخرج من الكتل الطائفية المتراصة وتتحرر من الإنقياد الأعمى ولا ترضى بذوبان حرية الفرد في انتظام الجمهور.
قبل ذلك، كان اتفاق الطائف أقرب الى التعامل الواقعي مع الطائفية. ولم يغب عن التغييرات في النظام السياسي التي اتى بها اعترافه بقوة الطائفية فقال بالمناصفة وبالتوازن بين الطوائف. لكنه جاء مشدودا الى تجاوز النظام الطائفي وأقرّ إنشاء مجلسين، واحد للنواب ينتخب حرا من القيد الطائفي وآخر للشيوخ يجري اختياره ممثلا للطوائف ومطمئنا لها. غير اننا، في واقع الأمر، لم يتقدّم اللبنانيون خطوة واحدة نحو التجاوز المذكور. ويعزو نواف سلام ذلك، في كتابه “لبنان بين الأمس واليوم”، الى غياب ميزان قوى داخلي يسمح بوضع لبنان على طريق فعلي لتجاوز الطائفية.
فالحياة السياسية لم تعرف نموا يذكر لحركات عابرة للطوائف او جامعة لأبنائها. واستمر تراجع “العيش المشترك” في السكن والتلاقي على مقاعد الدراسة وفي مجالات العمل. وبظل تراجعه زاد الحديث عنه فصار، كالتشديد على وحدة لبنان، بمثابة تعويض رمزي صغير عن هشاشة الرابطة الوطنية. غير أن “الثقافة المشتركة”، وان غاب تعبيرها السياسي أو تعثّر، تظل مشدودة الى قضيتي المواطنة والدولة. ولعل العمل الحق في بناء المواطنة يتطلب وجود اعداد كبيرة من الناس، يعون أنفسهم بوصفهم مواطنين لا تلهيهم عن تأكيد خيارهم اي ميول ظرفية او مصالح صغيرة. المواطنون ما صاروا أكثرية لأن الخلافات تستغرق المجتمع اللبناني في معظمه ولا تترك مجالاً كافياً الائتلاف حول أهداف لا تحتمل المحاصّـة بين الطوائف. لم تتخلّ فئات واسعة عن عاداتها الطائفية. صحيح اننا شهدنا تحالفات سياسية ما بين قوى من طوائف مختلفة لكنها لم تغيّر العلاقات الفعلية بين ابناء الطوائف المعنيّة بها.
لا تبدو الأحكام القيمية التي يطلقها مناهضو الطائفية قادرة بقوة ذاتها على مقارعة النظام الطائفي، الراسخ في السياسة كما في المجتمع. أكثر من ذلك، ليس الغاء الطائفية السياسية، وهو محل اختلاف في معناه وفي كيفية الوصول اليه، مشروعا سياسيا قابلا للتنفيذ في المدى المنظور. فلا يمتلك المنادون به التأثير المعنوي الكافي لإقناع الناس به، لا سيما وان بينهم من يصعب عليه التحرر من ولاءاته الطائفية فلا يستطيع ان يبدد الخشية من ان يؤدي الغاء الطائفية السياسية لا الى المساواة في المواطنة بل الى نوع من الغلبة الطائفية.
ثم ان الغاء الطائفية لا يتحقق بمعزل عن تغيير حقيقي في المجتمع، أي بتجاوز الطائفية الاجتماعية. وهو عسير التحقيق من دون تجاور وتشارك وتبادل وتفاعل أكبر بين اللبنانيين ومن دون تأكيد حرية الفرد وحقوقه، بما فيها حقّه بالاستقلال عن الجماعة. في هذا المجال، يسلك نواف سلام في طريق الواقعية فلا يضع الانتماء الطائفي وحرية الفرد في مواجهة. لكنه يقرّ بوجود توتّر بينهما. كما يرى ان المنطقين، الطائفي والفردي، يتعايشان اليوم في لبنان. ويضيف ان مسؤولية إعاقة نمو المواطنة تقع على الدولة والنظام السياسي القائم نظرا لترجيحه حقوق الطوائف على حساب حقوق الأفراد. ويعيدنا الى المسألة السياسية حيث يولي أهمية كبيرة لظهور تشكيلات سياسية مدنية ذات بعد وطني غير طائفي.
فهل نشهد ظهورا لها قريبا؟


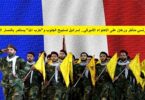





Leave a Comment