حاوره: ياسين النابلي مهدي العش*
المفكرة: في ظل هذا الاختناق البدائِلي، الذي يُهدّد أفكارا كبرى مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما هو الأفق التجاوزي الذي بالإمكان التفكير فيه؟
الحاج صالح: فكرة حقوق الإنسان لا تَعوم خارج الأطر السياسية للمجتمعات الحديثة، والإطار الأساسي المهيمن هنا هو الدولة – الأمة. أوافق على نقد حنة آرنت لفكرة حقوق الإنسان بأن الأمر يتعلق بالأحرى بحق في الحقوق مرهون بوجود جماعة سياسية، وليس بالفرد المجرد. لكن حتى وجود جماعة سياسية مثل الدولة الأمة لا يضمن أنها إطار للحق في الحقوق إلا في بعض البلدان، مثلما نعرف جيداً في بلداننا. وحتى في بلدان الديمقراطية الليبرالية، فإن الحقوق تشهد تراجعاً يطال المهاجرين والملوّنين واللاجئين. ولكن دينامية التراجع قد تشمل بعد قليل فئات أوسع، بما فيها الإثنية السائدة. وهذا جزء من أجندة النضال في الفترة المقبلة، فنحن نواكب أزمنة مفصلية على المستوى العالمي، تجعلني أكاد أقول أنّنا في حاجة إلى ”أفق اشتراكي جديد“، وإن بدلالة مختلفة لفكرة الاشتراكية. والدلالة التي أفضّل أن تُعطَى للاشتراكية اليوم هي الانفتاح على الغائب: المهاجر، اللاّجئ، النساء، المقهورين، المهمّشين، وعلى البيئة لأن لدينا مشكلة عالمية تتمثل في مشكلة البيئة الحية. هذا كله مُغيّب. الديمقراطية اليوم تَقوم على حوار ثنائي بين”أنا“ و”أنت“؛ أما الثالث، ”هو“ و”هي“ و”هم“ و”هن“، للعاقل وغير العاقل، ليسوا موجودين، غائبين. الاشتراكية هي حضور الغائبين. واليوم نشاهد تراجعاً حتى عن الحوار بين أنا وأنت، وفي ألمانيا حيث أقيم حالياً، عوضا عن الحوار (Dialogue) يسود المونولوغ (Monologue) بخصوص غزة، وهو نوع من العقيدة الرسمية وفرض الرقابة التي تقارب محاكم التفتيش، حيث يُمكن أن يُسأَل كل فرد؛ هل تدعم إسرائيل؟ وهذا إن حصل فهو سيضع ألمانيا بأقرب موقع إلى التوتاليتارية منذ سقوط النازية. فعوض أن تُحلّ أزمة الحوار باتجاه تعددي يستوعب الغائب، نرى أنها تحل في اتّجاه العودة للعقيدة الرسمية، أي في اتّجاه”المونولوغ“ والصوت الواحد. قبل ستين عاماً، وُجدَت في فرنسا حركة يسارية بقيادة كورنيليوس كاستوريادس، باسم الاشتراكية أو البربرية، وهو اسم مجلة الحركة كذلك، تيمّنا بشعار كانت طرحته روزا لوكمسبورغ قبل اغتيالها عام 1919. اليوم يبدو لي وجيهاً طرح شعار يقول الاشتراكية أو التوتاليتارية. تعدّد الأصوات وإلا فالصوت الواحد والعقيدة الرسمية.
الديمقراطية هي المسرح الذي يَحضر فيه الغائبون. لكن من أيام أثينا في الزمن الكلاسيكي استَبعدَت الديمقراطية الأثينية النساء والأجانب والعبيد. الفئات الأشد فقراً وتهميشًا هم في حكم عبيد الأمس، وليس الطبقة العاملة بالمعنى الكلاسيكي الواسع. والنساء لا يزلنَ بوضع المُغيّبات بدرجات متفاوتة، في مجتمعاتنا أكثر من مجتمعات الغرب. والأجانب اليوم هم المهاجرون واللاجئون. يُضاف إليهم غائب رابع هو البيئة التي تُشكّل الإطار الحي للحياة. لذلك أريد أن أفكّر في الاشتراكية من خلال هذا الاتجاه، الذي بإمكانه أن يكون منشّطاً للخيال السياسي، لأننا نفتقد إلى نوع من الطّوبَى والصور المُحفّزة للتفكير السياسي الجديد. والديمقراطية لا تحمي الحقوق إلا بقدر ما توجد دينامية لتجاوز الديمقراطية ذاتها، وإذا لم توجد هذه الدينامية تجنح الديمقراطية لأن تصير شكلية ومُفرغة كحالها اليوم. ما يُنقذ الديمقراطية هو شيء يتجاوزها. لذلك من المهمّ بناء تقاليد نضالية جديدة، لأن هناك أزمة خيال مثلما قال كثيرون، بينهم علاء عبد الفتاح، سجين نظام السيسي طوال معظم السنوات العشرة الماضية. لقد افتقرنا بالفعل إلى الإبداعية الفكرية والتنظيمية في العقود الأخيرة. وفي أوساط اليسار وغيره سيطرت الحساسية الليبرالية، والفردانية جداً، والمشتتة والمنفصلة عن قوى اجتماعية حية، والتي تنزع لأن تعرف نفسها بالضدّ لأنها لا تملك شيئاً إيجابياً تعرف نفسها به.
أعتقد أنه بهذا الاتجاه يُمكن أن تُحمَى فكرة حقوق الإنسان عبر تجاوزها نحو الحق في الحقوق، كشيء غير مرتبط بالدولة الأمة، وإنما كشيء مرتبط بفكرة النضال لتجاوز الأوضاع الحالية في العالم.
المفكرة: على الصعيد العربي، لطالما تم تأجيل المطلب الديمقراطي باسم أولوية الاشتراكية أحياناً أو توفير الخبز قبل الحرية، برأيك كيف نقرأ هذا الجدل بخاصة في ظل حالة التراجع الديمقراطي والاجتماعي في أكثر من بلد عربي؟
الحاج صالح: اسمَح لي بالعودة قليلا إلى مساري الشخصي. أنا كُنت شيوعياً معارضاً للنظام السوري على أرضيّة ديمقراطية، في واحد من أوّل الأحزاب الشيوعيّة العربية التي أعادت الاعتبار لقضيّة الديمقراطيّة، بالاستفادة من كتابات ياسين الحافظ (1930-1978)، المفكر السوري الذي تُوفي شابّاً قبل نهاية السبعينات. في ذلك الوقت، كانت الفكرة الديمقراطية ذات بُعد مناقض لاتجاه ”اشتراكيّة الأمر الواقع“ القائمة في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقيّة، والتي بدأت في التخثّر على الأقلّ منذ ستينات القرن العشرين. هذه الاشتراكية كانت أحادية الصوت، ليس فيها ثنائية مثل الديمقرطية، ولا تعدّدية بطبيعة الحال. ولكن ما أُهدر في تجربة الحركات الديمقراطية ذات الأصول اليسارية في المجال العربي هي الفكرة التي تحدثت عنها سابقاً، ومفادها أنّ الديمقراطية تكون بخير كلّما كانت هناك دينامية لتجاوزها. في المجال العربي، أعتقد أنّه من المهمّ أن ينفتح تفكير الديمقراطيّين، وأتحدث أيضاً عن نفسي بقدر من النقد الذاتي، على ما يتّصل أكثر بمطالب الشعب الحياتية، بامتلاك الناس لحياتهم، وعلى أفق نسوي يخترق الأسرة والمجتمع، وأفق ثالث بيئي. نحتاج ذلك من دون شكّ إلى المزيد من التفاصيل والإكساء، ولكن هذا هو الأفق الاشتراكي الذي أتحدّث عنه. أظنّ أنّ تناولنا لفكرة الديمقراطية في الفترة الأخيرة استنفد طاقته كي يأتي بجديد. ربما لسنا نحن، الذين كنا شيوعيّين وأصبحنا ديمقراطيّين بعد ذلك، وأسمي جيلي ”جيل الاستدراك“، مؤهّلين لذلك. أعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح في سنوات شبابنا، لكن هل لا يزال ذلك هو الشيء الصحيح اليوم؟
لا أعتقد أنّ الديمقراطيّة كما تُطرح حاليا تُخاطب شرائح واسعة، إذا لم تُفتح على شيء يتجاوز باتجاه امتلاك الحياة، أو إن شئنا بلغة ماركسية تقليديّة، ما يتصل بعلاقات الإنتاج وتوزيع الثروة. إذا استمرّينا في الحديث عن الديمقراطية بالمعنى الليبرالي، وهو حديث مثقفين من الطبقة الوسطى، فلن ننجح في إرسائها، خصوصا وأنّ الديمقراطية الليبرالية في أزمة. حان الوقت لتجاوز السؤال حول توطين الديمقراطية، وما إذا كانت لدينا تقاليد ديمقراطية. على العكس من ذلك، ما دَامت الديمقراطيّة في أزمة، فنحن نظرياً في موقع يؤهّلنا للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة باتجاه أفق اشتراكي. ولا أقصد بذلك التجربة التاريخية الاشتراكيّة. فما حصل في هذه التجربة كان التضحية بالديمقراطيّة، أو النكوص إلى الصوت الواحد بدل السير قدماً نحو تعدد الأصوات. إذ لم تَعد الاشتراكيّة تجاوزاً ثلاثي الأبعاد للديمقراطيّة ثنائيّة الأبعاد التي تجاوزت بدورها الليبراليّة أحاديّة البعد، وإنما على العكس، تحوّلت الاشتراكيّة إلى البعد الواحد والصوت الواحد، حيث فُرضَت كعقيدة رسميّة. ما أحاول قوله، هو أنّ ما يحمي الديمقراطيّة هو شيء يَتجاوزها، ينفتح على الغائب أو المغيّب. والغياب مصنوع سياسياً بعلاقات السلطة والثروة والمعرفة.
يجب أيضا أن نقطَع مع هذا الابتزاز المُخادع بين الخبز والحرية. فالانشغال الحصري بالخبز لا يضحّي فقط بالحرية سلفاً، وإنما بالخبز أيضاً. هناك نظريات مهمّة، مثل أعمال أمارتيا سين، حول أنّ التنمية حريّة. وهذا ما أقصده بتملّك الناس لحياتهم؛ من الحياة المادّية إلى الحياة السياسيّة العامّة. وواضح جداً أن مجاعة الغزيين اليوم، ووقوع ما يفوق 90% من السوريين تحت خط الفقر بحسب أرقام الأمم المتحدة، أن الجوع مصنوع سياسياً، في صلة وثيقة تنظم الإبادة السياسية (بوليتيسايد) والقتل الجماعي على الهوية (جينوسايد) في البلدين المنكوبين. لا ننسى أنّ الحكم الأسدي رفع شعار الجوع أو الركوع أثناء حصاره لمناطق متعددة في البلد بين 2013 و2018. ما يضمن الخبز هو حصراً ما يتجاوزه إلى الحرية، وهو ألاّ يعامل المواطنون كأدوات. من يُضحّي بالحرية من أجل الخبز سيَخسرهما معًا. وما يحمِيهما معًا هو أفق لتجاوزهما، بشرط أن يكون أفقًا ديناميّا وغير مفروض من فوق.
المفكرة: أنت حاليا مُقيم بألمانيا. كيف واكبتَ ردود فعل السلطات الألمانية وجزء من النخب إزاء ما حصل من عدوان على غزة؟
الحاج صالح: بعد أسبوع فقط من بداية الحرب على غزّة، سافرت وقضيّت شهرًا خارج ألمانيا. لذلك لم أعشْ مباشرة أسوَأ فترات الاعتداء على المظاهرات المناصرة لفلسطين واستهداف الكوفيّة والعلم الفلسطيني. يبدو لي أنّ ألمانيا اليوم أقرب إلى التوتاليتاريّة من أيّ وقت مضى منذ التجربة النازية. مع احترامي للبلد والثقافة والمجتمع وثرائه التاريخي، لا يمكن أن نُنكر أنّ بعض أوجه هذا التاريخ كانت شديدة الإجراميّة، وأهمّها النازية والحرب العالميّة الثانية. وفي الحقيقة قبل ذلك أيضا في ناميبيا، حيث حصلت أوّل إبادة في القرن العشرين. بعد الحرب العالميّة الثانية والهولوكوست، تَمركَز الوعي الذاتي الألماني حول التكفير عن هذه الجريمة، مع شعور بمسؤوليّة خاصّة تجاه اليهود. في حدّ ذاته هذا شيء إيجابي ومفهوم. ولكن الإشكال هو أنّ فكرة “never again” أو ”لن يحصل مثل ذلك مجدداً“، يحمل تأويلا ضيّقا يقول بأنه ”لن يحصل ذلك مجدداً فقط تجاه اليهود“، فكأنما لا بأس أن يحدث ما يقاربه لغيرهم. لكن صار يصر بعنف على أنه لا يمكن حدوث ما يقارب الهولوكوست. أصبحت كلّ مقارنة للهولوكوست مع إبادات أخرى تُعتبر تنسيباً لإبادة اليهود أو حتى تتفيهًا لها. يمكن فهم ذلك بالعُقدة المرضيّة التي سبّبتها جريمة الإبادة الرهيبة التي ارتكبها النازيون، والتي شملت، إلى جانب اليهود، الغجر والمعوّقين والمثليين جنسيا. ما لا يُفهم، هو تحويل هذه العقدة المرضيّة إلى معيار عالمي للسّواء. ما يتّصل بعقدة جَمْعية لشعب في علاقة بجانب شديد السوء في تاريخه لا يُمكن أن يُعمّم على الآخرين. فقط الشمولية يمكن أن تطلب من فلسطيني أو سوري أو عربي أن يعترف بحقّ إسرائيل في الوجود ودعمِها. نحن ليس لدينا هذه الذاكرة ولم نشارك في هذه الجريمة، ومعنى إسرائيل فيما يخصنا هو الاستعمار والعنصرية والتطهير العرقي، وليس النجاة الأمان ”وقلعة الغرب“، مثلما قد يكون في نظر الألمان. نحن ضحايا إسرائيل. ليس فقط الفلسطينيّين بل السوريّون تأثروا أيضاً. وحتى إذا سلّمنا بالمنطق الوطني الغبيّ الذي يقول أنّ فلسطين لا تعنينا كسوريّين، فإن إسرائيل تحتلّ أيضا أرضًا سوريّة. فكيف تريدونني أن أعترف بإسرائيل؟ هذا حتى لو وضعنا بين قوسين الانحيازات القيمية والأخلاقية وما يتصل باعتبارات العدالة، وكلها تضع المرء في صفّ فلسطين وضد إسرائيل.
وأتصور أن مركزة الوعي الألماني حول الهولوكوست ليس تعبيرا عن غيريّة بقدر ما يعبّر عن نرجسيّة. أكاد أقول أنّ المسألة ليست حتى حول اليهود، بقدر ما تتعلّق بأن يُعطي الألمان أنفسهم شعورا طيّباً، بحثاً عن اكتفاء ذاتي نرجسي. شعار ”ألمانيا فوق الجميع“ يعود، لكن بطريقة أخرى. تفكير الألمان يبقى حول أنفسهم، الفرق هو أنّه موجّه إلى آثام وذنوب الماضي. ألمانيا لم تخرج بعد من نرجسيّتها نحو غيريّة مُعَافاة وحقيقيّة فيما أرى.
* نُشرت المقابلة على موقع المفكرة القانونية بتاريخ 15 آذار 2024


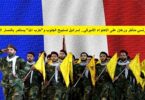





Leave a Comment