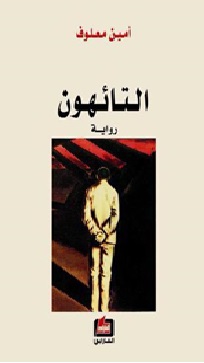قصة جيل ووطن يتأرجحان بين الحياة والموت
كتبت عائدة خدّاج أبي فراج
رواية * أمين معلوف التائهون هي قصة وطن وجيل من أبنائه، تبدأ عشية إندلاع الحرب الأهليّة، وتستمر حتى الزمن الراهن. قصة واقع مرير إمتدّ من الماضي إلى الحاضر، ويستمر إلى مستقبل مكفهر، مجهول المعالم، تلفه غشاوة من الغموض، تحجب الرؤية والآفاق. إنها قصة وطن مريض يتأرجح بين الحياة والموت.
يمسك بخيط الأحداث راوٍ هو المؤرخ آدم الذي ينسج خيوط أحداث الرواية من معلومات وإعترافات ورسائل الأصدقاء التائهين. أصدقاء لاذوا بالفرار، وتاهوا في جهات الأرض الأربع بعدما غمر الطوفان البلد وصَعُبَ الإصلاح. في الرواية، تتشابك القصص، وتتداخل القضايا، ويتحول كل من الأصدقاء إلى راوٍ يحكي قصته، بل يعرض قضيّته التي يتناقش حولها الأصدقاء، ويتحاورون إلى درجة العدائيّة الودودة أحياناً، «التي تبقي عقولهم متيقظة، وتجنبهم ويلات التقيد بالأعراف والتقالييد».
“التائهون”، الذين لايشبهون طوائفهم بشيء، هم أصدقاء الأمس. جمعتهم المبادىء الثوريّة الكبرى التي وعدت بالمساواة، والحريّة، وزوال الطبقيّة، وحريّة الشعوب في تقرير مصيرها، وحريّة الرأي والتعبير، ونبذ الطائفية والعشائريّة. هم شلّة من الطلاب الجامعيين، يعتمرون قبعة تشي غيفارا، وينتمون إلى طوائف وجماعات مختلفة. يجتمع الأصدقاء في بيت صديقهم مراد، أو في مطعم «القانون المدني»، الذي يرمز إلى المساواة بالمواطنة، ليتناقشوا حول قضايا وجوديّة كبرى، هادفين إلى تغيير مجرى الأحداث، ليس على أرض الوطن فقط، بل في العالم برمته.
حاولوا تأليف «أخويّة»، أو «مجمع أدبي»، أو «حركة سياسيّة» يبدأ منها التغيير. ولشدة ما تناقشوا، لقبوا بـ «البيزنطيين»، لكن «هذه البيزنطيّة هي التي جعلت هذه «الأخويّة» لا تبصر النور»، والتي تحولت أحياناً إلى طوباويّة تقارب الأحلام.
حاول الأصدقاء إحياء قصة بلزاك الرجال الثلاثة عشر، التي تطرح فكرة إمكانيّة تغيير العالم بواسطة أصدقاء مخلصين، يحملون طموحات مشتركة ويناضلون من أجل قضيّة واحدة. أليس هذا ما طرحه أيضاً المفكر الإشتراكي روجيه غارودي حول فكرة قيام حزب يضم أصحاب القضيّة الواحدة، بعدما خيبت آماله ممارسات قيادات ما بعد الثورات الكبرى، وتبدد حلمه بعد “منعطف الإشتراكيّة الكبير“؟
وشلة الأصدقاء هذه، أليست هي نفسها الحركة الطلابيّة التي شهدها الوطن والعالم، خاصة فرنسا، في أواخر الستينيات و أوائل السبعينيات؟ ألم يجاهر هؤلاء الطلاب بآرائهم الجسورة، وواجهوا رصاص السلطات القمعيّة أثناء التظاهرات؟ ألم تفرز هذه الحركة كبار الكتاب والمفكرين والشعراء، والمؤرخين، وآدام الراوي هو واحد منهم؟
و جاءت النتيجة واحدة. لقد تبدد حلم التغيير، ورحّل الأمل، لأن «الحرب الأهلية مرّت من هنا». فانساق كل من الأصدقاء، وبفضل هذه الحرب العبثية، إلى شرنقته الطائفيّة، وإلى سجن عقيدته الإيمانيّة التي لم يخترها بنفسه، بل فرضتها عليه هويته منذ الولادة، رجعوا مسيحيين أو مسلمين، أو يهوداً، و عادوا إلى حضن الرسل، والأنبياء والقديسين، إلى «بيت بمنازل كثيرة»، الذي إستفاض المؤرخ كمال الصليبي في الكلام عنه. بيت يضم عشائر، وطوائف تمترس كل واحدة منها وراء منظومة فكريّة، وعقائديّة، ودينيّة، وعشائريّة منذ القرن الحادي عشر.
لقد كان الأصدقاء من أتباع فولتير، وكامو، وسارتر، ونيتشه، أو حتى السرياليين. واستهوتم المقاومة الوطنيّة في فيتنام، وبوليفيا، ,إسبانيا. لكن «الحرب الأهليّة مرت من هنا»، فلم يسلم منها بيت، أو حي، أو منطقة. لقد أفسدت الحرب كل شيء، « الصداقة، والحب، والإخلاص، و صلات القربى، والإيمان، والوفاء وكذلك الموت…، حتى الموت يبدو مشوها،ً ملطخاً».
ويتساءل أحد الأصدقاء: « هل النزاعات التي تعصف ببلدنا مجرد إشتباكات بين قبائل وبين عشائر، وبين عصابات مختلفة من الزعران، أم أن لديها بعدا ًأكثر إتساعاً، ومضمونا ًأخلاقياً؟ وهل كان الأمر يستحق أن ينخرط فيها المرء ويلاقي حتفه»؟.
أما سميراميس، وهي واحدة من الأصدقاء الذين لم يغادروا البلد فعانوا ويلات الحرب وذاقوا مرارتها، تضيف قائلة: «إنها ليست حرب… لأن الحروب كانت كثيرة. لم يكن المتحاربون أنفسهم، وساحات المعارك نفسها… في بعض الأحيان تورطت فيها جيوش غريبة… كانت النزاعات تحصل بين طائفتين، وأخرى داخل الطائفة الواحدة. أنا لم أقتل، لكن الرغبة ساورتني… لقتل كل الزعماء، وتجريد الشباب من الأسلحة.»
وكأن الزمن لم يبرح مكانه في هذا الوطن المشرذم والمصلوب على خشبة الطائفية. أما زال الشباب يتظاهرون في الساحات، وينادون بتنحي الزعماء وإسقاطهم؟
ويدلي الراوي برأيه هو الآخر، ويتساءل إن كنا سنمضي حياتنا بأكملها دون أن تسنح لنا الفرصة للإنخراط في معركة تستحق النضال، و هل هناك «قضيّة عادلة يدافع عنها البشر الأنقياء، الجديرون بالثقة؟» ويضيف بحزن وأسى:
«كانت الحياة ستكون جميلة لو لم تندلع الحرب… لو لم يمت أي واحد منا، لو لم يخن أي واحد منا، لو ظل وطننا لؤلؤة الشرق، لو لم نصبح أضحوكة العالم، وهاجسه، وفزاعته، وكبش فدائه…، ولو، ولو، ولو».
ألم تصبح كلمة” اللبننة”، مرادفا ًللفوضى وللحروب العبثية التي تقض مضجع العالم بعد الحرب الاهلية اللبنانية؟
وتتوسع دائرة الحوار، ويحتدم النقاش حول موضوعة الحرب، فيدلي رامز المهندس الذي تاه في العالم العربي، مصدر النفط والثروات، والذي أثرى بدوره وامتلك القصور والطائرات الخاصة، ويعتبر أن التقهقر والتراجع لم يصب وطننا فقط، بل المشرق برمته. و يعتريه الحزن «لأني أرى قومي في أسفل الهاوية. فمن ينطقون بلغتي، ومن يعتنقون ديانتي (الإسلام) يُحقرون في كل مكان… إنني أنتمي بحكم الولادة إلى حضارة مهزومة… و أنا المحكوم بالعيش مع هذه الوصمة على جبيني… فأنا بالنسبة للأوروبيين همجي صاحب ثروة… إن قرنا ً مشؤوما ً قد إنتهى… و إن قرنا ً جديدا ً يلوح و هو أكثر شؤماً… وأرغب أن أعرف بأي صلصة سنؤكل».
ولنعيم الشاب اليهودي الذي رحلته الحرب الأهليّة هو وعائلته إلى البرازيل، رأيه أيضاً. فيعيد أسباب إندلاع الحرب الأهليّة إلى جذورها التاريخيّة، إلى بداية القرن العشرين، وتحديدا ً «إلى الحرب الكونيّة الأولى عام 1914، وغاز الخردل وثورة أكتوبر… مبادىء الشيوعية لقد آمنت بها، وآمن بها الجميع… لكننا تعرضنا للخيانة… فذلك التوق لتحقيق المساواة بين البشر تحول إلى مشروع توتاليتاري». فالمشرق ومن ضمنه أبناء الوطن، يدفعون اليوم ثمن مذبحة الخنادق، ومعاهدة فرساي التي أدت إلى الحروب اللاحقة، ونتج عنها الإنتدابان الفرنسي والبريطاني للمنطقة، ولربما تمتد جذورها إلى أبعد من ذلك، إلى زمن “المسألة الشرقيّة “حين تكالب الغرب على تقاسم تركة “السلطنة العثمانية”، وعلى السيطرة على المسالك البحريّة والبريّة الموصلة إلى الشرق موطن التوابل والخيرات، ولاحقا ً للسيطرة على النفط وآباره.
«أن النفط نقمة، تسببت أمواله بالحروب الأهليّة، والانقلابات الدمويّة. فالنفط لم يحقق الثروة للعرب، إلا للتعجيل في هلاكهم».
ويحدد المؤرخ آدم المعضلة بأمرين: «أنّ القرن المنصرم شهد عقيدتين مدمرتين: الشيوعيّة ومناهضة الشيوعيّة».
“أما معضلة القرن الواحد والعشرين فهي أسوأ من السابق. فهذا القرن يعدنا بمصيبتين: الأصوليّة الإسلاميّة، ومعاداة الأصوليّة الإسلاميّة، وهذا ما جعل العالم ينغمس في الهمجيّة”.
ويبرر آدم الراوي هروبه وهروب أصدقائه من الوطن، ويتساءل ماذا كان بوسعهم ان يقدموه لوطن “لا نستطيع فيه إيجاد وظيفة، ولا تلقى رعاية صحيّة، ولا إيجاد المسكن، ولا الإستفادة من التعليم، ولا الإنتخاب بحريّة، ولا التعبير عن الرأي”. فهم لم يرحلوا بملء إرادتهم، بل لأن البلد الذي كانوا يحلمون بأن يعيشوا فيه مرفوعي الرأس، كان أول الراحلين.
وتتوالى القصص في الرواية، ويدور النقاش بين الأصدقاء، ويتحول كل واحد منهم إلى راوٍ يحكي قصته ويعرض قضيّته. والقصة المحور التي تربط خيط الأحداث منذ البداية حتى النهاية، هي قصة مراد. كان مراد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة إليهم. يجتمعون في بيته، ويضمهم تحت جناحيه، يأخذون برأيه، ويمتثلون لمواقفه. جمع الشباب في مقتبل العمر، ويعود فيجمع “التائهين” بعد إنقضاء قرابة الربع قرن من الزمن بطلب من زوجته تانيا، وهي واحدة من الأصدقاء، بعد وفاته. مراد لم يغادر الوطن بسبب تعلقه به. فهو الجبلي المتمسك ببيته وأرضه اللذين يرمزان إلى الوطن، فحارب للدفاع عنهما كالوحش الضاري.
قام مراد بالتنازلات التي قادته إلى إرتكاب المحظور والخيانة. كان خطأه الذي لا يغتفر أنه لجأ إلى الغريب، واستقوى بغزاة الوطن. تفانى في خدمتهم و سعى لاستخدامهم ضد خصومه المحليين، وسلّم أمره” للمفوض السامي”، فأصبح وزيرا ً نافذأً، وثريا ً كبيراً. واشترى مصرفا ًبمال الحرام، والرشوة والعمولات، والإبتزاز، والنهب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال. فخان مبادءه وتلطخت يداه بالدم وبكافة أنواع المعاصي. لذلك يرفض آدم تأبينه، وحضور مراسم دفنه تجنباً لمصافحة أمثاله من تجار الحرب، رغم وجوده في البلد الذي عاد اليه لرؤية مراد ونزولاً عند رغبته قبل رحيله، لوصل ما انقطع بين الصديقين. ولكن تعذر اللقاء لأن مراد قد فارق الحياة قبل وصول صديقه.
ويدور النقاش مجدداً، وتطرح قصة الصحافي اليهودي نعيم وقضيّة الصراع العربي الإسرائيلي على بساط البحث، بعد عودة نعيم من البرازيل للقاء الأصدقاء بعد رحيل مراد. يطرح والد نعيم اليهودي المعتدل الذي عايش القضيّة منذ بدايتها، الموضوع كي يقنع إبنه نعيم بمرافقة العائلة إلى البرازيل على الرغم من حبه وتمسكه بالبلد، ورفضه اللجوء إلى إسرائيل التي تقوم على غير وجه حق. فالطائفة اليهوديّة، بالنسبة اليه، في طور الاندثار في العالم العربي والمشرقي. اما الوضع في اوروبا فقد كان أسوأ بكثير، تراوح بين المعتزلات والمحارق، والتهجير وحمامات الدم على يد النازيّة. وما لم يقله والد نعيم كان قد أكده هيغل في فلسفة التاريخ: “أن بداية الحروب الصليبيّة، جرت على أرض الغرب حيث ذُبِحَ عدة آلاف من اليهود، وثمَّ الإستيلاء على ممتلكاتم، وبعدها بدأ العالم المسيحي زحفه” باتجاه القدس بل الشرق.
ولكن ما أن خفَّ العداء للسامية، حتى تلى الغرب فعل الندامة، و دعم قيام دولة إسرائيل سياسيّاً وعسكريّاً في قلب فلسطين العربيّة. وقد لعبت بريطانيا رأس حربة في قيام هذا الكيان الصهيوني. لكن الوضع ازداد سوءاً في بلدنا وفي المنطقة .«إن قيام دولة إسرائيل أسفر عن كارثة وعداء». ثم يضيف” يحق لنا ان ندعو فلسطين أرض إسرائيل، و يحق لنا أن نعيش فيها مثلما يحق ذلك للأخرين، لكن لا يحق لنا أن نقول للعرب إرحلوا… مهما كان تأويلنا للنصوص (التوراتيّة والتلموديّة) ومهما بلغت معاناتنا… إن الاسرائيليين تحولوا من حمل إلى ذئب… ومن المشين الاعتداء على سكان مدنيين عزل”.
ويضيف المؤرخ آدم رأياً آخر حول القضيّة ويقول: أن الخلاف ليس إقليمياً، إنه صراع الحضارات بين الغرب والإسلام. فحين أدرك العرب أن الهجرة اليهوديّة هي لإحتلال الأرض واستملاكها، وطردهم إلى أرض الشتات، حملوا السلاح للدفاع عن أرضهم و كرامتهم. لكنهم مُنيوا بالهزيمة تلو الأخرى، فتزعزع العالم العربي والعالم الإسلامي. لم يأت اليهود كمدنيين عزل بل كجيوش غازية مدعومة من الغرب. فاليهود الذين عانوا مما عانوه في الغرب من قمع وإقصاء، لم يتوانوا عن إعادة المأساة في حق الشعب الفلسطيني.
وتتوالى سبل الهروب، فالصديق ألبير، الشاب المثلي الذي يعيش في كنف جدّه “كغصن مقطوع من شجرة” حسب تعبير الأصدقاء، إختار الإنتحار كأقصر طريق للهروب من بلد “ميؤوس من شفائه”. أعلن ألبير عن انتحاره قبل تتفيذه في رسائل بعث بها إلى الأصدقاء. فقد راعه جنون الحرب، والذبح، والقنص، والقصف، والخطف والتنكيل. ولكن لحسن حظه فقد انقذه خطفه على يد صاحب كاراج للمقايضة بولده الوحيد المخطوف، من الانتحار، وسلبه موته. بعد الإفراج عنه تاه في بلاد الغربة بين فرنسا والولايات المتحدة ليتخصص في علم المستقبليات والإستشراف.
اما الموت، فكان وجهة بلال الغيفاري للخلاص من هذا الواقع الصادم. هرب بلال من الحرب الى جحيمها، فالتحق باحدى الميلشيات وقتل بقذيفة، بعدما خانته مبادئه الثوريّة الطوباويّة. “لقد قتله الأدب” كما تقول خطيبته سميراميس. أراد ان يتماثل وأورويل، ومارلو، وهمنغواي، والأدباء المقاتلين في الحرب الإسبانية. كان يريد ان يمارس تجربة القتال كي يؤلف كتابا على غرار لمن تقرع الأجراس لهمنغواي. كان يقول “يجب ان اقاتل، ثم اكتب” من أجل قضيّة حقيقيّة ذات بعد أخلاقي. لقضية تستحق التضحية تماثل قضيّة محاربة النازيّة، سواء كانت المانيّة، أو ايطاليّة، أو فرنسيّة، أو سوفياتيّة. قضيّة يدافع عنها البشر الأنقياء، الجديرون بالثقة. وبلال كان انقى الأنقياء.
ويفتح موضوع مقتل بلال سجالا ًحامياً بين نضال، أخ بلال، الذي تحول من ثائر غيفاري، إلى أصولي من أصحاب اللحي وبين الراوي آدم. نضال الذي دعاه آدم لحضور “لقاء الأصدقاء” وفاء لذكرى بلال، أصبح أكثر رجعيّة من الطالبان، وأكثر راديكاليّة من الخمير الحمر. لقد تخلى عن نقائه الثوري، والتحق بتيارات معاكسة، يدافع عن المحرمات بشراسة، وعن الأعراف، والتقاليد، والحجاب واللحي. يعبر نضال عن هذه الأصوليّة المتطرفة بالقول: “لقد كانت الثورة حكراً على التقدميين، والآن تلقفها المحافظون. أنها حركة عكسيّة.”
يناصب نضال الغرب أشد العداء “لأن العلاقة بيننا و بين الغرب ليس فيها مساواة”. فالغرب هو الذي يجتاحنا، ويخضعنا، ويستعمرنا، ويذلنا، كما كان الحال في الجزائر واليوم في فلسطين. لذلك “لا يمكن ان نساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، اي بين القتلى وضحاياهم.”
ويذكرنا آدم بكتاب شكيب ارسلان لماذا تأخر المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم. حين يرد على نضال بالقول، “فلنحاول ان نفهم لماذا انتصروا هم، وخسرنا نحن، ولماذا بقينا في حالة تخلف وتبعيّة… لماذا دائما نضع الحق على الآخرين. يجب ان نواجه نواقصنا، وهزيمتنا، والإندثار المدوي لحضاراتنا… الحق ليس على الآخرين، بل علينا نحن”.
اما طريق الإيمان كوسيلة للهروب، والوصول الى بر الأمان، فقد اختارها المهندس رمزي، الذي اصبح يعرف ب” الأخ باسيل”، مبرراً ذلك بالقول:
“في بداية حياتي كنت احلم ببناء العالم و في نهاية المطاف لم ابنِ شيئاً”. اراد رمزي الذي اجتاحته الأفكار الثوريّة، ومفهوم العدالة الإجتماعيّة والمساواة، ان يبني المستشفيات، والجامعات، والمختبرات، والمصانع، والمساكن الشعبيّة، ينتهي به الأمر في بناء القصور للأمراء والميسورين، والقواعد العسكريّة، والمراكز التجاريّة، وناطحات السحاب، والجزر الإصطناعيّة لمليارديرات مجانين. ويقول: “أنني لم أخن مبادئي الدينيّة، فلم أختلس، ولم أغش. لكن هذا لا يكفي للإمتثال للوصية الإلهية”. فقرر الإنعتاق من كاهل هذه الدنيا، والتحول الى زاهد في أحد الأديرة.
وينبري ألبير لتبرير هذا الهروب الى الإيمان، لأن “في عالم يسيطر فيه” العجل الذهبي”، وهو أسوأ تهديد لجميع القيم الإنسانيّة، أصبح الله ملاذا” للمهزومين وملجأهم الأخير”.
اما دنيا زوجة المهندس رامز شريك رمزي (الأخ باسيل ) في الشركة وتوأم روحه، فتلوم رمزي على هذا الهروب، لأن إذا أراد المرء أن يؤمن بالله، فالله في كل مكان. وتشتد وتيرة اللوم، وتضيف، “أصبح الدين يقحم في جميع الأمور، ويظنون أنهم يخدمونه، فيما هم يسخرونه في الواقع لمآربهم الشخصيّة، ولنزواتهم”. ولكن، وقبل انسدال الستارة على “لقاء الأصدقاء”، يفارق الأخ باسيل الحياة نتيجة حادث تدهور سيارة مروع، كانت تقله وآدم لحضور الإجتماع الأخير الذي لم يكتب له النجاح، بل شكل بداية تية جديدة. وكأني بالكاتب يريد قطع طريق الهروب الى الدين والإيمان، والإرتماء في أحضان الرسل، والأنبياء، والقديسين. وليقول أيضا” أن عودة اللمة بين الأصدقاء دونها عوائق في ظل ما يتخبط به البلد من أزمات ومشاكل.
وتُسدل الستارة على مشهد غير متوقع. على مشهد الراوي آدم في المستشفى وهو في منزلة بين المنزلتين يتأرجح بين الحياة والموت. آدم الذي لجأ إلى فرنسا هربا” من جحيم الحرب، وجد في الكتابة والتأريخ مهربا” لمعاناته. فهو نموذج اللامنتمي الذي يعاني قلق المفكرين. ولا يتردد في القول: “إني ضيف، كنت على الدوام مختلفاً، غير متأقلم… غريبا ًعلى تراب الوطن، ولاحقا ًعلى أرض المنفى”. وهذا التأرجح بين المنزلتين، يعبر عنه مجددا ًحين يوضح “أنا لست من أتباع أي دين… ولكني لست ملحداً. انني في منزلة بين الإيمان وعدم الإيمان، كما أنني بمنزلة بين وطنين”.
وآدم في منزلة وسطية بين الخلق والإندثار. فبدأ الرواية بالقول: “إني أحمل في إسمي بدء الخليقة، لكني أنتمي الى بشرية تندثر… لن أكون أول سلالة، بل سأكون آخرها، آخر قومي، والمؤتمن على أحزانهم، وخيباتهم، بل وعارهم وخزيهم”.
لقد ابتعد آدم عن الوطن، لكنه لم ينسلخ عنه. فبعدما ذاق مرارة الإغتراب، عاد الحنين يشده إلى أرض الوطن. فبعد أن تستضيفه صديقته سميراميس في فندقها “سميراميس”، يسر لنفسه: “اتمنى أن أبقى هنا في هذا المكان حتى نهاية الأزمنة، لا أرى سوى أشجار الصنوبر… أقرأ وأكتب… وأسرح بخيالي معلقا ًبين قمم الجبال والبحر”. فهو مجددا ً يتأرجح بين مكانين.
ويُرحَّل آدم الى فرنسا وهو في غيبوبة، برفقة صديقته الفرنسيّة دولوريس، دون أن ينعقد “لقاء الأصدقاء”، وتحول يوم لمّ الشمل إلى يوم الإنفصال النهائي. لقد جاء آدم للقاء “شبح صديقه مراد، فأصبح هو بدوره شبحاً، مستلق على سرير في إحدى المستشفيات ملفوفا ًبالضمادات” في منزلة بين المنزلتين: بين الحياة والموت، أي بين الخلق والإندثار، “تماما ًمثل بلده، ومثل هذا الكوكب الذي يتأرجح هو الآخر بين الحياة والموت… ومثلنا جميعاً”.
وحبذا لو أسدلت الستارة على غلبة الحياة على الموت، تماشيا ًمع ما قاله أليزيه روكلو، أبّ الجغرافيا الحديثة، عن بيروت (الوطن): ” قدر هذه المدينة أن تعيش من جديد رغم كل شيء، يمر الغزاة وتنهض المدينة بعد رحيلهم”. ومع ما قالته بعده الأديبة ناديا تويني:
“ماتت بيروت ألف مرة، وألف مرّة عادت إلى الحياة”.
وتماشيا ًمع تماهي مدينة الصراع الازلي بين الحياة والموت وطائر الفينيق الأسطوري الذي يبعث، على الدوام، من رماد إحتراقه.
[1] ) * رواية أمين معلوف التائهون، ترجة نهلة بيضون٬ الصادرة عن دار الفارابي عام 2013، و الواقعة في 555 صفحة٬ تحضرنا اليوم و كأن التاريخ قد راوح مكانه٬ لأننا لا نرال ندور في نفس المتاهة التي لم نجد٬ حتى الساعة٬ للخروج منها سبيلاً.