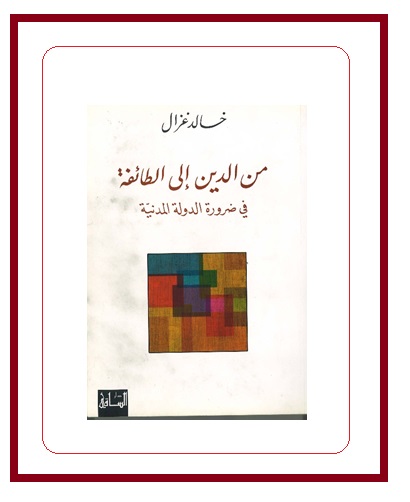كتبت عائدة خدّاج أبي فرّاج
كتاب خالد غزال” من الدين إلى الطائفة في ضرورة الدولة المدنية”، الصادر عن دار الساقي في 319 صفحة، ينقسم إلى قسمين متساويين: يتناول الأول أسباب تحول الأديان إلى طوائف. اما الثاني فيعرض للحل وهو ضرورة قيام الدولة المدنيّة. ويشكل كل قسم منه كتاباً قائماً بحد ذاته لتماسك موضوعاته وترابط احداثه. والكتاب سريع الإيقاع، مثقل بالمعلومات، ويعج بالأحداث التي يحاول القارئ مواكبتها محاولاً التقاط ما يفلت منها نظراً لاهميتها. وهو يغطي فترة زمنية مترامية تبدأ مع نشأة الأديان السماويّة وصولاً إلى الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي راهناً، ومحاولة إقامة الدولة المدنيّة التي دونها عقبات.
في القسم الأول يحاول الكاتب القول أن الدولة الدينيّة لم تقم يوماً لأنها عكس مسار التاريخ، وهي لم تكن أكثر من أسطورة “وضعت لها المؤسسات الدينيّة بنياناً إيديولوجيّاً ونظريّاً بالتواطؤ مع السلطات السياسيّة القائمة. ويركز غزال على معضلة الأديان السماويّة وبنيوتها القمعيّة والاستقصائيّة والاستبعاديّة، وممارساتها المشبوهة في إلغاء الآخر وذلك على امتداد التاريخ.
ومن كتاب المِلَل والنحل للشهرستاني يستدل الكاتب على انقسام الأديان إلى طوائف متصارعة، متناحرة ونابذة الواحدة للأخرى؛ وكل واحدة منها تدّعي الحق الإلهي؛ فكان ما كان من صراع دموي لم يُستثنَ منه دين.
يتكلم غزال عن شراسة الانقسامات في الديانة المسيحيّة بين طوائفها الثلاث، ثم النزاع بين الكنيسة الغربية الخاضعة لسلطة البابا والكنيسة الشرقيّة الخاضعة لسلطة الإمبراطور، ليستعر الصراع بين البابوات من جهة، والأباطرة والملوك من جهة أخرى، المتنافسين على السلطة والمدّعين ان سلطتهم مستمدة من الله.
كان الصراع يتأجج طمعاً بالمال والسلطة، فكثرت عملية بيع المناصب الكهنوتية وفسدت الكنيسة، مما أدّى إلى انشقاقها ونشوء الحركات الإصلاحية. وقد تزامن هذا الفساد مع انتشار المذاهب الفلسفيّة والعقلانيّة وحتى الإلحاديّة منها، ما استدعى قيام حركة إصلاحيّة واسعة وجذريّة قادها مارتن لوثر أدّت إلى مذهب ديني جديد هو البروتستانتيّة.
أما الانقسامات في الإسلام وبين المسلمين فقد برزت أولاً بسبب الصراع على الخلافة والسلطة. وقد ظهرت بعد وفاة النبي مباشرة لينتج عنها لاحقاً الصراع السني – الشيعي الذي ما زال العالم العربي الإسلامي يعاني من مغبّته حتى يومنا الحاضر.
وما ان تحولت الخلافة وراثيّة في عهد معاوية حتى استعر الصراع الشيعي السني وأصبح الدين يستخدم في خدمة السياسة. وأدّت هذه الصراعات إلى نشوء الفرق الاسلاميّة كـ “الخوارج” الذين طالبوا بالعدل والمساواة وسعوا إلى تكريس الحق بالخروج على طاعة السلطة، و”المرجئة” التي أثارت مبدأ المساواة بين المؤمنين من العرب والموالي، و”المعتزلة” التي أعطت للعقل الأولويّة في قراءة المسائل اللاهوتيّة.
وتحول الصراع في العهدين الأموي والعباسي، ولاحقاً في العهد العثماني، إلى حروب وتناحر واضطهاد مما رسَّخ العداء وجذّره ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الوجدان الشعبي. وقد لعب رجال الدين دوراً كبيراً في تسعير وتأجيج الأحقاد الطائفيّة لحماية مواقعهم الدينيّة والاجتماعيّة. وما تزال هذه العناصر تحقن الطوائف والمذاهب الاسلاميّة بشحنات هائلة من الحقد والكراهية… والتخوين والكفر والهرطقة مما يجعل قانون التناحر هو السائد.
هنا يطرح غزال السؤال: لماذا سلكت الانقسامات بين الأديان التوحيديّة سبيل العنف؟
وتأتي الإجابة سريعة باقتطاف نصوص وآيات تثبت ان العنف بنيوي في الأديان السماويّة، فلم يخلُ دين من العنف والاستقصاء والاستكبار، فكل دين يدعي الاصطفائيّة واحتكار الحقيقة. فاليهود هم “شعب الله المختار”، والمسيحيون هم “ملح الأرض… ونور العالم…”، والمسلمون هم “خير أمّة أخرجت للناس”.
يفرد غزال الفصل الثالث للصراعات الدينيّة في المسيحيّة. فعلى الرغم من التسامح والمحبة اللتين يدعو إليهما الدين المسيحي، فان ممارسات المؤسسات الدينيّة جعلت منه “أكثر الأديان وحشيّة وعنفاً… وعندما انجدل هذا الدين بشهوة السلطة… تحول إلى أبشع مظاهر الظلم البشري والاعتداء على الكرامة الإنسانيّة، وقد تمظهر هذا العنف في محاكم التفتيش، الحروب الصليبيّة والحروب الدينيّة التدميريّة والإباديّة بين الكاثوليك والبروتستانت.
وقد طالت محاكم التفتيش المهرطقين، والمشعوذين والسحرة والمسيحيين جملة، إضافة إلى اليهود والمسلمين والعلماء ورجال الفكر ومؤلفاتهم.أما الحروب الصليبية فقد تخطت الصراع المسيحي – المسيحي إلى الصراع المسيحي – الإسلامي عن طريق توظيف الدين في خدمة مشاريع الهيمنة والسيطرة الأوروبيّة على بقية الشعوب. وكانت الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت الأقسى والأعنف وامتدت قرابة القرنين. ارتكبت فيها المجازر والمذابح، وأبيدت فيها جماعات وأحرقت ودمرت مدن وقرى.
ثم ينتقل غزال للكلام عن الصراعات الدينيّة في الاسلام. فكما بدأت المسيحيةّ دعوة سلام ومحبة كذلك بدأت الدعوة الاسلاميّة، ولكن سرعان ما اتخذت العنف وسيلة لفرض الدعوة الجديدة على سائر الشعوب. ونتيجة لترامي رقعة انتشارها، شهد الاسلام صراعات وحروباً عرفت الكثير من العنف وحتى الهمجيّة باسم الدفاع عن الدين.
يعرض غزال لحروب النبي وغزواته، ثم لحروب الردّة التي شكلت بداية الصراع على السلطة، وحروب الخوارج، وكلها كانت حروب عنف وعنف مضاد. ويصل الصراع السياسي إلى ذروته في معركة “كربلاء” التي أسست لبداية الصراع السني – الشيعي المفتوح الذي نشهد ارتداداته اليوم في كثير من الدول العربية. ويضيف غزال إلى هذه الحروب الدمويّة قضيّة الاغتيالات التي شهدتها الساحة الاسلاميّة. وقد مورست في هذه الصراعات أقسى وأشد أنواع العنف والتعذيب. وهكذا يتساوى العنف في الاسلام مع محاكم التفتيش في المسيحيّة في إطار واحد هو الصراع على السلطة. فالأديان السماويّة قد أسهمت في تكوين “شخصيّة دمويّة فاشيّة المزاج معادية للإنسان”.
وهكذا يطوي القارئ القسم الأول من الكتاب الذي ضاق بالعناوين والأفكار العامة المضغوطة في مساحات كان يمكن ان تكون أوسع. ولو توسع غزال بالديانة اليهوديّة وبعض المواضيع الأخرى لغدا الكتاب شاملاً وكاملاً في وحدة الموضوع ودقة الاستنتاجات.
استناداً إلى ما تقدم من صراعات دينيّة يتوصل الكاتب إلى استنتاج أثبت صحته على أرض الواقع السياسي والاجتماعي وهو “استحالة ان يكون الدين عنصر توحيد وطني أو قاعدة لحمة اجتماعيّة – سياسيّة في أي مجتمع من المجتمعات” (ص 145). وان الدولة الدينيّة هي مجرد أسطورة أيديولوجيّة معششة في الوجدان الشعبي.
في الفصول المتبقية من الكتاب، أي في الفصل الثاني منه، ينتقل غزال إلى الكلام عن مقومات الدولة المدنيّة التي دونها العقبات في العالم العربي. ثم يُعرِّج على الانتفاضات العربيّة وشعار الدولة المدنيّة ليصل إلى الفصل الخامس والأخير ويقول ان لا نهضة في العالم العربي الاسلامي إلا بقيام الدولة المدنيّة وفصل الدين عن الدولة. وللتوصل إلى استنتاجه الأخير يعرض غزال لاستحالة قيام الدولة الدينيّة المنصفة والقائمة على المساواة بين معتنقي الطائفة الواحدة ومع الطوائف الأخرى.
يؤكد غزال أنَّ أسطورة الدولة الدينيّة تطال الاسلام أكثر ما تطال الأديان الأخرى، ومقولة أن “الإسلام دين ودولة” ليست سوى الوهم الأسطوري البعيد عن الحقيقة والواقع. ويضيف أنَّ القرآن لم يأت على ذكر السياسة أو قيام الدولة. وقد أكّد الرسول أكثر من مرة “أنَّ المسلمين أدرى بشؤون دنياهم”. وأكد محمد عبده مفتي الديار المصرية أنَّ الإسلام دين لا دولة يقوم “على الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر”.
إنَّ مفهوم الدولة الدينيّة هو فكرة حديثة ارتبطت بفكر حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين. ومما أسهم في صعود نجم القوى الماضويّة التي اعتبرت نفسها البديل للقوى القائمة، هو فشل المشروع النهضوي القومي الناصري والبعثي، والهزيمة المدويّة التي مُنيت بها الدول العربية في العام 1967. وقد فات الكاتب هنا ذكر سبب ثالث لانتعاش الحركات الاسلاميّة وهو انهيار المنظومة الاشتراكيّة برمتها، وهي الداعمة الفعليّة للأنظمة العسكريّة العربيّة، وسقوط حلم التغيير الديمقراطي والحداثة بعدما فشلت هذه الأنظمة في بناء الإنسان إلاشتراكي وتحولت إلى أنظمة بيروقراطيّة قمعيّة.
ويعود الكاتب إلى الماضي الاسلامي مجدداً ليثبت انه لم تتشكل يوماً دولة إسلاميّة، بدءاً بدولة النبي التي لم تكن دولة بالمفهوم الحديث، بل عمليّة تجميع للنظام القبلي في أمة. ومروراً بالعهود الاسلاميّة الأخرى التي لم تؤسس يوماً دولة بل اقتصر تاريخها على الصراع على السلطة والطغيان والقهر، وصولاً إلى الحكم العثماني الذي وصف بـ “الاستبداد الشرقي”. وأخيراً يذكرنا بالثورة الايرانيّة (1979) التي وصفت منذ بداية عهدها بأنها ثورة “عكس التاريخ”. فقيام الثورة مقدَّر من الله وليس لأسباب اجتماعيّة أو إرادة شعبيّة، ومثالها الأعلى قيام “دولة ثيوقراطيّة” أو “الهيّة”.
لذلك، فما يطرحه الاسلاميون من قيام الدولة إلاسلاميّة ليس سوى عودة إلى وهم أسطوري ليس إلا، فالتاريخ العربي الإسلامي لم يشهد يوماً صراعاً من أجل بناء دولة بل من أجل الاستيلاء على السلطة.
ومن الملاحظ ان الكاتب يسهب في الكلام عن مساوئ الدولة الدينيّة واستحالة قيامها ليتوصل إلى استنتاج في غاية الأهميّة وهو أن لا حل ولا خلاص إلا بقيام الدولة المدنيّة، ومكوناتها: “المواطنة، الفصل بين الدين والدولة أو تحقق العلمانيّة، الديموقراطيًة بمفاهيمها ومؤسساتها، تداول السلطة، الفصل بين السلطات، حقوق المرأة والحقوق الانسانيّة للمواطن”. إن مصدر السلطات في الدولة المدنيّة هو الشعب لذلك فان المعضلة الأساس التي يواجهها العالم العربي هي نظريّة “الاسلام دين ودولة” التي تؤكد ان السلطة لله وليس للشعب.
ولكن دون تحقق قيام الدولة المدنيّة في العالم العربي عقبات جمة بسبب حداثة تشكل الدول العربيّة، وبسبب ما انتجه الاستعمار من كيانات قائمة على سلطة القبائل والعشائر والطوائف، وبسبب القيم العشائريّة المتجذرة في الوجدان العربي.
ومن العوائق أيضاً فشل المشاريع النهضويّة وتحولها إلى أنظمة استبداديّة تستغل الصراع العربي الإسرائيلي من أجل استمراريتها وبقائها، وغياب الثقافة الديموقراطيّة في الحركات القوميّة والاشتراكيّة والاسلاميّة الأصوليّة.
وفي مجرى كلامه عن الانتفاضات العربيّة التي رفعت شعار الدولة المدنيّة في وجه الأنظمة الاستبداديّة والحركات إلاسلاميّة، يقول غزال إنّ الكثيرين قد شككوا بالانتفاضات الشبابية واتهموها بانها تدور في فلك بناء الشرق الأوسط الجديد، متناسين الأسباب المتعددة التي أدت إلى قيامها مثل الاحتقان السياسي، وتردي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وفساد السلطة، وانتشار طبقة من الشباب الجامعي المتعلم والمستثنى من القرار السياسي، والبطالة، والثورة التكنولوجيّة التي كسرت القيد الإعلامي وسهلت عمليّة التواصل بين الشباب.
نتيجة لهذه الأسباب مجتمعة كان التحدي الكبير بالنزول إلى الشارع وكسر جدار الخوف. لكن وسط مجتمعات غير مؤهلة للمسار الديموقراطي لأن بديل هذه الأنظمة الديكتاتوريّة الذي كان يعاني القمع والتسلط الفوضى. فلم يكن هناك وعي لمفهوم الدولة المدنيّة. ومن هذه الثغرات تسربت القوى الإسلاميّة مستغلة الفراغ الفكري السياسي وفقدان البرنامج السياسي لدى الشباب.
ويصل غزال إلى الفصل الخامس والأخير فيعرض للحل الذي لا حل سواه وهو قيام الدولة المدنيّة الضرورة والحاجة كي يلحق العالم العربي والإسلامي بركب الحضارة والديموقراطيّة والعلمانيّة. وللعبور إلى هذه الدولة لا بد من إعادة بناء القوى المدنيّة والديموقراطيّة التي تم قمعها في ظل أنظمة العسكريتاريا، وإشراك قوى الشباب الواعدة وتأطيرها وتنظيمها فكريّاً وسياسيّاً، والتركيز على التواصل الاجتماعي لكسر احتكار الإعلام، واستنهاض القوى والأحزاب الديموقراطيّة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في وجه سياسة العبوديّة السياسيّة والفكريّة والدينيّة.
وأخيراً يركز غزال على الحاجة الماسة إلى إصلاح ديني مدعوم “بحامل سياسي اقتصادي – اجتماعي – فلسفي”. ويُذكِّر “أنَّ الإصلاح الديني في أوروبا لم ينجح لو لم يترافق مع تحولات في القوى الاجتماعيّة والصناعيّة والسياسيّة، والتي أدت في النهاية إلى فصل الدين عن الدولة. ويمكن ان يتم هذا الإصلاح عن طريق إعادة النظر بالفقه والتشريع تمشياً مع روح العصر، وإعادة الدين إلى “موقعه الحقيقي بوصفه الحامل للقيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والروحيّة”؛ وفصل التشريعات عن الشريعة؛ وقيام القوانين الوضعيّة وتحديث الفقه الديني تمهيداً لقيام الدولة المدنيّة”. ويختم بالقول إنه لا يمكن للمصلحين من رجال الدين إنجاز هذا الإصلاح دون دعم القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. فالاصلاح يبدأ في الدين وتشريعاته وليس بتخطيه من أجل الوصول إلى الدولة المدنيّة. لأنه لا يمكن القفز فوق هذا الإصلاح بسبب تجذر الدين وانقساماته وصراعاته في نفوس الناس.
ويوصل غزال القارئ إلى خاتمة هي أشبه ما تكون بحلم دون تحققه عقبات. فوسط ما تخرجه المجتمعات العربيّة “من جوفها… من تناقضات وموبقات تراكمت على امتداد عقود في ظل هيمنة القهر والظلم”، وعلى الرغم من “تذرر الطوائف” والعقبات التي تعيق الديمقراطيّة، فأن الأمل ما يزال قائماً وهو استحالة عودة الشعوب إلى الخنوع والشباب إلى الانكفاء، وأنهَّ عاجلاً أم آجلاً سيساهم التقدم العلمي في تسريع وتجديد مشروع النهضة الذي لا حل سواه، والقائم على مثلث: ديمقراطيّة، تنمية شاملة وقيام الدولة المدنيّة. ولكن يبقى هذا الحلم سراباً ان لم يترافق مع نمو القوى الاجتماعيّة الحاملة للتغيير. وهو حلم جيل كامل شهد انتصارات الثورات الكبرى في القرن الماضي وانكساراتها على حد سواء.