زاهي البقاعي
تبدأ مقدمة الدستور بالإشادة بثورة 17 ديسمبر2010، وتصف السنوات العشر التالية بسنوات الفساد والشعارات والوعود الكاذبة والجوفاء، ما استدعى قيام سعيد بتصحيح مسار الثورة والتاريخ كما ورد حرفياً في المقدمة، وهو ما لم يسبقه إليه أحد بمن فيهم قائمة الديكتاتوريين الذين عرفتهم المنطقة العربية و”خاطوا” للبلاد دساتير مفصلة على مقاسهم. ينطبق ذلك على صدام حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي وعمر البشير و… لكن هؤلاء لم يضعوا “مآثرهم” في نص الدستور كما فعل سعيد.
وهذا الدستور يأتي في سياق سياسي فريد من نوعه على مستويات عدة، فبعد 11 سنة من فترة انتقالية غير مستقرة، ما قاد إلى الانتقال من فشل إلى آخر، تجلت ذروته في وصول قيس سعيد نفسه إلى الحكم، مقرونا بما شهدته البلاد يوم 25 يوليو/ تموز 2021. وقاد إلى جملة التطورات العامة والمتاهات السياسية القمعية وذروتها صياغة هذا الدستور. والتي سبقها عمليات التأويل التي رافقت حكم سعيد لفصول من دستور العام 2014، ولاسيما المادة 80 منه التي تبيح للرئيس اعلان حالة الاستثناء – الطواريء- التي مهدت لاجراءات اتخذها منفرداً، وأبرزها دون منازع حل البرلمان وتسريح الحكومة والوزراء والفصل الكيفي لعشرات القضاة، فضلاً عن اغلاق باب الحوار مع الاتحاد التونسي للشغل. إذن جرى خرق دستور العام 2014 انطلاقاً من التصور السياسي الذي يحمله سعيد، ومارسه على امتداد الفترة المنصرمة، وأبرز ما فيه إلغاء الديمقراطية التمثيلية، لصالح الديمقراطية المباشرة. ولكل هذه الأسباب والعوامل اختلط الجانب السياسي بالقانوني الدستوري، مع الإرادة السياسية لرئيس الدولة، ما قاد إلى تجاوز نص وروح دستور 2014 الذي جرى عملياً تعليق العديد من مواده الرئيسية، قبل أن يجري إلغاؤه واعتباره غير موجود تماماً. كما هو حاصل بعد الاستفتاء.
والملاحظات التي قدمتها الأحزاب والاوساط الاكاديمية والقانونية على الدستور، تؤكد أن النص الذي جري الاستفتاء عليه يقود مباشرة إلى تكريس حكم فردي مطلق، وديكتاتورية عارية. خصوصاً بالعلاقة مع ما سبقه من ممارسات وضعت التونسيين أحزاباً ونقابات وهيئات تمثيلية خارج اطار التأثير، وعلى هامش الحياة السياسية التي باتت تدار فقط من القصر الرئاسي دون سواه . فوحده سعيد هو ” المرشد الأعلى “، وهو من يقرر مصير البلاد ويؤسس للمستقبل كما يراه، وما على الآخرين سوى الاستجابة، والموافقة بنعم على ما قرره لهم. ما يؤسس لعودة عهود التسلط الفردي التي جربها التونسيون، وثاروا عليها من خلال النيران التي أشعلها البوعزيزة بنفسه عام 2010 وأضرمت حرائقها معظم سلطات الاستبداد في المنطقة العربية، وأسقطت زين العابدين بن علي والبورقيبية.
لدى الدخول في فصول الدستور يتبين طبيعة المخاطر التي يتضمنها، ومن خلال تشريحه، يتأكد أن ما يتضمنه هو أفدح من قيام مجرد نظام رئاسي فردي خارج اطار المؤسسات، إلى شرعنة ديكتاتورية شعبوية، لا تؤمن بضرورة وجود نطام برلماني منتخب، وسلطة تنفيذية تتولاها الحكومة، التي تتعرض للمحاسبة ومنح ونزع الثقة من الهيئة التشريعية.
ولا يقضي الدستور بانتخاب البرلمان بشكل مباشر، بل من خلال البناء القاعدي. ما يعني انقلاباً على الديمقراطية التمثيلية، خلافاً للتوجه العالمي السائد المتجه نحو الديمقراطية التشاركية، وهي حل وسط بين الديمقراطية التمثيلية والمباشرة.
أكثر من ذلك باتت السلطات بمثابة وظيفة مأجورة، وليست عملية تمثيل لها أساسها الدستوري، تحكمها علاقات وظيفية، ما يعبر عن تهميش لهذه السلطات، ويحد من دورها وصلاحياتها، التي تنتقل إلى مكان آخر هو الرئاسة الفردية بطبيعة الحال.
وضمن الدستور الجديد بات الرئيس فوق الشبهات محصنا من أي مراقبة أو مساءلة أو متابعة أو سحب ثقة أو عزل إن هو ارتكب من الجرائم ما يستوجب إنهاء مهامه، وذلك على قاعدة ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 109 التي تقول “يتمتّع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلّق في حقّه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”. والرئيس هو “الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلطات العمومية ويضمن استمرارية الدولة ويترأس مجلس الأمن القومي”، وهو “القائد الأعلى للقوات المسلحة”. وله أن يتخذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الداهم، وأن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون أو مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات العمومية أو المصادقة على المعاهدات، ومن حقّه عرض مشاريع قوانين على المؤسّسة ذات “الوظيفة التشريعية”، فلم تعد هناك سلطات، وإنما هناك وظائف فقط. ويختصّ الرئيس بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية، ويمكنه أن يصدر المراسيم بعد تفويض مجلس النواب وفي حالة الخطر الداهم، وهو من يُبرم اتفاقات الحرب والسلم، ويتمتّع بحق العفو الخاص، وضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها. وله كذلك أن يختم القوانين الدستورية والأساسية والعادية، وردها إلى مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات إن بدا له ذلك ضرورياً، والسهر على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة التنفيذية. وهو من يعيّن رئيس الحكومة، وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وإنهاء مهامها أو مهام عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيسها. وإذا ما قدّم المجلس التشريعي بغرفتيه لائحة لوم ضد الحكومة فلا بدّ من أن تكون معلّلة وموقعة من نصف أعضاء الغرفتين، ويقبل الرئيس استقالة الحكومة المصادقة عليها بأغلبية الثلثين في المجلسين، فالحكومة في هذه الحالة، وفق الدستور، لا تسقط بعد أن يسحب البرلمان والمجلس الوطني للجهات الثقة منها، وإنما تقدم استقالتها للرئيس، الذي يمكنه في حالة تقديم لائحة لوم ثانية في الدورة الثانية النيابية أن يحلّ مجلس النواب أو كلا المجلسين، والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بدلا من القبول باستقالة الحكومة. ولا سلطة حقيقية لمجلس النواب ونظيره المجلس الوطني للجهات على الحكومة والوزراء، إذ لا يستطيع أحدهما أو كليهما إسقاط الحكومة أو أحد وزرائها لاستحالة جمع ثلثي المجلسين على موقف واحد، طبقا للقانون الانتخابي الحالي. حسب ما ورد في الفصل 114، فقد ولّى زمن مساءلة الحكومات ومحاسبتها التي باتت مرهونة المصير بيد الرئيس دون سواه.
ولا يقتصر التهميش على “السلطة التشريعية” على ما ورد أعلاه، اذ يبرز في الفصل 61 إمكانية سحب الوكالة من النائب المنتخب، وهو إجراء شعبويٌّ في ظلّ سرية الانتخاب، فعضوية النائب قد تسحبها مجموعات سياسية لم تصوت له أو كانت تعارضه وتنافسه على المقعد، أو بسب عوامل قبلية وصراعات جهوية، أو لأغراض كيدية، هذا إضافة إلى أن النائب المنتخب يضعه الدستور الجديد على الدرجة و”السلطة” نفسيهما، وتولي مهمة التشريع مع عضو المجلس الوطني للجهات (الغرفة الثانية) الذي لا ينتخب انتخابا عاما حرّا مباشرا سرّيا وإنما يُصعّد وفق آليات النظام القاعدي، ليكون ممثلا للمجلس الجهوي بجهته، وللإقليم الذي تنتمي إليه الجهة، ولكن لا تسحب منه الوكالة، شأن رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع أحدُ سحب الوكالة منه أو تنحيته من منصبه، حتى إذا ثُبّتت في شأنه الخيانة العظمى. وفي السياق ذاته، احتقر الدستور الجديد الأحزاب السياسية، ولم يذكرها إلا عرضا في الفصل 40 منه .
أما بالنسبة للسلطة القضائية فلم يعد هناك موقع للمجلس الأعلى للقضاء، رمز السلطة القضائية ومؤسّستها. واكتفى الدستور بإقرار وجود مجالس للأقضية الثلاثة، العدلي والإداري والمالي، يكون دورها تسييرياً وإدارياً. أما الكلمة النهائية الفاصلة في تسمية القضاة فهي من مشمولات رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات تتقدم بها المجالس القضائية المذكورة وفق مقتضيات الفصل 120. وبإلغاء المجلس الأعلى للقضاء، تنتقل مهامه إلى السلطة التنفيذية، ممثلة بالرئيس الذي يحتكر التسميات النهائية للقضاة ووزارة العدل، وهي التي تمتلك حق تسمية القضاة ونقلهم وتأديبهم، وهي صاحبة اليد العليا التي تمارس نفوذها على القطاع القضائي برمّته.
و كما أن دستور 2014 لم يحسم الجدل، عندما أرجأ موضوع مدنية الدولة وهويتها، كما حدث مع دستور 1959. عاد نص دستور سعيد إلى صيغة العام 1959، فحذف منها دين الدولة، في توطئة الدستور، لكنه أكد على الانتماء إلى الأمة الإسلامية والعربية، وهو ما خلق جدلاً جديداً، يتغذى من جدل قديم في محاولة من سعيد لقطع الطريق على استعمال مسألة الهوية من جانب الاسلاميين، بينما يتقصد الاطاحة بالديمقراطية مع تعدد ألوانها ومؤسساتها وتوزع السلطات بين التشريع والتنفيذ والقضاء وتوازن أدوارها وتباين منابتها الاجتماعية.
يمكن القول إن التجربة التونسية تمر الآن بمرحلة عسيرة، تدخل البلاد في منعطف بالغ الخطورة يهدد بإعادتها إلى خطوات إلى الوراء، من خلال الحنين إلى استعادة تجربة الحكم الفردي التي كدست المشكلات حتى لحظة انفجارها. باختصار دستور قيس سعيد أعاد تونس خطوات إلى الوراء ويمثل ارتداداً عن مسيرة ثورتها الديمقراطية.


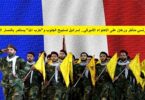





Leave a Comment