إيلي يوسف*
«القارة السمراء» بحاجة إلى استثمارات… والتقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص مصدر القوة الأميركي
رغم إصرار الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي إدارته على النفي، لا يخفى أن الحافز الرئيس وراء عقد «القمة الأميركية الأفريقية» الثانية، خلال 8 سنوات، هو التصدّي للتمدد الصيني في أفريقيا، وليس روسيا أو غيرها من البلدان التي لديها طموحات «إقليمية» محدودة. فموسكو، رغم التحدي الذي فرضته حربها في أوكرانيا على الولايات المتحدة، وأربكت علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ليست منافساً استراتيجياً لواشنطن، بعدما تحولت إلى «تاجر سلاح» ومورِّداً لـ«الجنود المرتزقة»، وفقاً للمسؤولين الأميركيين. بيد أن توقيت عقد القمة يأتي في جزء منه ترجمة لهذا «الإرباك الأفريقي»، الذي عُبّر عنه برفض بعض الدول اتخاذ موقف ضد روسيا، وسط مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، وكجزء من جهود بايدن المستمرة لتعزيز الديمقراطيات في الخارج. ومع هذا فإن إعادة «ترميم» علاقات واشنطن بدول القارة السمراء تحتاج أولاً إلى إعادة تأسيس سياسات مشتركة داخل دوائر المؤسسة السياسية في واشنطن، وتوافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تغيير نظرتيهما وطريقة فهمهما للعلاقة مع تلك القارة. ومن نافل القول إنه في دوائر السياسة الأميركية كان يُنظر إلى أفريقيا عموماً على أنها منطقة منعزلة وحشية وهامشية بالنسبة للأولويات الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، وهو ما انعكس لسنوات طويلة على دبلوماسية واشنطن، إذ إن آخِر زيارة لرئيس أميركي لدولة أفريقية قام بها الرئيس الأسبق (الأفريقي الأصل) باراك أوباما عام 2015 إلى إثيوبيا. في المقابل، وخلال سنتين من عهده، قام خلفه بايدن برحلات عدة إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بما يثبت أن «قرار العودة إلى أفريقيا» يحتاج إلى أكثر من قمة واحدة.
مع التمدّد الصيني في أرجاء أفريقيا منذ نحو عقدين، وتحوّل «التنّين الأصفر» إلى أهم منافس استراتيجي للولايات المتحدة، كان لا بد لصانعي السياسة الأميركية من تغيير البوصلة، إذ إن الفوز في مثل هذا السباق لا يمكن تحقيقه، ما لم تتحقق العودة إلى «الساحات» التي خرجت من القارة السمراء، ليس واشنطن فحسب، بل الغرب عموماً.
لقد كان طبيعياً أن تملأ الصين، وخلفها روسيا، الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني الذي تركه الغرب هناك. وبالفعل وصلت التجارة بين الصين والدول الأفريقية إلى مستوى تاريخي بلغ 254 مليار دولار أميركي عام 2021. وفي المقابل تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية من ذروة بلغت 142 مليار دولار عام 2008 إلى 64 مليار دولار فقط عام 2021؛ أي ما يمثل نحو 1.1 % من التجارة العالمية الأميركية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل باتت الحكومة الصينية تمتلك أيضاً الكثير من مشروعات الطاقة والسكك الحديدية والموانئ في جميع أنحاء القارة، وتديرها بطاقاتٍ بشريةٍ صينية مباشرة، ووفقاً لشروطها.
تهم العنصرية
يدّعي كثرة من الديمقراطيين الأميركيين أن جزءاً من سياسات خصومهم الجمهوريين السلبية من أفريقيا نابع من «عنصرية» موروثة، فالرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، الذي جمّد خطط سلفه أوباما تجاه القارة، أرفق سياساته بمواقف وُصفت بغير اللائقة تجاه الأفارقة، مما تسبَّب بتوتر علاقات واشنطن بمعظم دول القارة، أما اليوم، مع تصاعد التناغم بين الحزبين حول الموقف من الصين، بدا أن القارة الأفريقية في طريقها للعودة إلى «منطقة الضوء» الأميركية.
وفي جزء من سياسات واشنطن لمواجهة النفوذ المتزايد للصين، كشفت إدارة بايدن النقاب عن «شراكة أميركية أفريقية جديدة للقرن الحادي والعشرين»، ضمن الاستراتيجية التي نشرتها في أغسطس (آب) الماضي، والتي حظيت بتأييد الحزبين. ويومذاك اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الاستراتيجية جاءت لتعكس التوصيات التي صدرت خصوصاً من وزارة الدفاع «البنتاغون»، ومن مراكز الأبحاث المتخصصة، التي حذّرت من خطورة استمرار سياسة إهمال القارة الأفريقية؛ أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً. ثم إن عدداً من الخبراء شددوا على أن ما تحتاج إليه أفريقيا هو «استثمارات» وليس «مساعدات»، رغم تفوّق واشنطن في هذا المجال على غيرها من الدول، إذا كانت ترغب باستعادة موقعها فيها.
توقيت القمة ودلالاته
وفقاً لمسؤولين أميركيين، فإن قرار عقد القمة الأميركية الأفريقية بدأ التحضير له منذ أشهر عدة، وحقاً نظّم وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار موظفي وزارته زيارات مكّوكية عدة إلى دول القارة. وكان من الواضح أن توقيت عقدها قبل نهاية هذا العام يهدف إلى عدم تفويت الفرصة للرد على «القمم الأخرى» التي عقدتها الصين وغيرها من الدول الإقليمية الكبرى، سواءً في القارة الأفريقية نفسها أو في مناطق أخرى. ورغم الانتقادات التي وُجهت لبايدن، بسبب انعدام لقاءات القمة الثنائية – عُدت لأسباب «صحية» – في تكرار للانتقادات التي تعرّض لها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، سعى كبار المسؤولين الأميركيين للتعويض عنها عبر لقاءات ثنائية مكثفة لإظهار «جدية» واشنطن في مساعيها لتنفيذ استراتيجيتها الأفريقية.
لقد سعى بايدن، في كلمته أمام نحو 50 من قادة القارة، لترجمة ما وعد به في استراتيجيته، وذلك عبر توظيف استثمارات وتقديم قروض وهِبات مباشرة؛ لدعم التحول العادل للطاقة والانتعاش الاقتصادي في المنطقة بعد جائحة «كوفيد-19». ورغم تأكيد الرئيس الأميركي أهمية وجود «مؤسسات ديمقراطية قوية» و«شفافية في الحكم»، بدا أن الديمقراطيين يغادرون «رطانتهم» وعودتهم إلى التعامل مع الواقع السياسي كما هو. فالاستثمارات الحكومية أو من القطاع الخاص تحتاج إلى استقرار لا بد منه. وفي ظل استعداد الصين وروسيا، وحتى تركيا وإيران وغيرها من الدول، التي لديها شهية للتوغل في هذه القارة الشابة، «من دون الحاجة إلى الدروس في حقوق الإنسان»، على حد قول الرئيس السنغالي، كان لا بد لواشنطن من أن تخفف تلك اللهجة.
أيضاً سعى البيت الأبيض إلى تهدئة المخاوف من أن القمة لن تكون حدثاً لمرة واحدة، أو أن التركيز على أفريقيا سيتراجع بمجرد انتهائها. وأعلن بايدن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى «مجموعة العشرين» بشكل دائم، ودعمه بصفته عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وعزمه على السفر إلى أفريقيا في عام 2023، في ترجمة سياسية للثقل الذي تتمتع به الولايات المتحدة في هذه المحافل. كذلك عيّن السفير جوني كارسون، الذي كان مساعداً لوزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية وشغل منصب السفير في كينيا وزيمبابوي وأوغندا، ليكون الممثل الخاص الجديد لتنفيذ قرارات القمة الأميركية الأفريقية. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم يريدون أيضاً مناقشة موضوعات «تطلّعية» مثل الاستثمارات التجارية والتكنولوجيا التي يمكن أن تكون لها فوائد طويلة الأجل للقارة. وقال وزير الخارجية بلينكن: «خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن استثمارات إضافية لتسهيل مشاركة الطلاب في برامج التبادل بين بلداننا، وزيادة الفرص التجارية لأعضاء الشتات الأفريقي، ودعم رواد الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة».
وللعلم، بينما تتمتع شركات الأدوية الأميركية العالمية بموقع رائد، مقارنة بالكيانات المماثلة في الدول المنافسة مثل الصين، فإن الضمانات التي قدّمت من الوكالات العامة مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة، ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، ستمكّن الشركات الأميركية من الاستثمار في بناء سلاسل التوريد لإنتاج الأدوية والمعدّات الطبية واللقاحات في البلدان الأفريقية. وستساعد هذه الاستثمارات في تعزيز سلاسل التوريد الضعيفة للمنتجات الطبية في أفريقيا، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية، وهو ما من شأنه أن يمكّنها أيضاً من دعم تنمية رأس المال البشري في البلدان الأفريقية من خلال برامج التبادل للمهنيين الطبيين الذي أُقر في القمة.
مواجهة «الحزام والطريق»
ونظراً لأن سياسة الولايات المتحدة بشأن إفريقيا مرتبطة بجهود الحد من صعود الصين، فقد سَعَت واشنطن إلى ترجمة الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة «الدول السبع الكبرى» لإطلاق الشراكة من أجل استثمارات البنية التحتية العالمية؛ لمواجهة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بوصفها وسيلة لإطلاق مشروعات الطاقة والصحة والمشروعات الرقمية. ومع هذا بدا أن استثمارات البنى التحتية المماثلة لن تكون أفضل استخدام للموارد العامة الأميركية؛ لأن هذه المبادرات تلعب دوراً في نقاط قوة بكين. لذلك ركّزت واشنطن على نقاط القوة التي تتمتع بها، مثل التقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص، ومن ثم مواءمة المصالح الأميركية مع احتياجات التنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية.
هنا يقول بعض الخبراء إن «أجندة» من هذا النوع ستدعم الاقتصادات الأفريقية وتقدم فوائد طويلة الأجل للولايات المتحدة؛ لكون سكان أفريقيا أصغر سناً وأسرع نمواً من أية قارة أخرى، حيث متوسط العمر 19 سنة. كذلك من المتوقع أن يعيش أكثر من ملياري شخص في أفريقيا بحلول عام 2050. وبنهاية القرن، ستنمو المدن الأفريقية بسرعة، وستشكل 13 من أكبر 20 منطقة حضرية في العالم. وبالنظر إلى أن إمكانات النمو الكامنة في المنطقة هائلة، ستتمكن الشركات التي تستثمر في أفريقيا، والبلدان التي تتحلّى بالصبر في مواجهة تحديات الحوكمة في القارة، من الوصول إلى أسواق جديدة وبناء نفوذ سياسي.
ومع وجود ميزة نسبية أخرى للحكومة الأميركية، عبر قدرتها على توفير التمويل، من جانب واحد وعبر مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، بأسعار أقل من السوق، ستتمكن من تلبية دعوات الدول الأفريقية إلى إصلاح التمويل العالمي لجعله أكثر إنصافاً، وكسب المزيد من الأصدقاء في القارة من خلال دعم هذه القضية، إذ إن غياب التمويل الغربي للبنى التحتية خلال العقود الأخيرة هو الذي دفع البلدان الأفريقية إلى اللجوء للبنوك الصينية.
أما الآن، ومع حاجة الدول الأفريقية إلى استثمار حوالي 50 مليار دولار سنوياً في التكيف مع المناخ، تسعى واشنطن لاغتنام الفرصة ودفع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والحلفاء الأوروبيين إلى تقديم تمويل منخفض الفائدة. وتتمشى هذه المبادرة بشكل جيد مع احتياجات معظم البلدان الأفريقية، لتوظيف أكثر من 11 مليون شاب ينضمّون إلى سوق العمل سنوياً.
هذا الأمر يذكّر بسوابق الاستثمار الناجح للقطاع الخاص الأميركي في البلدان النامية، في أماكن مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، التي ازدهرت من خلال هذه الاستثمارات وحافظت على تحالفها الموثوق مع الولايات المتحدة. و«أفريقيا ليست منطقة هامشية، وما يحدث فيها سيعيد تشكيل بقية العالم»، وفقاً لكمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
التحدي التنموي بالأرقام
أفريقيا قارة شاسعة ومهملة، قال عنها ذات مرة، أمين عام الأمم المتحدة الراحل الغاني كوفي عنان إنها «قارة غنية فيها الكثير من الفقراء». مساحتها تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف حجم الهند، وثلاثة أضعاف حجم الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 18 % من سكان العالم، وحوالي 30 % من موارده المعدنية. ومع أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يزيد قليلاً عن ألفي دولار، فإنها تظل أفقر قارة إلى حد بعيد. ومن بين 46 دولة صنفتها الأمم المتحدة على أنها أقل البلدان نمواً، هناك 35 دولة من أفريقيا. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكان القارة في بلدان، حيث متوسط العمر المتوقع والدخل والتعليم أقل بكثير من المتوسط العالمي.
بعض الإحصاءات المحبِطة بالفعل يعزز الشكوك في توفير آفاق نمو واسع في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، يمكن أن تكون 48 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء موطناً لـ90 % من فقراء العالم بحلول عام 2030. وتقع في القارة 20 دولة، من أصل 38 دولة تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات. ووقعت فيها 5 انقلابات عسكرية بين عامي 2021 و2022 فقط، لكن فرص الاستثمار موجودة، وقد استفاد منها بعض البلدان. ووفقاً لبعض التقارير، يجري دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في أفريقيا من خلال البنية التحتية الرقمية الصينية وشركات الهاتف المحمول الصينية، مثل «هواوي» و«زد تي إي» و«ترانشن». وأصبحت هذه الشركات الصينية رائدة في السوق بالقارة إلى حد كبير، بعدما «شطبت» الشركات الأميركية، في مطلع القرن الحالي، معظم الأفارقة باعتبارهم «فقراء جداً بحيث لا يمكنهم شراء الهواتف المحمولة».
الرهان على الاستثمار وأمن التجارة الحرة
وفق الخبراء، فإن أهمية قرار استثمار 55 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والذي يتجاوز المبلغ الذي خصصته الصين (50 ملياراً)، تكمن في أن توظيفاته ستذهب بشكل أساسي إلى قطاعات يمكن لواشنطن أن تنافس فيها، وليس فقط على البنية التحتية، التي تفوّقت فيها الصين. وبالفعل أعلن جو بايدن، خلال اجتماع بحضور الرؤساء التنفيذيين من أكثر من 300 شركة أميركية وأفريقية، عن فرص تجارية واستثمارات جديدة لترسيخ «التزام الولايات المتحدة بمستقبل أفريقيا»، كما أعلن عن مذكرة تفاهم مع أفريقيا بشأن أمن التجارة الحرة من أجل فتح فرص جديدة للتجارة، فضلاً عن الاستثمارات في البنية التحتية لتسهيل التجارة داخل أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستستثمر 350 مليون دولار لتسهيل مشاركة أفريقيا في الاقتصاد الرقمي، وستستثمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ما يقرب من 370 مليون دولار لمشروعات جديدة. وأوضح «أن تحسين البنية التحتية لأفريقيا أمر ضروري لرؤيتنا لبناء اقتصاد عالمي أقوى يمكنه أن يتحمل بشكل أفضل أنواع الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية». ويرى البعض أنه على الرغم من ذلك، لا بد للولايات المتحدة من بناء شراكات جديدة مع أفريقيا، ووضع الدبلوماسية الاقتصادية في صميم مشاركتها، بالاعتماد على نقاط القوة الأميركية، التي لا مثيل لها في التقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص، مع تبسيط نظام التأشيرات الأميركية للسماح بمزيد من العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والقارة.
أهمية الوصول إلى شرائح المجتمع الأفريقي
يقول تقرير في «فورين أفيرز»، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة متابعة نهجها الاستراتيجي الجديد لأفريقيا، عليها توسيع نطاق وصولها إلى شرائح المجتمع الأفريقي التي غالباً ما يتجاهلها صُناع السياسة الأميركيون. وتُظهر بعض استطلاعات الرأي أن تصنيف الأفضلية للولايات المتحدة في المنطقة يتساوى مع أو حتى يتخلف عن الصين. ورغم جهود توعوية للمجتمع المدني في البلدان الأفريقية من خلال «برنامج القيادة الدولية للزائر» وغيرها من المبادرات، فإنها أغفلت فئة مهمة؛ أصحاب الأعمال الصغيرة.
وعليه، فتطوير العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة؛ أغنى اقتصاد سوق في العالم، وبين أفريقيا؛ المنطقة حيث أعلى معدل لريادة الأعمال في العالم، يحتاج إلى توجيه سياسات مركزة نحو هذه الشريحة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية بلينكن، فقد بدأ 22 % من السكان، في سن العمل، في أفريقيا أعمالهم التجارية.
ومن الشائع مقابلة تاجر أو رائد أعمال أفريقي من الطبقة المتوسطة، على متن رحلة إلى دبي أو بكين، للبحث عن الملابس أو الإلكترونيات أو الآلات الصناعية الثقيلة.
ووفقاً للتقرير، فقد أصبحت دبي عاصمة تجارية لأفريقيا، مع أكثر من 21 ألف شركة أفريقية مقرُّها في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن الأحجام المتزايدة من التجارة الأفريقية الصينية هي في الغالب نتيجة الروابط العابرة للقارات بين الآلاف من رواد الأعمال الأفارقة والصينيين، في حين أن روابط الأعمال الصغيرة بين الولايات المتحدة وأفريقيا لا تزال ضئيلة.
*نشرت في جريدة الشرق الاوسط في 17 كانون الاول / ديسمبر 2022


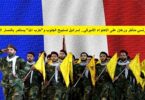





Leave a Comment