كتب أحمد مغربي
مقدمة:
الأرجح أن العالم يعيش انتقالاً يسير به إلى ابتكار نظام عالمي متعدد وهجين، ربما إنه آخذ في التبلوّر بالتدريج من آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف الذي امتد بصيغ متنوعة من الحرب العالمية الثانية إلى نهاية رئاسة دونالد ترمب واندلاع جائحة كورونا، واقتراب “الثورة الصناعية الرابعة” عبر اندفاعة مذهلة في ثورة المعلوماتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والنانوتكنولوجيا.
هل من مبالغة في القول إن التحوّل الأوضح [لا يعني ذلك سوى أنه نتيجة مسار تفاعل بين عوامل متشابكة ومتفاعلة] اندفع من صناديق الاقتراع الأميركية، في ظل جائحة كورونا، وبروز انقسام حاد في الداخل الأميركي للمرة الأولى في تاريخها الحديث كقوة عالمية، والمآزق المتنوعة في النظام الدولي لما بعد العولمة [خصوصاً ما سُمّي “الليبرالية القومية” التي قادها ترمب]؟
لعل المبالغة تبدو أقل في عين من يستمر في مراقبة المتغيّرات في العلاقة بين أقطاب النظام الدولي بعد انتخاب جو بايدن. الأرجح إنه من المستطاع البدء من المتغيّر الأميركي الداخلي مع خطة بايدن التريليونية في التعافي الاقتصادي [بعد كورونا والأزمة المالية 2008] التي تسعى إلى التركيز على إعادة إحياء الطبقة الوسطى، وتقليص الفجوة الاجتماعية في المداخيل وبين الأعراق، والتعامل مع ظاهرة التمركز الفائق للثروة في يد قلّة تقدر بـ1%، والعودة إلى التوظيف في البنية التحتية وغيرها.
وقد يندرج في الإطار نفسه، ذلك المتغيّر الفائق الوضوح المتمثّل في إعادة موضعة القوة العظمى ضمن قيادة العالم الغربي، ما يعني تجديد النظام الدولي المتعدد الأطراف، ولَجْم مسار المحاولة الأميركية في تفكيك الاتحاد الأوروبي، والتركيز على المنافسة في التعامل مع روسيا والصين، التي اعتُبِرت المنافس الأول عالمياً لأميركا مِنْ قِبَلْ ترمب وبايدن.
وتشمل ملامح المتغيّرات في النظام الدولي، حدوث تبدل في العلاقة مع أوروبا عبر تغيّر جذري في الموقف الأميركي من مشروع “نورد ستريم 02” في نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق [تذكيراً، لقد فرض ترمب رسوماً عقابية متنوعة لمنع المشروع، وألغاها بايدن]، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية العقابية “المتبادلة” على الألمونيوم والحديد والصلب وغيرها.
في السياق نفسه، الأرجح أن هنالك أشياء كثيرة يمكن أن ترد في وضع بريطانيا ضمن النظام الدولي الجديد، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عِبْرَ “بريكست”، ما شكّل آنذاك إحد أبرز نجاحات ترمب في محاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي. ولعله جدير بالتأمل أن بريطانيا تحاول التقرّب من “الشرق”، بمعنى محاولة تعويض الخروج من الاتحاد الأوروبي بعلاقات مع الهند واليابان وأستراليا و… الصين. أليس ملفتاً أن تتقدم بريطانيا رسمياً بطلب الانضمام إلى تكتل اقتصادي لدول في المحيط الهادئ، على الرغم من أن ذلك التكتل يوصف على نطاق واسع بأنه يسير تحت قيادة الصين أو على الأقل، بدفع من القوة الاقتصادية الاستراتيجية للصين؟
الانقسام الأميركي في مشهدية تاريخية
في سياق التبدّلات الكبيرة، يبرز الشروع فعلياً وعملانياً في صوغ مشاركة أميركية أوروبية، خصوصاً فرنسية، في أفريقيا التي تتجه صوب أن تكون منطقة استراتيجية متقدمة في عمل قوى الإسلاموية المسلحة، إضافة إلى مسارات داخلية وخارجية متشابكة، لعل أبرز مظاهرها ضعضعة “الدولة” فيها. واستكمالاً، ثمة تبدل في موقف القطب الأبرز في النظام الدولي [= أميركا]، من قوى اقليمية كإيران وتركيا. ولعل الانسحاب التاريخي للقوات الأميركية من أفغانستان، يقدم مساحة يمكن التأمل في متغيّرات النظام الدولي وتبدله، بل تبلور تدريجي لنظام دولي جديد وهجين [بمعنى أنه يضم مكونات ليبرالية وغير ليبرالية وديمقراطية وغير ديمقراطية، ما يفرض أيضاً التأمل في إمكانية تجديد تعريف الديمقراطية وعلاقتها مع الليبرالية].
وفي سياق مؤثر، للمرّة الأولى تصل أميركا إلى انقسام سياسي يهدد نسيجها الوطني، مع مشهدية مماثلة بدرجات متفاوتة في دول الاتحاد الأوروبي، ما يشي بأن المعطى الداخلي في المعادلة بين الدولة والشعوب، بات يصنع آليات نوعية جديدة في النظام الدولي. [تذكير بأن النظام الدولي تصنع آلياته الأساسية الدول الكبرى]. والأرجح إن ذلك المعطى متفاعل مع بروز دور اللاعبين غير الدُوَلاتيين، أي خارج مؤسسة الدولة، من الشعبوية القوموية العنصرية في الغرب إلى الإرهاب الإسلاموي والمجموعات المسلحة المشابهة، ومروراً بحركات شبابية بلمسة يسارية مناهضة للعنصرية، وتؤيد البيئة وحقوق الشعوب والعدالة في النظام الدولي.
إذاً، فالأرجح أن تعزز جائحة كورونا تأثير عنصري المعطى الداخلي للدول واللاعبين من خارج الدول. ومع ملاحظة أن هذين العنصرين يتفاعلان في نظام هجين متعدد، فقد يؤدي ذلك إلى توسّع هوامش التحرك الاستراتيجي للقوى الإقليمية، وتعزيز تأثير الآليات الداخلية [واللاعبين غير الدُوَلاتيين] في دول المركز والأطراف معاً!
لقد وضعت جائحة كورونا النظام العالمي على محك تاريخي ما زال في بداياته. وكشفت التفاوتات المتعددة والعميقة فيه، سواء داخل الدول أو بينها، والوهن في آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف [من “حرب الكمامات” إلى “حرب اللقاح” وحِزم دعم الاقتصاد] مع ضرورة إعادة صياغته نوعياً. وكذلك عمّقت الجائحة التغيير في أسس المعادلة بين النظم والشعوب، وقد تسهم متغيّراتها في تمهيد صعود الطبقة الوسطى في أميركا والغرب.
وكذلك تقدم الهند والبرازيل [سادس وثامن الاقتصادات العالمية على التوالي] نموذجاً عن المأزق النوعي للتنمية ضمن نمط رأسمالي متفاوت التقدم في الحداثة، لكنه متمحور حول نُخُب معولمة وفاعلة. وقد يستطيع ذلك النموذج تحقيق إنجازات كبرى، لكن إخفاقه في حل معضلة التفاوتات الداخلية المتنوعة، يهدد انجازاته تماماً. وليس مصادفة أن يجري الحديث أميركياً عن تجديد “العقد الجديد” الذي تحققق بعد الحرب العالمية الثانية [وسارت بعده أميركا في نظام ميّال إلى الكينزية في الاقتصاد]، وإعادة أحياء الطبقة الوسطى بأمديتها العريضة، والتوسع في توظيف القوى العاملة وزيادة نصيبها في الانتاج. وتبدو إدارة بايدن كأنها تعبّر عن ميل إلى تجديد “العقد الاجتماعي” [خصوصاً مع أخذ معطيات أبرزتها جائحة كورونا] يشدد على إعادة بناء الطبقة الوسطى، ما يقربها من محاولة صوغ نوع من “الكينزية الجديدة” أيضاً.
لننظر إلى الأرقام والأموال
الأرجح أن أميركا ستبقى الدولة العظمى الوحيدة والقطب الأول في النظام العالمي المتعدد الهجين الصاعد. وقد يستمر ذلك على الرغم من تآكل حصتها من الاقتصاد العالمي. إذ شكّلت أميركا نصف الاقتصاد العالمي عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهبطت النسبة إلى 25% عند نهاية “الحرب الباردة”، وتتأرجح الآن عند قرابة 16%. وقد تتغيّر الأرقام كثيراً مع الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بعد كورونا بفعل أشياء من ضمنها حِزم الدعم والموازنات الغربية التريليونية، والارتباط بين الخروج من الجائحة والتعافي الاقتصادي، واستمرار الاقتصاد الصيني في النمو أثناء الجائحة، والتأثير الذي لا زال غير ثابت للعملات المشفرة والرقمية.
وفي المقابل، لعل التمركز الهائل [المتناقض النتائج] لرأس المال المالي، وهو ظاهرة تاريخية أيضاً، يحفظ لأميركا أرجحية ضخمة واستمرارية إمساكها بزمام القيادة في الاقتصاد العالمي. وفي ظل ما سُمّي “الليبرالية القومية” في زمن ترمب، بدت أميركا مختلة التوازن أمام جائحة كورونا. وفي المقابل، الأرجح أنها أثبتت أيضاً أنها تمتلك مرونة مذهلة، إذ برز تقدمها العلمي المسنود ببنى منسجمة متنوعة، خصوصاً مع سرعة نشر اللقاح، واقترابها السريع من الخروج من الجائحة.
وكذلك ترافقت جائحة كورونا مع تبدّلات كبرى ومتشابكة في الاقتصادات العالمية، خصوصاً حدوث تقلص شديد وسريع في النشاط الاقتصادي والدخل القومي [ركود شامل وحاد، لم يسجل نظيره في معظم الاقتصادات الكبرى منذ عقود ثلاثينيات القرن العشرين، بل ربما منذ ثلاثة قرون]، بالترافق مع بطالة واسعة وسريعة، وكساد هائل متأتٍ من تقلص حاد وواسع في الاستهلاك.
واستطراداً، دفعت تلك المتغيرات وغيرها، الاقتصادات الرأسمالية الكبرى إلى عمليات اقتراض حكومي قياسية ضخّمت الميزانيات الحكومية، على العكس من مساراتها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين. وترافق ذلك أيضاً مع التشديد على القطاع العام وأشكال الملكية والضمان التي تصاحبة، إضافة إلى توضّح أهميته في الرعاية الصحية وغيرها. وفي استنتاج مبكر تماماً، قد تغيّر تلك المعطيات وتفاعلاتها أنماط الاستهلاك والانتاج، والعلاقة بين السلع والبشر في الاقتصاد وكذلك عقود العمل، بل ربما مجمل علاقة قوى العمل بالاقتصاد.
وبعبارة اخرى، قد يتشكّل مسار أساسي قوامه عودة تاريخية للطبقة الوسطى في الغرب [بعد تآكلها منذ صعود النيوليبرالية في زمن رونالد ريغان ومارغريت تاتشر]، مع تأثيرات واسعة وعميقة تتجاوز السياسة والاقتصاد معاً، ما يشكّل مؤشراً حاسماً يجدر تتبعه في مسار النظام المتعدد الهجين.
ربما يجدر أيضاً تذكر أن الوضع الراهن استراتيجياً يتضمن أيضاً وجود 3 كتل اقتصادية تمسك بـ80% من الاقتصاد العالمي، محور كل منها قطب في النظام الدولي المتعدد الهجين، هي كتل أميركا [خصوصاً بالامتداد القاري الجنوبي والشمالي]، والصين مع 13 دولة في “سوق التجارة الحرة التقدمي الشامل”، والاتحاد الأوروبي. وهناك 3 دول خارج الكتل الثلاثة، روسيا وبريطانيا والهند. وسيكون تفاعل كل منها مع الكتل الثلاثة حاسماً استراتيجياً، بما في ذلك مجالات الطاقة والبيئة والتكنولوجيا المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
الصين وأميركا: ليست ثنائية قطبية لكنها تنتظر روسيا
في منحىً متصل، ربما يتوجّب التنبّه إلى محورية التجاذب الثنائي بين أميركا والصين في النظام الهجين، لكن ذلك لا يجعله ثنائياً على غرار الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية. إذ يشهد النظام المتعدد الهجين صعوداً للقطب الأوروبي يستدعي انتباهاً خاصاً، بما في ذلك تصاعد التصرف المستقل و”الحيادي” الاستراتيجي لأوروبا، خصوصاً حيال الحليف الأميركي المتقدم في معطيات القوة الاستراتيجية ومكوناتها. وتعطي القمة الثلاثية في تموز (يوليو) 2021 بين فرنسا وألمانيا والصين، نموذجاً عن مسألة التصرف المستقل. ويقود ذلك مباشرة إلى روسيا التي قد لا تكون مجازفة الإشارة إلى أنها تمسك ببيضة الميزان في تشكّل النظام المتعدد الهجين برمته، أكثر من الدول كلها. وبذا، يجدر التركيز خصوصاً على العلاقات بين أوروبا وروسيا باعتبارها نقطة التوازن والحسم، وتظهر أميركا والصين في خلفية ذلك التجاذب.
إلى حد كبير، قد يعتمد مسار تبلور النظام الهجين على مسار تلك العلاقات المتشابكة. ومثلاً، في أحد طرفي الطيف، قد تتقارب روسيا وأوروبا، ولعل ذلك يعني ذلك بلورة سريعة تماماً للقطب الأوروبي في النظام الهجين، خصوصاً بلورة الذراع العسكرية والنووية [وتذكيراً، الفضائية والرقمية في الفضاء السيبراني]، إضافة إلى نوع من “موازنة” خروج بريطانيا كقوة استراتيجية. وربما يعتمد الشيء الكثير على تصرّف أميركا حيال روسيا، بمعنى وجود مصلحة أطلسية مشتركة في ألا تُلقي روسيا بثقلها على الأمن الأوروبي، وكذلك في اجتذاب روسيا خارج أفق “الأوراسية” مع الصين. ثمة مشروع “أوراسي” آخر، يعتمد أساساً على تفاعل إيجابي استراتيجي بين أوروبا وروسيا، ويشمل دوائرهما في النفوذ، خصوصاً البحر المتوسط والشرق الأوسط.
وهنالك مساحة رمادية في تصرّف أميركا إذا تزايد اقتراب روسيا من أوروبا إلى درجة قد يتشكّل معها ما هو أكثر من منظومة توازن قوى قاري وعالمي. كيف ستنظر أميركا إلى تقارب روسي أوروبي يحمل إمكانية زيادة استقلال أوروبا استراتيجياً عنها؟
وفي الطرف الآخر من مروحة الطيف نفسه، ربما تنحو الصين صوب نسج تحالف مع روسيا [بمعنى التحالف المرن الذي يستمر طالما تناقضاته الداخلية أقل من الخطر الخارجي على أطرافه]، ضمن مسارها الاستراتيجي الذي لا يقتصر على المشروع العملاق “حزام وطريق” الذي ترصد له عشرة تريليونات دولار في أضخم مشروع بشري حتى بالمقارنة مع بناء الأهرامات. في تلك الحالة، ربما تحصل ولادة متعرجة لمشروع أوراسي صيني- روسي، يرسم صورة مغايرة في مسار النظام الدولي الهجين.
واستطراداً، ستكون علاقة ذلك المحور الأوراسي مع بريطانيا، عنصراً أساسياً في مصير أوروبا كله، وكذلك مسارها كوزن دولي متحالف مع أميركا في حلف الناتو وغيره. هل يخلو من الدلالة أن بريطانيا تقدّمت بطلب الانضمام إلى اتفاق “سوق التجارة الحرة التقدمي الشامل” المتمحور حول الصين؟
تذكيراً، لعل أول قفزة نوعية في التحقّق الاستراتيجي لمشروع “حزام وطريق” حدثت في 2017، مع وصول أول قطار انطلق من الصين ليصل إلى لندن في ظل حكومة محافظين قادتها تريزا ماي. وربما في السياق نفسه، يظهر أن أول اتفاق اقتصادي بارز عقدته بريطانيا بعد بريكست، جاء مع اليابان. وثمة تناقضات هائلة بين الصين واليابان تشمل تنافسهما طويلاً على المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تراكمات تاريخية سلبية، لكن يقابل ذلك كله علاقة اقتصادية متصاعدة عبر اتفاق “سوق التجارة الحرة التقدمي الشامل” الذي يشملها [اليابان] مع الصين و12 دولة في المحيط الهادئ. وكذلك جاءت الخطوة البريطانية الثانية باتجاه الهند [التي خرجت في اللحظة الأخيرة من اتفاق “السوق الحرة…”]، محمولة على صهوة “حرب اللقاحات”، مع سماح بريطاني مُبَكّر بإنتاج لقاح “آسترازينيكا” في الهند التي تمثّل الصانع الأول للقاحات [غير كورونا] عالمياً. وتشكل الهند طرفاً في رباعية “عمالقة آسيا”، مع الصين واليابان وروسيا.
وفي ملمح متصل، بات الوزن الدولي للهـند معلقاً على طريقة تعاملها مع جائحة كورونا التي صدَّعت أسس بنياتها الداخلية، وكشفت خلل نموذج التنمية فيها، على الرغم من ضخامة إنجازاته التي جعلتها سادس اقتصاد عالمي مع بنية علمية وتكنولوجية قوية. قد تعتمد أشياء كثيرة في الهند، بما في ذلك وزنها الدولي، على مسار التفاعلات العميقة لانكشافاتها أمام جائحة كورونا.
أفغانستان نموذجاً عن “اللاعبين غير الدوُلاتيين”
لعله من الصعب اختتام مقدمة عن النظام الدولي الهجين من دون الإشارة إلى اللاعبين غير الدُولاتيين [= من خارج الدولة كمؤسسة تاريخية]، خصوصاً الإسلاموية والتنظيمات الإرهابية المتصلة بها. لعله ضروري تذكر أن ثمة تواهن تاريخي في معظم العالم الثالث [وخارجه أيضاً؟] للدولة كمؤسسة تاريخية. وفي المقابل، أسهمت العولمة في صعود قدرات اللاعبين غير الدوُلاتيين. ماذا لو ارتطم هذان المتغيران؟ ربما يفيد النظر إلى أفغانستان في رصد ملامح الإجابة. ماذا لو تمكنت “حركة طالبان” من تحقيق حلمها التاريخي، بل ربما سبب وجودها الأصلي، بأن تنهي حروب أفغانستان الداخلية وتفرض سيطرتها الكاملة على ذلك البلد؟ ماذا حينما يتحوّل لاعب غير دوُلاتي إلى نظام دولة، خصوصاً في منطقة فائقة التشابك لأنها تقع على خط الحرير القديم ومسار “حزام وطريق”، وتتصل بالدول المحيطة ببحر قزوين التي يتصاعد دورها مع صعود دور الغاز في مشهدية الطاقة التاريخي وحلوله بديلاً للبترول؟ إذا لم تكفِ تلك التشابكات، فمن الممكن أن يُضاف إليها ذلك التفاعل المعقد بين أولئك اللاعبين كلهم من جهة، وأقطاب النظام الدولي [واستطراداً، بعض الأطراف الفاعلة في منظومات توازن القوى الإقليمية]، الذي يمتد من استمرار ما يشبه قوة الدفع الذاتي لـ”الحرب على الإرهاب”، ويمر بالتقلبات في مسارات “القاعدة” و”داعش”، ولا ينتهي عند تيارات العنصرية والتفوق العرقي واليمين الشعبوي [مسنوداً بمقولات الليبرالية القومية ومآزق مشروع الديمقراطية والحداثة وما بعدها]. ولعل مشهد اجتياح مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] في 6 كانون ثاني (يناير) 2021، تعبير كثيف عنها، وليس صدفة رواج تشبيهه بهجمات الإرهاب الإسلاموي في 11/9!
ويضاف إلى ذلك، أن تلك المشهدية الفريدة من نوعها في تاريخ القطب الأول للنظام الدولي، أبرزت انقساماً بات معلناً، في النسيج الوطني الأميركي، للمرّة الأولى منذ قرابة 145 سنة.
في المقابل، ثمة تيار عميق يتفاعل في عمق المعادلة بين الشعوب ومؤسسة الدولة [خصوصاً في الغرب] مسنوداً بزيادة قوة الأفراد والمجموعات، وزيادة الميل إلى اليسار في أميركا مع بروز قوى مناهضة العنصرية [“أنتيفا” مثلاً، ومعنى إسمها هو “ضد العنصرية”]، والدفع نحو اقتصاد اجتماعي والتشديد على التصدي للامساواة في المداخيل [خصوصاً بفعل تضخم رأس المال المالي] التي ترافقت مع تآكل تدريجي وتاريخي للطبقة الوسطى، وارتفاع نبرة الفكر الإنساني في الفضاء العام، خصوصاً في مساحتي المناخ والجائحة. وهنالك مسارات مماثلة في الغرب عموماً. ربما أسهمت “الأنفلونزا الإسبانية” في عشرينيات القرن العشرين في تعزيز الميول النازية، فهل تكرر جائحة كورونا ذلك أم تسير على النقيض فتدفع صوب فكر إنساني بتلاوين النهضة والتنوير، بل ربما تعزيز بداية عصر شعوب جديد؟
نحو نظام دولي جديد متعدد وهجين
أربعة فرادات أوّلها أن الشرق في قلبه
الأرجح أن هنالك 4 ملامح متفردة تبرز كلها للمرة الأولى في النظام العالمي المتعدد الأطراف، ربما منذ بدايته بعد الحرب العالمية الأولى وتبلوره بعد الثانية، وصولاً إلى لحظة ترمب التي يصعب عدم وصفها بإنها نهاية معلنة للآحادية القطبية الأميركية، ثم لحظة بايدن التي قد تُسجّل بداية ظهور نظام دولي هجين ومتعدد. بعبارات استهلالية، تتمثل تلك الملامح الأربعة في:
1- ظهور قطب أساسي موازٍ [ليس بالضرورة مساوٍ] لأميركا متمثلاً في الصين الآتية من الشرق.
2- حدوث حركة تفكك غير مألوفة في القلب الأنغلو ساكسوني للنظام المتعدد الأطراف عبر نأي أميركا [ترمب] وبريطانيا عنه. ومع بايدن، شرعت أميركا في العودة إلى النظام المتعدد الأطراف. وفي مساحة غير محسومة، تعاني بريطانيا مع بريكست الذي ربما تهدد تأثيراته وحدة مكوّناتها.
3- ثمة قطبان في النظام الدولي “صُنِعا” على يد القطب الأميركي الأبرز فيه، وهما الصين المناوئة لأميركا وأوروبا الحليفة لها.
4- بروز معلم “مزدوج” يتألف من ترادف بروز دور الشعوب بطريقة نوعية فريدة من جهة، وتبلور تدريجي لنظام عالمي جديد، يوصف بالهجين والمتعدد، مع ملاحظة إنه للمرة الأولى، تحدث ولادة نظام عالمي [أو أن يتجدد نوعياً]، من دون انهيار إمبراطورية أو إمبراطوريات. وربما يُصر البعض بكثير من التطرف، على اعتبار النظام الهجين نفسه، نهاية الإمبراطورية الأميركية!
وفي التفاصيل، من المستطاع إيجاز تلك الفرادات بما يلي:
- للمرّة الأولى في تاريخ النظام العالمي الحديث، يأتي القطب الدولي المقابل لأميركا من الشرق. من المستطاع القول إنه يأتي من خارج الغرب، إذا استُعيد اعتبار روسيا جزءاً من الغرب في المشروع الكبير للحداثة وما بعدها. وباختصار، استطاعت الصين تحقيق ثورة صناعية مذهلة، وسارت في تصنيع مكثّف مسنود بتقدم تكنولوجي وعلمي مذهل، تَضَمَّنَ تفاعلاً وتشابكاً نوعياً مع الولايات المتحدة، في الغالب. وأحياناً، جرى الأمر نفسه بالتصادم، على غرار الصراع على الملكية الفكرية للابتكارات والاختراعات، أو تقنيات الطاقة البديلة كتلك المرتبطة بصناعة الألواح الشمسية، ووصولاً إلى اختراقات الـ”هاكرز” مراكز البحوث والمؤسسات الصناعية والعلمية الأميركية، بما فيها الجيش الأميركي.
لقد استطاعت الصين النهوض من تفكك إمبراطوريتها في القرن التاسع عشر التي وصلت آنذاك ذروتها فشكلت نصف الاقتصاد العالمي. وكذلك نجحت الصين في النهوض من فشل متراكم للنظام الشيوعي الماوي في إرساء صناعة مكثفة بالمعنى الذي ترافق مع الصعود التاريخي للرأسمالية وصناعتها، وقد وصفه آدم سميث وكارل ماركس وديفيد ريكاردو معاً! لقد نجحت الصين في إدماج ثورات الصناعة ما قبل المعلوماتية، وأرست بنية تحتية صناعية وزراعية وعلمية مكنتها من الإمساك بتقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطورة والذكاء الاصطناعي. وفي الملمح الأخير، يبرز أيضاً تداخل الصين مع القطب الاقتصادي الأميركي خصوصاً في أن معظم الشركات الكبرى في المعلوماتية والاتصالات المتطورة، تمتلك مصانع ومختبرات ومراكز إنتاج أساسية، بما في ذلك البرمجيات والرقائق الإلكترونية، في الصين. [تحتل تايوان مقدمة الدول المنتجة للرقاقات الإلكترونية، فإذا نجحت الصين في استعادتها، يصبح الوزن الصيني حاسماً في تلك الصناعة التي تعتبر قلب ثورة المعلوماتية والاتصالات المتطورة]. هل يكون مؤشراً وازن الدلالة أن الصين هي الوحيدة التي نجحت في منافسة أميركا في الكومبيوتر الخارق [حاولت اليابان ذلك، لكنها فشلت]، وكذلك في شبكات الجيل الخامس من الخليوي؟
وقبل لحظة كورونا، رسخّت الصين مكانتها في الاقتصاد العالمي بوصفها ثاني اقتصاد في العالم. وفي ظل الأزمة المالية العالمية 2008، تفرد الاقتصاد الصيني بالقدرة على الاستمرار في النمو. وفي ظل جائحة كورونا، تفرد الاقتصاد الصيني مرّة اخرى بالقدرة على الاستمرار في النمو، فيما عانى الاقتصاد العالمي شللاً وبطالة واسعين وغير مسبوقين أقلّه منذ “الكساد الكبير” في ثلاثينيات القرن العشرين، قبل الحرب العالمية الثانية!
وفي تطور مهم، اتّخذ الرئيس السابق دونالد ترمب قراراً بالانسحاب من مجموعة دول “الشراكة عبر المحيط الهادئ” الذي يضم بلاده مع 11 دولة في تلك المنطقة، فانفسح المجال أمام تحرك الصين بقوة في تلك الدائرة الاستراتيجية. وفي ظل جائحة كورونا، توصلت الصين إلى عقد اتفاق “سوق التجارة التقدمي الشامل” الذي ضمها أساساً مع دول “الشراكة عبر المحيط الهادئ”. ويشمل ذلك السوق تحرير التجارة كلياً بين دوله خلال عشر سنوات، مع إعفاءات من الرسوم يشمل 94% من التبادل التجاري بينها، إضافة إلى 15% من حقوق التملك المتبادل بينها. ويبلغ مجموع اقتصادات ذلك السوق 60% من الاقتصاد العالمي، و20% من التجارة العالمية كلها. وبذا، أتيح للصين، للمرة الأولى في تاريخها الحديث، نسج نوع من تكتل اقتصادي يؤدي اقتصادها القوي دور القلب فيه.
ولا يعني ذلك أن النظام الدولي الآخذ في التبلوّر يتسم بثنائية قطبية بين أميركا والصين، بل الأرجح أن ما يتشكّل تحت الأعين يتمثّل في نظام دولي هجين، بمعنى إنه يتضمن نُظماً متنوعة في الاقتصاد والسياسة، سواء أكانت ليبرالية أو غير ليبرالية. وقد يشمل ذلك النظام أيضاً صعود أوروبا إلى مرتبة القطب العالمي، فيما يعتمد تشكّل النظام كله على روسيا بصورة كبيرة. واستطراداً، يشكّل التجاذب/الصراع بين أميركا والصين مسألة محورية في بلورة النظام الهجين، لكنها ليست ثنائية قطبية، بل يحرص الطرفان على إبقائها خارج تلك الصورة.
وتذكيراً، إبان رئاسة ترمب، لم يقلق بعض الاستراتيجيين إلا من المدى الذي ذهب إليه في الصدام مع الصين، بل توقع بعضهم أن تكون الحرب معها مرتسمة في أفق ولايته الثانية. وكذلك يجدر التفكير في ميانمار وهونغ كونغ، كساحات اختبار للتجاذب الثنائي. واستطراداً، سارع بايدن إلى إنشاء القيادة الأمنية الرباعية [اختصاراً، “كواد”. وتضم أميركا وأستراليا والهند واليابان]، ما يشي بتقرّب استراتيجي مفاده الضغط على المدى المباشر للصين، مع ملاحظة أن أستراليا تقع استراتيجياً في مدى الصد المباشر للصين التي دأبت على استمالة أستراليا، ونأت باستمرار عن الصدام معها.
من جهة اخرى، دأب محللون كثيرون على وضع تايوان ومشكلتها التاريخية مع الصين [منذ هَرَبِ زعيم حزب الـ”كومنتانغ” تشيان تشاي تشيك إليها وإعلانه دولة منفصلة عن الصين الشيوعية]، باعتبارها النقطة التي قد تفجّر “الثنائية القطبية” الصينية الأميركية، مع سعي بكين إلى استعادة تايوان عبر تقرّب استراتيجي متواصل ومتراكم. ومع ملاحظة أن النظام الهجين ليس ثنائياً، إلا أنه من المستطاع قراءة مشكلة تايوان ضمن ما يستفاد من تجربة الثنائية القطبية السوفياتية- الأميركية التي شهدت حروباً كثيرة، لكنها لم تفجر ذلك النظام. ربما يفيد تذكّر أن ضوابط ذلك النظام شملت عدم الصدام المباشر بين القطبين بالسلاح النووي، وقد شكل ذلك الآلية الفعلية لنظام الثنائية القطبية [مع استبداله الحرب النووية بحروب بديلة؟]؛ وعدم الاستهداف المباشر للقوى العسكرية للطرفين؛ وعدم التدخل العسكري المباشر في دوائر النفوذ المكرسة. ومثلاً، حاربت أميركا في فيتنام لكنها لم تتدخل عسكرياً في دول الكتلة الإشتراكية أبداً، بل أن التدخل الغربي بالنفوذ في بولندا [حركة “التضامن” بقيادة ليخ فاليسيا] ترافق مع بداية مرحلة حسم “الحرب الباردة”، بمعنى بداية ميل ميزان القوى دولياً، إلى كفة المعسكر الرأسمالي.
- حدوث حركة تفكك غير مألوفة تاريخياً في القلب الأنغلو- ساكسوني للنظام العالمي، تتمثّل في ميل قوتين رئيسيتين فيه [بريطانيا عبر بريكست وأميركا ترمب عبر الأحادية القومية الأميركية] إلى الخروج من نقطة المركز فيه. ولقد سعى ترمب إلى فكفكة حلف الأطلسي الذي شكّل ركناً أساسياً في النظام الدولي المتعدد الأطراف طيلة أكثر من سبعة عقود. الأرجح أن ذلك يفسر سبب الاهتمام الاستراتيجي القوي للاتحاد الأوروبي باستراتيجية العودة إلى الحلف الأطلسي، وبالتالي إلى منطقة القلب في النظام الدولي المتعدد الأطراف، مع رئاسة جو بايدن. لكن، هل عليها الحذر من تحقق أمنياتها؟ ربما ألّا إجابة عن هذا السؤال من دون تتبع العلاقة المتماوجة والحاسمة مع روسيا. وثمة أشياء كثيرة للقراءة في الظلال الاستراتيجية المتداخلة لأزمتي أوكرانيا وخط أنابيب “نورد ستريم 2”.
وفي المقابل، يصعب تصور خروج قوة كأميركا وعودتها إلى قيادة القلب في النظام الدولي، من دون تحريك تأثيرات وآليات وتوجهات مختلفة لدى الأطراف كلها. ولعل تصاعد الميل الأوروبي المعلن إلى الاتكال على الذات، يشكّل مؤشراً يمكن تتبعه في ذلك الصدد.
ولم يحدث في التاريخ الحديث، أن نأت بريطانيا في مستوى استراتيجي كبير، عن القارة الأوروبية. يستطيع هواة تاريخ النظام الدولي الإدعاء بإن ذلك لم يحدث حتى منذ الصورة الأولية المرتجلة والبدائية عن ذلك “النظام” في مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية وحروب نابليون بونابرت. آنذاك، شكّلت بريطانيا، مع احتفاظها بسياستها المحافظة والمتمحورة حول جغرافيا الجزيرة فيها، ركناً أساساً في اتفاقية فيينا (1815). وآنذاك أيضاً، اندرجت بريطانيا في “الحلف المقدس” بين “الأربعة الكبار”، مع النمسا وروسيا وبروسيا. وتبلور ذلك “النظام الدولي” [ليس تماماً بالمعنى الذي نعرفه اليوم]، عبر توازنات أُرسِيَتْ بين “اتفاقية فيينا” و”مؤتمر فيرونا” (1821) حين أُضيفت فرنسا إلى ما عُرف بـ”الخمسة الكبار”، وكذلك وُضِعَتْ صيغة للتعامل مع الإمبراطورية العثمانية. [ثمة من يعتقد بأن مصطلح “الرجل المريض” وُلِد في ذلك المؤتمر الذي أقرّ وضعاً خاصاً لليونان ضمن الإمبراطورية، لكنه أسهم في وصولها إلى الاستقلال سنة 1829]. آنذاك، شكّلت بريطانيا ركناً في صنع ما يوصف أحياناً بأنه نظام أول في “توازن القوى” عالمياً استطاع حفظ السلام [بين الدول الرئيسية في العالم آنذاك] قرابة مائة سنة في أوروبا، على الرغم من ثورات القوميات وحرب “خاطفة” بين ألمانيا وفرنسا. استمر ذلك السلام حتى الحرب العالمية الأولى. ما زال سلام المئة عام الأطول تاريخياً حتى الآن، على الرغم من أنه لم يترافق مع ظهور مؤسسات دولية تعبر صراحة عن آليات نظام دولي، وقد شكّلت بريطانيا ركناً أساساً فيه.
واستطراداً، الأرجح أن بايدن يحاول طي فصلٍ صادمٍ من النأي الأميركي عن النظام الدولي المتعدد الأطراف أثناء رئاسة ترمب. وعلى الأقل، أعلنت أميركا بايدن تَجَدُّدْ الشراكة الأطلسية مع أوروبا، وأبلغت الأمم المتحدة رسمياً عودتها إلى ذلك النظام. وربما لا زال الأفق غائماً أمام بريطانيا تحت قيادة بوريس جونسون، المستمرة في تنفيذ بريكست الذي قد يهدد وحدة مكوّنات المملكة المتحدة. لكن، الأرجح أن الوقع العميق لذلك النأي الاستراتيجي المزدوج ما زال مستمراً.
- تبرز مفارقة مهمة في ثلاثية أميركا والصين وأوروبا. إذ يجدر تذكّر أن أميركا “صنعت” القطبين الصيني والأوروبي. وعلى عكس ذلك، وضعت أميركا نفسها مرتين تاريخيتين في مواجهة “روسيا”. جاءت المرة الأولى مرّة عندما أسهمت أميركا، ربما بصورة ليست فائقة الوضوح، في تفكيك إمبراطورية القياصرة. [تذكيراً، أدّت روسيا القيصرية دوراً محورياً باستمرار في صنع نظام لتوازن القوى في القارة، بما في ذلك بعد الحروب النابوليونية حينما مثّل ذلك التوازن الأوروبي ما يشبه “نظاماً” دولياً نظراً للمدى الاستراتيجي الواسع للإمبراطوريات الأوروبية آنذاك. ومهد تخلخل ذلك التوازن لزلزال سقوط الإمبراطورية العثمانية]. وحلّت المرّة الثانية للمواجهة الاستراتيجية بين أميركا و”روسيا”، بعد الحرب العالمية الثانية، إبّان الثنائية القطبية بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
إذاً، يجدر التذكير بأنه مع نظام الثنائية القطبية، انخرطت أميركا في صنع أوروبا عبر مسارات تضمنت “مشروع مارشال” و”اتفاقية برايتون وودز” التجارية، والمؤسسات الدولية للنظام المتعدد الأطراف، مع إبقائها [أوروبا] تحت سقف الدولار كعملة مرجعية عالمية وأداة حاسمة في إدارة أميركا النظام الاقتصادي عالمياً. ثم شرعت أميركا في “صُنع” الصين الحديثة إبّان اقتراب نظام الثنائية القطبية من نهايته، أو بالأحرى ضمن تقّربها الاستراتيجي الواسع في صراعها مع الاتحاد السوفياتي، بهدف الانتصار على ذلك الخصم. ربما تُذكّر تلك المعطيات مجدداً بأن محتوى النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية لم يشكّل عنصراً حاسماً فيه، بمعنى إنه لم يكن نظاماً ليبرالياً، فلا سَعى دوماً إلى نشر الليبرالية كشرط حتمي ولا اقتْصَر حصراً على نظم ليبرالية.
وبالاستعادة، ربما ليس مجازفة القول إن الصين أيضاً أسهمت في المقاربة الأميركية حيالها بأن وضعت نفسها خارج دائرة النفوذ السوفياتي بصورة متدرجة. وبالتالي، فقد تجنّبت الصين أيضاً أن يتصرف الاتحاد السوفياتي معها باعتبارها دائرة نفوذ مباشر على غرار ما فعل في هنغاريا 1956 وتشيكوسلوفاكيا 1968. واستطراداً، أسهمت قدرة الصين على التصرف باستقلال عن القطب السوفياتي، في جعل نفسها وزناً استراتيجياً مستقلاً، عبر ما اشتهر وصفه بـ”الصراع الصيني- السوفياتي”، وربما قبل ذلك عبر جهدها المميز في مشروع كتلة دول عدم الانحياز [وقد فشل لاحقاً]. ويستطيع هواة التاريخ أيضاً أن يروا في ذلك تطبيقاً صبوراً لمعادلة صعود التابع إلى حليف ثم محايد ثم وسيط ثم خصم مناوئ. [هل تسلك أوروبا المسار نفسه مع أميركا في النظام العالمي الهجين؟].
وفي المقابل، انفتحت الصين على القطب الأميركي المعادي للسوفيات في مستهل السبعينيات من القرن العشرين، مع زيارة هنري كيسنجر التاريخية الشهيرة إلى بكين. وكذلك شكّلت تلك الانعطافة التاريخية بداية الصين الحديثة التي استطاعت خوض ثورة التصنيع بشكل مذهل، بعد أن فشلت مقاربة ماو تسي تونغ فيه طويلاً، وخلّفت ديكتاتورية مريرة. وقد اعتمد نجاحها في دخول ثورة التصنيع، بل صارت “مصنع العالم”، على إمداد ورعاية واستثمار مباشر من أميركا، في التكنولوجيا والشركات والمعرفة وغيرها. باختصار، لقد صنعت أميركا القطب الصيني الذي تواجهه اليوم مع وجود شركات أميركية كبرى في الصين، مع وجود درجة عالية تماماً من الاعتماد المتبادل بين البلدين، وتداخل وتشابك واسع بينهما في المعطى المعلوماتي والسيبراني والعلمي وآليات الانتقال إلى “الثورة الصناعية الرابعة”. ربما برزت أزمة شركة “هواوي” كنموذج من ذلك التشابك، مع ملاحظة أنها تشكّل نقطة بارزة لتقدم تقني واضح في المعلوماتية والاتصالات للصين على أميركا. ويحدث أمر مُشابِه لكن بوضوح وحسم أقل، في مجالين، على الأقل، من الذكاء الاصطناعي هما الكومبيوتر الخارق [“سوبر كومبيوتر”] والكومبيوتر الكمومي. وربما ثمة نموذج آخر للتداخل يبرزه مختبر “ووهان” المتهم بكونه مصدراً لفيروس كورونا، لكنه أيضاً يعمل بتنسيق مباشر مع “المراكز الأميركية لترصد الأمراض والوقاية منها” استناداً إلى تقدمه العلمي في بحوث الفيروسات.
- الأرجح أن هنالك ملمحاً “مزدوجاً” مكوّناً من حركتين متداخلتين ضمن النظام الدولي الهجين. تتمثّل حركته الأولى بحدوث تغيير نوعي في حضور الشعوب فيه. وتأتي الحركة الثانية على شكل “تصادف” بلورة نظام عالمي جديد مع عدم انهيار إمبراطورية/إمبراطوريات للمرّة الأولى في التاريخ الحديث. في الحركة الأولى، من الواضح أن الشعوب باتت تتجاوز كونها داخلاً مؤثراً في كل دولة، يزداد تأثيره مع نوعية كل دولة. وضمن أشياء اخرى، رفعت ثورة المعلوماتية والاتصالات المتطورة قوّة الأفراد [والمجموعات المتنوعة، بما في ذلك الإرهابية بأنواعها] بشكل كبير، وكذلك الحال بالنسبة للجموع الواسعة التي باتت تترابط على مدار الساعة، لكنها تتوزع على محاور متضاربة، وأحياناً فائقة السلبية. إذاً، ثمة متغيّرات عميقة تشمل تكرُّس العولمة الاقتصادية عالمياً عبر نظم متباينة [تشمل الليبرالية الأميركية والأوروبية، والمركزية الاقتصادية الصينية، والنظام المختلط الروسي]، مع ما حملته من تغييرات اجتماعية شتى طاولت مناحي الحياة الاجتماعية على امتداد الكوكب كله. ويضاف إلى ذلك، حدوث توسع مستمر وزلزالي التأثيرات لثورة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتطورة بما في ذلك تداخلها مع القفزة في علوم الجينوم والتطوّر في الفيزياء الكوانتية والتقنيات النانوية، إذ تعتبر تلك القفزة تمهيداً متصاعداً للثورة الصناعية الرابعة. ويضاف إلى ذلك بروز البيئة كمعطى استراتيجي وسياسي وثقافي، ما جعل الموقف منها مؤشراً على اتجاهات السياسة في دولة المركز في النظام الدولي [أميركا]. ولعله من المفيد تذكر أن البيئة تتصل مباشرة بمسألة الطاقة وأسواقها في النفط والغاز والطاقة الذرية وتقنيات الطاقة البديلة. وفي تعبير مكثف، وصف بايدن التعامل مع البيئة في أول قمة مناخ أدارها [نيسان (إبريل) 2021] بإنه يفرض إعادة هيكلة شاملة للصناعة بأكملها. واستطراداً، لعلها ليست مبالغة أيضاً التنبه إلى الموقف من البيئة، ضمن أشياء اخرى، في سياق تلمس نوع من صعود يساري/اجتماعي في الغرب، خصوصاً أميركا. وقد تقوّى ذلك اليسار بعوامل كثيرة من بينها جائحة كورونا وما رافقها من متغيّرات في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وما تمهد له من آفاق فيها أيضاً. بشيء كثير من المبالغة، لربما يتعلق الأمر بعصر شعوب جديد، يشبه زمن ما بعد الثورة الفرنسية! وفي المقابل، أثناء الانتخابات الأميركية 2020، بدت أميركا منقسمة وطنياً بصورة عامودية، للمرّة الأولى منذ حربها الداخلية التي دارت بين عامي 1860 و1877، مباشرة قبيل تحوّلها قوة رأسمالية صناعية فاعلة دولياً. ولعله أمر يحتاج إلى نقاش من نوع آخر يتقصى تداعيات أن تكون أميركا في قلب نظام دولي آخذ في التبلوّر، أثناء معاناتها انقساماً في نسيجها الوطني. الأرجح أن الأمر يتضمن انعطافة ضخمة، حتى لو بقيت ضمن أميركا لكفى ذلك كي يعطيها بُعداً استراتيجياً كبيراً.
إذاً، هل مجازفة القول بوجود “لمسة” يسارية/تقدمية في ذلك النظام الهجين المتعدد؟ لا تسهل الإجابة، لكنها “لمسة” تبرز في استقراء المسارات الداخلية في أقطاب النظام الهجين، بمعنى التبدّل في المعادلة بين النظم والشعوب.
وفي أميركا، برز أخيراً مصطلح “التقدمية” على نحو غير مألوف تماماً ومتمحور حول الشباب والعدالة العرقية والتشديد على المساواة بين الشعوب. وبات “التيار التقدمي” مصطلحاً مقراً به ومتداولاً في المؤسسة السياسية الأميركية، على غرار “الشعبوية” فيها. وفي أميركا والغرب عموماً، تعني تلك التقدمية أساساً الميل إلى اقتصاد اجتماعي مع ثقل وازن للدولة، على غرار اقتصادات الدول الاسكندنافية التي توصف بأنها ليبرالية اجتماعية أو ليبرالية اشتراكية.
وللمرّة الأولى منذ عقود، ثمة شباب أميركي يصف نفسه صراحة بأنه شيوعي. وللمرّة الأولى على الإطلاق، يدور نقاش في الجامعات الأميركية، وقد انتقل إلى فرنسا، عن “يسار إسلامي”. ويشكل ذلك جزءاً من تحولات ما بعد الحداثة في الثقافة، ويحتاج إلى قراءة من نوع آخر.
وفي الحركة الثانية من الملمح “المزدوج”، يبرز أن نظاماً عالمياً جديداً آخذ في التبلور من دون أن يترافق ذلك مع سقوط إمبراطورية. في الصيغة الأولى للنظام الدولي الحديث بعد الحرب العالمية الأولى، تفككت الإمبراطوريتان العثمانية في الشرق الأوسط وإمبراطورية القياصرة في روسيا. يتطلب الكلام عن العلاقة بين التفككين الإمبراطوريين مقاربة أوسع من هذه السطور، لكنه زلزال هائل مازالت أصداؤه تتفاعل حتى اللحظة. في سياق تفكك الإمبراطورية العثمانية، برزت الدول العربية وتركيا الحديثة ومجمل دول المدى الذي يشار إليه في الجغرافيا السياسية بتسمية الشرق الأوسط، متداخلاً مع الجغرافيا السياسية لـ”درب الحرير” التقليدي. في الحدث الروسي، أدى تفكك إمبراطورية القياصرة إلى ولادة روسيا البلشفية ثم المعسكر الاشتراكي، الذي شكّل القطب الآخر للثنائية التي حمت السلم الدولي بين نهاية الحرب العالمية الثانية، مع ملاحظة أن توازن الرعب في السلاح النووي شكّل آلية أساسية في سلام ذلك النظام الثنائي لا تقل عن آلية الصراع بين النموذجين الرأسمالي والاشتراكي! وقد استمرت الثنائية القطبية إلى أن تفكك المعسكر الاشتراكي، وانطلقت العولمة تحت ظلال الآحادية الأميركية المنتصرة آنذاك.
غني عن التذكير بأن تجدد النظام الدولي المتعدد الأطراف، بمعنى انتقاله من صيغة “عصبة الأمم” إلى نظام الثنائية القطبية وآليات النظام المتعدد الأطراف في صيغة الأمم المتحدة، ترافق مع انهيار الإمبراطوريات الغربية بشكلها الاستعماري التقليدي، واستقلال مجموعة كبيرة من الدول خصوصاً في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى تقسيم ألمانيا.
إذاً، ما الذي “سقط” إمبراطورياً هذه المرّة، مع الانتقال إلى النظام المتعدد الهجين؟ لا تسهل الإجابة. ربما يجدر الانتظار والتأمل طويلاً ووئيداً، قبل التوصل إليها. وينطبق وصف مماثل على السؤال عن العلاقة بين عدم حدوث تفكك إمبراطوري أثناء تبدّل النظام الدولي، وبين التبدل الكبير في المعادلة العميقة التي يتشكل طرفها من الدول [ونظمها] من جهة، والشعوب من الجهة الثانية. ليست أسئلة سهلة، وأجوبتها صعبة تماماً.
نظرة خاطفة إلى الداخل الأميركي
الأرجح أن اضطراباً هائلاً في الدور العالمي للولايات المتحدة حدث أثناء ولاية دونالد ترمب، خصوصاً نأيها الظاهر عن قيادة النظام العالمي المتعدد الأطراف وتكسيرها آليات في العولمة الأميركية. ومن الأمثلة على ذلك خروجها من “اتفاقية باريس للمناخ 2015″، وخروجها من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفرض قيود جمركية ضخمة على الصين [بل حتى فرنسا] وصولاً إلى حافة الحرب التجارية معها، واستهداف شركة “هواوي” في شبكات الجيل الخامس للخليوي عبر إجراءات سياسية وعقوبات اقتصادية [وليس عبر التنافس وفق قواعد العولمة]، وتغييرها اتفاقية الـ”نافتا” للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك، واتباعها سياسة “المقعد الخالي” في “المحكمة الجنائية الدولية”، وتقليص مساهماتها المالية في مؤسسات الأمم المتحدة، والتنائي الواضح عن حلف الناتو عبر المطالبة بتدفيع الأوروبيين أثماناً متزايدة [تحت طائلة خفض الحماية الاستراتيجية] وكذلك السعي إلى سحب القوات الأميركية من ألمانيا والقائمة طويلة.
وفي المقابل، برزت سياسة أحادية بصيغة ما سمي بـ”الليبرالية القومية” معبراً عنه بشعار ترمب “أميركا أولاً” [مع استعمال صريح لمصطلح الإمبراطورية، وهو مصطلح استعمله ترمب في حملاته الانتخابية]. إذ ظهر تفرّد التصرف الأميركي الأحادي في مجالات جمّة، خصوصاً السعي الواضح إلى تفكيك النظام الدولي المتعدد الأطراف و[الأهم] السعي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، عبر تأييد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، ودعم حركات الانفصال عن أوروبا في فرنسا [مارين لوبن] وإيطاليا [سيلفيو مالديني] والنمسا [فيكتور أوربان] وغيرها، إضافة إلى دعم رجب طيب أردوغان ضمن الضغط الاستراتيجي على أوروبا في خاصرتها المباشرة [أوروبا الوسطى] ومداها الحيوي [البحر المتوسط، وليبيا شكّلت مثلاً على ذلك].
الأرجح أن أميركا بايدن شرعت في ترك تلك السياسة، لكن ذلك لا يعني انتقالاً إلى نقيضها بالكامل. من الواضح أن مقاربة بايدن الاستراتيجية تعتمد على نظام دولي والتفاعل مع شركاء وأقطاب دوليين، لكن الأمر ليس عودة ميكانيكية إلى النظام الدولي المتعدد الأطراف [والمعولم] الذي سرى قبل ترمب. إذاً، الأرجح أن الأمر يتعلق بصيغة جديدة كلياً للنظام الدولي العالمي. واستطراداً، يصعب وصف النظام الدولي الهجين من دون متابعة الخط الداخلي الأميركي باعتباره ترسيمة أساسية فيه.
وفي 2021، تبدو أميركا كأنها في انتقال نوعي كي تكون شيئاً مختلفاً في العمق [لنقل إنه تغيير في كينونتها] عن “المألوف”، أقلّه في الأزمنة الحديثة، وربما إنه تغيير في كينونة تلك “الإمبراطورية” الفريدة. وعلى الرغم من أن ذلك المتغير يظهر أساساً في الداخل، لكن الفارق بين الداخل والخارج قد لا يستمر طويلاً في الدولة العظمي الوحيدة حتى الآن، بل ربما إنه غير واضح أصلاً. وقد انصبّ أول نقد وجّهه الحزب الجمهوري إلى القرارات الأولى التي اتخذها الرئيس جو بايدن كالعودة إلى “منظمة الصحة العالمية”، وهي من مؤسسات النظام العالمي الذي تولّت أميركا إرساءه وإدارته، أقلّه منذ الحرب العالمية الأولى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى “اتفاقية باريس 2015 للمناخ”، مع ما يعنيه من علاقات مع أوروبا والدول الكبرى عالمياً. لعل الأوضح من ذلك أن الخطاب الأول لبايدن عقب ترسيمه رئيساً، ركّز على عودة أميركا إلى قيادة العالم وإحياء القيادة الأطلسية المشتركة، ما يذكر بانتقادات وجهت إلى إدراة الرئيس السابق دونالد ترمب بإبعاد نفسها عن قيادة العالم، أو بالأحرى التخلي عن تلك القيادة. الأرجح أن العالم الحديث لا يستطيع أن يفكر في نفسه من دون الولايات المتحدة، والعكس صحيح أيضاً.
واستطراداً، لعله من المفيد عرض ما يمكن تسميته بالمدارس أو التوجّهات الاستراتيجية في أميركا، مع تذكر أنها ليست أيديولوجيات، على الرغم من أن بعض مفكريها يسير وفق خطوط أيديولوجية حادة كـ”المحافظين الجدد” الذين برزوا على نحو متدرج منذ رئاسة رونالد ريغن، لكنهم أمسكوا بزمام الأمور مع رئاسة جورج دبليو بوش (الإبن)، ثم عملوا مع ترمب، لكنهم اصطدموا معه آخذين عليه السير في إنعزالية على نمط أميركي غير مألوف!
وفي نفسٍ مماثل، ربما يجدر التنبه إلى أن تلك التوجهات أو الخطوط الاستراتيجية لا تشكّل قائمة حصرية وليست تعريفاً نهائياً ثابتاً بشأن هذا السياسي أو ذاك. الأرجح أنها خطوط غير دقيقة. بالأحرى، يتعلق الأمر بخطوط عريضة تصلح أن تكون “خربشة” تفيد في إلقاء بعض الإضاءات على خريطة الخيارات الاستراتيجية الكبرى في أميركا. ويعني ذلك أن المسار الفعلي للأمور أشد تعقيداً بكثير. لا تصح خطوط تلك “الخربشة” حتى في وصف طرف سياسي أميركي ما، كالرئيس بيل كلينتون أو جورج بوش دبليو بوش (الإبن)، عبر “خلطة” ما من تلك الخطوط. وتذكيراً، إنها أميركا. إنها إمبراطورية على الرغم من أن ذلك الأمر موضع خلاف، لكن لسان السياسة في الولايات المتحدة يكاد يُجمِع على “الفرادة” و”التفوق مع السيطرة”، ما يلامس بسهولة صيغة الهيمنة الإمبراطورية. وكذلك صُنِعَتْ تلك “الإمبراطورية” في ظل مشروع الحداثة الغربي الضخم ومساراته المتشابكة، إضافة إلى أنها ترافقت مع ثورات صناعية وعلمية يرجح أننا نعيش في مسار الثورة الرابعة منها. واستكمالاً، يصعب التأمل في ذلك المشهد السوريالي في اقتحام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، في 6 كانون ثاني (يناير) 2021 أثناء تكريس فوز الرئيس جورج بايدن، من دون تذكر مآزق مشروع الحداثة الغربي، سواء أكانت تلك التي تناولها نقّاد ما بعد الحداثة أو غير ذلك.
وبصورة إجمالية، من المستطاع الإشارة إلى وجود أربع توجهات أو ترسيمات كبرى، في الخيارات الاستراتيجية الأميركية. وتَرَسُّم الحدود المتداخلة بينها وفق تلك النقاط الرئيسة.
- تيار الليبرالية الدولية [الويلسونية]
لعله التيار السياسي الأميركي الأشهر والأكثر تداولاً. ولعله الوحيد الذي يمكن نسبته بوضوح إلى رئيس أميركي بعينه هو وودرو ويلسون الذي قاد دخول أميركا إلى الحرب العالمية الأولى، وقد شكّلت عنصراً أساسياً في حسمها. وتفرّد ويلسون بأنه الرئيس الذي دعا إلى وضع نظام عالمي، بالأحرى وضع مؤسسات تدير العلاقات والنزاعات بين الدول كلها. إلى حد كبير، بدا ذلك كأنه تحقيق حلم المفكر الشهير إيمانويل كانط في كتابه “نحو سلام دائم”، لذا يجري الحديث عن الويلسونية متسربلاً دوماً بأنها توجّه مثالي. ويزيد في صورة المثالية أن المؤسسة التي اقترحها ويلسون لإدارة العالم تمثّلت في “عصبة الأمم” التي شكلت مؤسسة أولى من نوعها تاريخياً. ولقد انهارت سريعاً، بالترافق مع انهيار السلام الهش وغير المستقر الذي صنعه منتصرو الحرب الأولى الذين سرعان ما انخرطوا في الحرب العالمية الثانية. وقد فاقت الأولى هولاً وضخامة، واستُعمل فيها السلاح النووي للمرّة الأولى [والوحيدة حتى الآن، مع الأمل أن تبقى كذلك]، فصار سقفاً للردع الاستراتيجي عالمياً. ويبقى أن الويلسونية يُشار إليها أيضاً بتسمية المدرسة الليبرالية العالمية، بمعنى أنها التوجّه الذي يرى أن المدى الاستراتيجي الأميركي [وكذلك بوصفها قائدة الدول الديمقراطية]، يتحقّق أساساً عبر نشر النموذج الليبرالي الديمقراطي عالمياً، ويكون ذلك دعامة للسلام العالمي أيضاً. ولربما الأهم أنها ترى تثبيت السلام والديمقراطية يكون عبر عمل أميركا عالمياً استناداً إلى مؤسسات النظام العالمي. وتصلح الليبرالية العالمية (الويلسونية) نقطة استرشاد في رسم الحدود بين التوجهات الأربعة، مع التذكير بأن حدودها متداخلة وتؤثر فيها عوامل لا حصر لها. ويبرز الرئيسان الديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما بين من يُنسبون إلى الليبرالية العالمية، من دون أن يعني ذلك أنهم يوافقون بالضرورة على ذلك التحديد.
- المحافظون الجدد والبُعد الدولي
من المفارقة أن يكون “المحافظون الجدد” الذين ضمت صفوف مفكريهم جون بولتون وريتشارد بيرل [المؤثر فكرياً بأكثر من شهرته] وإليوت أبرامز ووليام كريستول وروبرت كاغان و… [بالطبع، من ينسى؟] صامويل هنتغنتون وغيرهم. وتتبنى تلك المدرسة ضرورة العمل الأميركي على المستوى العالمي بالترافق مع نشر النموذج الليبرالي [بالأحرى، النيوليبرالي]. في المقابل، يقف المحافظون الجدد على طرف نقيض مع الويلسونية، في تبنيهم العمل الأحادي الأميركي [= الهيمنة الأميركية المباشرة] عبر التدخل الفاعل المنفرد الذي يشمل العقوبات الاقتصادية والعمل العسكري المباشر وغيرها، من دون الاستناد إلى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، أو بالأحرى مع تجاوزها وعدم الاهتمام بها إلى حدّ يلامس الازدراء.
وبالنسبة إلى هذه المدرسة، لا ضرورة إلى الحصول على تبرير المؤسسات الدولية [حتى لو شكلياً] في التدخل الأميركي المباشر. ويشمل ذلك الحلفاء الغربيين كحلف الأطلسي، الذين يفترض بهم أن يتّبعوا الفعل الأميركي ويسيروا تحت قيادته. إنها مدرسة الآحادية والهيمنة الأميركية، لكنها ليست إنعزالية. ويعتبر جورج دبليو بوش (الإبن) النموذج الأوضح عن ذلك التوجه، على الرغم من أنه استهل رئاسته بعيداً عنه نسبياً، إلا أنه انخرط فيه كلياً مع وجود فاعلين في مقدمة صفوف إدارته على غرار ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول وولفوفيتز.
- السيادة الأميركية “المنغلقة” مع هيمنة عالمية
يتشابه هذا التوجّه مع مدرسة “المحافظين الجدد” عموماً، وهو أسبق زمنياً عنها، لكنه يمقت التدخل الدولي المستند إلى نشر نموذج الليبرالية في دول اخرى. ويرتاح أيضاً إلى التدخل الآحادي المباشر بالوسائل كلها، لكنه لا تؤيد التدخلات غير المجدية بمعنى تلك التي لا تخدم مباشرة المصالح الآحادية لأميركا. في المقابل، يرى ذلك التوجّه أن حفظ السلام العالمي واستمرارية المصالح الأميركية عالمياً يكون بالارتكاز إلى استراتيجية “توازن القوى” [وهو مفهوم أكثر تعقيداً من ظاهر الكلام عنه] كي يخدم استمرارية الهيمنة الأميركية. ويعني ذلك أن ذلك التوجّه السيادي المهجوس بالسيطرة العالمية، يميل إلى العمل استراتيجياً بأسلوب منظومات “توازن القوى” عبر تحالفات مباشرة، وليس عبر مؤسسات النظام العالمي. وكذلك فإنه لا يستثني أن تعمل أميركا في شكل آحادي، لكنه لا يراه خياراً وحيداً. وغني عن القول أنه يمقت النزعة “الليبرالية الدولية”، بل يتصادم معها. ولعل المثل الأوضح على ذلك يأتي من الصدام الذي حدث في رئاسة بيل كلينتون مع “الموجة المُحافظة” التي قادها السياسي الجمهوري البارز آنذاك نيوت غينغريتش، وقد مارس الناشط السياسي بات بوكانان آنذاك دوراً فكرياً فيها. في تشابك ملفت، تعتبر الحروب التي قادها بيل كلينتون المحسوب على مدرسة الليبرالية الدولية، في أوروبا كالحال في يوغسلافيا السابقة وكوسوفو، مثلاً من ذلك التوجه! ولعل ذلك يدل أيضاً على التشابك وتداخل الحدود بين التوجهات الاستراتيجية الأميركية، وأنها ليست أيديولوجيات ورموز وانقسامات واضحة.
- توازن القوى والواقعية السياسية
إنه توجه البراغماتية السياسية بالمعنى العميق للكلمة. يكاد ينطبق وصفه على معظم رؤساء أميركا أثناء “الحرب الباردة”، مع ملاحظة خصوصيات تلك المرحلة التاريخية. وعادت تلك المدرسة بقوة مع رئاسة جو بايدن. وتتبنى هذه المدرسة بعمق استراتيجية “توازن القوى” على المستوى العالمي. وتعتبر مبادرة الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر تجاه الصين (1972) خلال “الحرب الباردة”، نموذجاً صافياً عنها. وتتعامل مع المؤسّسات الدولية ضمن الهيمنة الأميركية عليها. ولعل من يَصِف المؤسّسات الدولية للنظام العالمي في ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنها أدوات الهيمنة الأميركية، يكون قد أشار إلى ذلك التوجه الاستراتيجي الواسع. وفي نموذج أكثر وضوحاً، يبرز الرئيس جورج وولكر بوش (الأب)، مع أركان إدارته المتمرسين في الواقعية السياسية على غرار جيمس بيكر. وتعتبر حرب “عاصفة الصحراء” وتحرير الكويت، نموذجاً عن طريقة عملها في الاستراتيجية العسكرية.
ثمة تنويعات كثيرة على تلك التوجهات الأربعة تشمل “التطرف والاعتدال” و”اليمين واليسار” و”الصقور والحمائم” وغيرها.
أين نضع الرئيس السابق دونالد ترمب؟ إنه خارج تلك التوجهات كلها! وقد تصادم معها جميعها، حتى مع المحافظين الجدد الذين يُعتبرون الأقرب إليه فكرياً. الأرجح إنه يمثل ما يوصف أميركياً بـ”الجاكسونية” [نسبة إلى الرئيس آندرو جاكسون، على الرغم من عدم دقة الأمر]، المتسمة بالمبالغة في التطرف القومي وشعار “أميركا أولاً”، بل وأخيراً أيضاً، والليبرالية القصوى ورفض الضرائب والتخفف إلى أقصى حد من المؤسّسات المركزية في عمل الدولة، وعدم المبالاة بالنظام الدولي وصولاً إلى معاداته. لا شيء مهم في خارج أميركا سوى مصالحها المباشرة التي تحفظها بنفسها بشكل مباشر، عبر علاقات مباشرة مع كل دولة على حدة، و أساسها الخضوع إلى إملاءات المصالح الأميركية. تميل تلك المدرسة إلى العسكر والإنفاق على السلاح، لكنها لا تميل بسهولة إلى الحرب، لأنها إذا انخرطت في حرب، فلا تقبل بسوى الانتصار مهما بلغت التضحيات. لعلها حضرت في ثنايا الحذر الذي أبداه هنري كيسنجر تكراراً حيال ترمب، خصوصاً خشيته انزلاق سيد البيت الأبيض آنذاك من حرب تجارية مع الصين، إلى نزاع مسلح معها.
ولا يمكن وصف التوجه الترمبي سياسياً من دون الحديث عن الشعبوية العالمية وما يلابسها من إسلاموفوبيا وعداء للمهاجرين وتفوق العرق الأبيض ونظريات المؤامرة و”الاستبدال العظيم” وغيرها.
ويصعب الحديث عن الداخل الأميركي من دون الإشارة إلى أن ميل الرئيس جو بايدن إلى الواقعية السياسية، والاتكال على منظومات إقليمية أساساً في توازن القوى، يسير مع تبلور نظام هجين متعدد يتيح هوامش واسعة ومرنة أمام القوى الإقليمية أيضاً. ربما يحمل ذلك أملاً في إمكانية ضبط صراعات إقليمية [الخليج، سد النهضة، أفغانستان…]، لكنه محمّل بالخطورة أيضاً. ففي أفريقيا ودول الساحل خصوصاً، ثمة محك ضخم في كيفية تعامل النظام الدولي الهجين ومنظومات توازن القوى، مع استمرار الحركات الإسلاموية المسلحة فيها. هل يستطيع النظام المحافظة على الدول واستقرارها، ضمن ما يشبه المفهوم الويستفالي للدولة؟ كيف يتصرف إذا استطاعت حركة ما مرتبطة بـ”القاعدة” مثلاً، الوصول إلى السلطة؟ ثمة سابقة ربما آخذة في التبلور في أفغانستان، يجدر متابعتها بدقة، مع الانسحاب التاريخي الأميركي والأطلسي منها. هل يسهل قبول الداخل الأميركي بمشاركة أميركية، في تدخلات عسكرية مساندة لأوروبا في دول أفريقية، في ظل النظام الدولي الهجين ومعطياته؟ كيف سيقدّم ذلك إلى الداخل الأميركي، وبأي درجة من النجاح؟ الأرجح إنها مساحات غامضة.
أوروبا وروسيا: ربما “فالس” أو تخلخل مستمر
هنالك ما لا يحصى من الاحتمالات، كالعادة في التحولات التاريخية، تتلاعب على الحدود بين روسيا وأوروبا. وفي بداية عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، سعت فرنسا إلى استمالة روسيا، وذكّرتها بحضورها الاستراتيجي الدائم في موازين الأمن الأوروبي منذ أيام القياصرة.
وربما تؤدي أوروبا، بقصد أو من دونه، رقصة صعود في ظل تحالف مختل لمصلحة قوة الحليف [أميركا] الراجحة فيه. [مثلاً، استطاعت الإمبراطورية النمساوية في القرن التاسع عشر الصعود في ظل تحالف مختل لمصلحة نابليون بونابرت]. ويحتل البحر المتوسط مركز دائرة النفوذ الأولى في صعود ذلك القطب الأوروبي المحتمل [ربما ليس مؤكداً]، وكذلك تؤدي علاقتها مع روسيا دوراً حاسماً ومركزياً في ذلك الصعود، إذا نجح، خصوصاً مع استمرار خروج القوة البريطانية من أوروبا.
ثمة ملمح من المهم الإضاءة عليه ولو بإيجاز. لقد عاشت أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية تحت معادلة تمنع تحوّلها قطباً دولياً، بمعنى استمرارها في صيغة منظومة توازن القوى، لكنها تتضمن أيضاً مساراً مغايراً يدفع في بلورتها كقوة وازنة على الصعيد العالمي. أدارت أميركا تلك المعادلة بنجاح، فأسهمت في تشكّل الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم خلافات واسعة، تكاد تجمع التوجهات الاستراتيجية الأميركية على تعزيز أوروبا مع منعها من التمركز على نفسها كقوة مالية دولياً، بمعنى إنه إذا سعت أوروبا إلى فرض الـ”يورو” كعملة موازية للدولار في الاقتصاد العالمي [كأن يكون مرجعية في تسعير النفط]، فتكون كل الاحتمالات مفتوحة معها، وفي مقدمها الحرب التجارية والاقتصادية.
في مرحلة الآحادية القطبية الأميركية، تدخلت واشنطن في قلب الأمن الأوروبي ورسمت الخريطة الجغرافية السياسية لأوروبا في ما بعد “الحرب الباردة”، عبر جهد عسكري مباشر في كوسوفو والبلقان، والتدخل في تشيكيا وسلوفينيا وغيرها. ربما برز ذلك في خلفية موقفهما [أميركا وأوروبا] المتباين نسبياً أثناء حرب العراق. وقد عاشت أوروبا موقفاً استراتيجياً مغايراً مع أميركا باراك أوباما التي شرعت في الخروج من الآحادية وتوسيع العمل عبر حلف “الناتو”. وبرز ذلك مثلاً في “الربيع العربي” والحروب التي رافقته، ودعم القوات الأوروبية [الفرنسية أساساً] في مالي والتشاد، والتنسيق بين قيادة القوات الأميركية في أفريقيا [مقرها الجزائر] ونظيرتها الأوروبية، خصوصاً في دول الساحل الأفريقي وغيرها. وفي ذلك الصدد، وبين قوسين، تجدر ملاحظة حدوث انتقال في الجهد الاستراتيجي للاسلاموية المسلحة [التي تمثّل أبرز اللاعبين غير الدُوَلاتيين حاضراً] باتجاه دول أفريقيا، خصوصاً دول الساحل وما تحت الصحراء الكبرى. ولعل ما حدث في التشاد أخيراً يعطي نموذجاً عن إمكانية أن يصل ذلك الجهد إلى الإمساك بالسلطة في دولة أفريقية. ولعله يعبّر أيضاً عن الإمكانات الواسعة أمام اللاعبين غير الدُوَلاتيين في النظام العالمي، لكن مع التشديد دوماً على تداخلهم مع المنظومات الإقليمية، وصولاً إلى أقطاب النظام الدولي.
وفي ملمح مختلف، الأرجح أن الوضعية الاستراتيجية لأوروبا في النظام المتعدد الهجين، تتأثر كثيراً أيضاً بمواقف اللاعبين غير الدُوَلاتيين الفاعلين، إقليمياً أو دولياً، والذين تعاظمت قوتهم، بشكل متناقض، مع العولمة التي قادتها أميركا منذ تسعينيات القرن العشرين. إذ ترافقت تلك العولمة مع انتشار مصادر القوة في العالم، خصوصاً مع تقدم المعلوماتية والاتصالات والتقنيات المتطورة التي تشمل الفيروسات الإلكترونية وهجمات القرصنة على الدول الكبرى والشركات العملاقة، وإمكانيات شن ضربات جرثومية وغيرها. لقد بات الفاعلون غير الدُوَلاتيين أكثر قدرة على تعطيل مسار نفوذ الدول محلياً وإقليمياً ودولياً، وينظر إليهم عموماً كعناصر خلخلة في النظام الدولي. وتعطي “القاعدة” و”داعش” نموذجاً من أولئك الفاعلين الذين ليسوا معزولين عن الدول الإقليمية والدولية، وكذلك فإن تأثيرهما في أوروبا بات ملموساً، بل يشكّل أحياناً جزءاً من الآليات السياسية الداخلية، خصوصاً مع أزمة المهاجرين والإسلاموفوبيا وتفاعل تيارات شعبوية يمينية متطرفة معها.
وتسهم علاقات الأطراف غير الدُوَلاتية مع الدول ومناطق النفوذ، في تحديد قدرة تلك الأطراف على التزوّد بالمصادر والموارد، بما في ذلك البشرية، وكذلك تحديد أمدية انخراطها في مشاريع دول إقليمية ودولية. وربما يفيد النظر إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان من تلك الزاوية أيضاً، خصوصاً تشابكها مع تشكّل نظام دولي عالمي هجين ومتعدد.
وفي ذلك السياق من التفاعل بين أقطاب النظام الدولي والقوى الإقليمية والفاعلين غير الدُوَلاتيين، تقدم تركيا نموذجاً في فرادة علاقتها مع التنظيم العالمي لـ”الإخوان المسلمين” [وضمن آليات متداخلة مع ما يحصل في أفريقيا أيضاً]. إذ باتت أوروبا تتفاعل مع تأثيرات ذلك النموذج التركي، بطرق قد تؤثر في عمق مسارها كقطب، بل حتى وجودها كاتحاد أوروبي. وفي الوضعية الاستراتيجية لتركيا، ثمة اندماج بين قوة إقليمية صاعدة من جهة، وقوة غير دُوَلاتية من ناحية ثانية. وقد استفادت روسيا وأميركا ترمب، من تلك الوضعية في “الاشتباك” بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويبدو إداء إدارة بايدن مختلفاً في ذلك المجال، فكيف سيسير ذلك؟ [يصعب عدم القول بأن إيران تشكل نموذجاً مشابهاً].
وتؤثر تلك الوضعية الاستراتيجية لتركيا، بصورة مباشرة على المدى الاستراتيجي المباشر لأوروبا في المتوسط [وكذلك أفريقيا]. ويشمل ذلك اليونان وليبيا واليونان ولبنان ودول شمال أفريقيا وقبرص ومصر وسوريا وغيرها. وربما بديهي رؤية “غاز المتوسط” في عمق ذلك المدى وخلفيته، إضافة لكونه من المتحولات الاستراتيجية في مشهدية الطاقة العالمية.
واستطراداً، لعل حدوث كل تلك التفاعلات على حدود الاتحاد الأوروبي وروسيا معاً، مؤشرٌ آخر على مدى الوضعية الحاسمة التي تمتلكها روسيا في النظام الدولي الهجين. ويعني ذلك أن قدرة أوروبا على ضبط القوة الإقليمية لتركيا، والطريقة التي تتعامل بها مع روسيا في ذلك الإطار، وكيفية تشابك ذلك مع علاقتها مع أميركا، [إن تلك القدرة] قد تؤدي دوراً حاسماً في تبلور القطب الأوروبي [أو عدمه]. وربما اتصل ذلك مباشرة بالوضع العربي، خصوصاً عبر سوريا والعراق.
وثمة مشهدية مشابهة لتركيا في تعامل أوروبا وروسيا مع صعود إيران إلى مستوى القوة الإقليمية. ويسهم البعد الجغرافي نسبياً عن أوروبا [رغم التلامس المباشر في أرمينيا]، ووجود مشروع نووي في طهران [يغيب عن تركيا]، والمخزون الاستراتيجي الهائل للغاز الطبيعي في إيران، [يسهم] في جعل علاقة أوروبا مع إيران مغايرة عما يحصل مع تركيا. وكذلك يبرز في تعامل أوروبا مع إيران ومشروعها النووي، مدى ميلها [أوروبا] إلى توسيع نفوذها العالمي ولعب دور الوسيط [مع الحليف الأميركي]، ما يقرّبها أكثر من التحرك باستقلالية نسبية عنه. ولأسباب كثيرة، قد يكون من الأجدى نقاش القوتين الإقليميتين التركية والإيرانية في سياق توصيف الوضع العربي.
في مسار مختلف نوعياً وأشد حساسية، يبرز ذلك التفاعل الشديد التشابك بين أوروبا وروسيا في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، ودوماً مع تذكر حضور القوة الأميركية الراجحة في خلفية ذلك التفاعل. وأثناء رئاسة ترمب، ارتاحت واشنطن نسبياً إلى التدخل الروسي في القرم ودونباس [الإقليم المنشق في أوكرانيا]، أقلّه لسببين متعاكسين يتمثلان في استمرار الضغط الاستراتيجي على الاتحاد الأوروبي من خارجه عبر روسيا، وإبقاء جهد استراتيجي روسي مستمر في المشروع الأوراسي البعيد عن الصين. وكذلك تفيد تلك الوضعية في الضغط على روسيا نفسها في علاقتها مع واشنطن.
في المقلب الاستراتيجي الآخر لخط “نورد ستريم 2″، يبرز إنه يعزز التصرف الاستراتيجي المستقل نسبياً للاتحاد الأوروبي حيال القطب الروسي، وكذلك في المجال الاستراتيجي للطاقة العالمية المتجهة نحو مزيد من الاعتماد على الغاز الطبيعي كطاقة أقل تلويثاً من النفط التقليدي. إذ قد يسهم استمرار مشروع “نورد ستريم 2” في استقلالية الاتحاد الأوروبي، ويخفف تصادمه مع روسيا، ويستدرج أجواء أكثر “تحالفية” في علاقته مع روسيا. لقد عارضت أميركا ترمب “نورد ستريم 2” على العكس من مسار إيجابي في علاقتها مع روسيا. كيف ستتصرف إدارة بايدن حيال ذلك؟ لنتذكر أيضاً أن “نورد ستريم 2” الذي يمر تحت بحر البلطيق بموازاة نظيره “نورد ستريم 1″، يحمل كميات هائلة من الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا، ما قد يمهد للاستغناء عن خطوط الغاز البرية التي تمر عبر أوكرانيا وصولاً إلى بولندا وغيرها، أو على الأقل إنه يهدد القيمة الاستراتيجية لتلك الخطوط. واستطراداً، تعتبر أوكرانيا “نورد ستريم 2” تهديداً وجودياً لها.
ومع تذكر الدور المحوري الذي تؤديه روسيا في منظومة الغاز في بلدان آسيا الوسطى، خصوصاً حول بحر قزوين، فالأرجح أن روسيا تشكّل المصدر الرئيس للغاز، وهو أقل تلويثاً من النفط والفحم الحجري، ويصعد بسرعة ليكون بديلاً عنه، بالنسبة إلى أوروبا. إذاً، فالأرجح أن خطوط الغاز عبر بحري البلطيق والأسود [خصوصاً “الممر الجنوبي” ومشروع “الممر التركي”]، ستصنع ملمحاً حاسماً في علاقة روسيا مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع مسارات أوروبا نفسها، بما قد يزيد بأشواط كثيرة عما تفعله الآليات المتعلقة بغاز المتوسط.
وستسهم الطريقة التي تحل فيها أوروبا المشكلة الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي تتصل بخط شبه مباشر مع تركيا، أقله عبر خطوط الملاحة الاستراتيجية في بحار كالأسود وآزوف؛ [ستسهم] في رسم الآفاق الاستراتيجية الفعلية أمام أوروبا، في علاقتها مع روسيا وأميركا. ويلاحظ منذ الآن، ميل أوروبا إلى موقف متفاعل “إيجابياً” مع روسيا، يتضمن أفقها نسج توازن أو صيغة تحالفية مرنة، ليس بالضرورة تحالف، مع روسيا.
وفي إطار مُشابه، تقدم أفغانستان نموذجاً عن تبادل الضغوط بين أقطاب النظام الدولي ضمن منظومة توازن قوى [مختلة]، لكنها تتجه إلى وضع قد تتمكن فيه قوّة غير دُوَلاتية [حركة “طالبان” المتصلة بـ”القاعدة”] من الإمساك بمصير دولة أساسية على “خط الحرير” وتربطها صلات مع مشاريع الغاز الكبرى حول بحر قزوين، ما يزيد أهميتها في مشاريع استراتيجية لدول كروسيا والصين. لقد دخلت أوروبا عسكرياً إلى أفغانستان ضمن حرب شبه آحادية قادتها أميركا أيام جورج دبليو بوش (الإبن)، ضمن سياق وُصِفَ بأنه الحرب على الإرهاب. وبالتدريج، تحوّلت أفغانستان نقطة تجاذب مع روسيا أيضاً، بفعل نجاح روسيا في تحسين علاقتها مع “طالبان”، ضمن صيغة من العلاقة بين موسكو وصعود القوة الإقليمية لتركيا. وباتت أفغانستان من المحكّات المهمة للنفوذ الأوروبي الاستراتيجي مع أميركا وروسيا والصين.
ويتصل بأفغانستان مباشرة، الوضع المتشابك في باكستان. إذ نجحت روسيا في نسج علاقة متطورة مع باكستان التي تحتفظ بعلاقة متينة تقليدياً مع الصين. وثمة أزمة في العلاقة بين فرنسا وباكستان، تتشابك للمفارقة مع الإسلاموية وإشكالياتها، لكن دولاً أوروبية اخرى، خصوصاً ألمانيا، تحفظ أجزاء كبيرة من الحضور الاستراتيجي لأوروبا في تلك المنطقة الحساسة التي تتميّز بتشابكها مع “درب الحرير” والتوازنات المتعلقة بالهند، والمنظومة الإقليمية المتصلة بإيران، وصولاً إلى الشرق الأوسط في قسمه العربي.
ربما ليست واضحة تلك الصيغة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وإمكان صعوده كقطب دولي أساسي [باستقلالية]، لأنها تمثّل أمراً متبدلاً وغير محسوم ويحدث للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
إذاً، ربما يجدر تذكر أن النظام الدولي صُنع للمرة الأولى، بالنسبة إلى أوروبا، بعد الحرب العالمية الأولى، في ظل زلزال تفكك الإمبراطورية الإسلامية واستمرار انهيار الامبراطورية الصينية [وسبقتها الهند بكثير]، وبداية انهيار صيغ الاستعمار المباشر الذي بدا خطاب النظام العالمي آنذاك، خصوصاً الأميركي، ميالاً إلى الخلاص منه. ثم ظهر النظام الدولي الحديث المتعدد الأطراف بآليات ومؤسسات كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
وفي المجال الأوروبي، ربما يجدر أيضاً التذكير بذلك الشكل التاريخي المرتجل وغير المقصود من “النظام” الدولي الذي ساد في القارة قرابة مئة سنة فصلت بين سقوط نابليون بونابرت وبين الحرب العالمية الأولى. لقد استمر ذلك “النظام” في أداء مهتمه بنجاح كنظام توازن قوى استراتيجي بين الدول القوية الحاسمة أوروبياً [وعالمياً، في مرحلة الاستعمار الأوروبي عالمياً والسيطرة على التجارة الدولية وموارد كبرى]. وكذلك استمر “النظام” نفسه، في أداء مهمة التوازن في ظل عصر القوميات الأوربية وتبدّل الجغرافيا السياسية والكيانية [استقلال اليونان والوحدتين الألمانية والإيطالية…]، وانهيار النُظُم التي شكّلته، وكذلك تبدّل صيغ السلطة والحكم فيها. وتالياً، فلربما تساعد استعادة تلك المعطيات في رسم مَعْلَم مهم قوامه أن النظام الدولي لا يتعلق بنماذج الدول قدر اتصاله بشبكة التوازن العميق بين القوى الرئيسية التي تدير المشهد العالمي على المدى الواسع، خصوصاً في الاقتصاد والسياسة. [باختصار، لا يتحدد النظام الدولي بمضمون معين فيه]. وكذلك يُسجل أنه ارتكز على مفهوم الدولة الوستفالية المستقلة، وهو ما ينادي بعض الدارسين الاستراتيجيين في التأمل بفكرته حاضراً، بهدف استنباط نظام دولي جديد مختلف نوعياً عن “الحرب الباردة” والآحادية القطبية الأميركية.
لقد انتهى سلام المئة عام مع الحرب العالمية الأولى التي شهدت على الأقل حدثين مهمين في الاستراتيجية الدولية. تمثّل أولهما في دخول الولايات المتحدة إلى الآليات الفاعلة للنظام العالمي باعتبارها ركناً فيه، بل إنها أنشأت أول صيغة للنظام العالمي وفق ما نعرفه اليوم. وعبّرت عن ذلك رؤى الرئيس وودرو ويلسون عن “عصبة الأمم” وميثاقها الشهير الذي كرّس مفهوم الدولة الوستفالية المستقلة السيادية، بل اعتبارها أساسية في نظام دولي طوعي يعتمد ويسهل الاعتماد المتبادل، خصوصاً في الاقتصاد. ولم تستطع أول صيغة للنظام الدولي الحديث في “اتفاقية فرساي” (1919)، أن تحفظ السلام إلا هنيهة عابرة. وسرعان ما اندلعت الحرب العالمية الثانية. لقد لُقّبت الحرب العالمية الأولى بأنها “حرب لإنهاء كل حرب”، وظهر من يصف معاهدات فرساي بأنها “السلام الذي أنهى كل سلام”.
واستكمالاً لذلك الملمح، ثمة من يرى أن الفارق بين سلام المئة سنة في فيينا القرن التاسع عشر والسلام الفاشل في باريس القرن العشرين، يكمن أساساً في إصرار منتصري الحرب العالمية الأولى على إلحاق هزيمة كاملة بألمانيا إلى حد الإذلال، وإخراجها من منظومة توازن القوى التي تحفظ السلام. بقول آخر، أن منظومة مستندة على توازن القوى لا تستطيع الاستمرار إذا دُفِع أحد عناصرها إلى دَفْعِ ثمن استمرار ذلك التوازن، ما يعني حصول الأخرين على مصالحهم، مع حرمانه من الموارد وتحقيق المصالح الاستراتيجية. واستطراداً، ثمة توازن مطلوب في توزيع الموارد والقوى بين الأطراف الممسكة بالنظام الدولي، كضمان لاستمراره.
وهنالك عنصر آخر في الانهيار السريع لسلام ما بعد الحرب العالمية الأولى، يتمثل في نأي أميركا السريع عن نظام عالمي صنعته بنفسها. الأرجح أن ذلك حدث لأسباب سياسية داخلية، وربما أيضاً أن أميركا سعت إلى صيغة اخرى للهـيمنة العالمية لا ترتكز على الاستعمار المباشر كحال الدول الأوروبية الكبرى [واليابان وروسيا]، ما وسّع الخلاف حول مضمون النظام الدولي الذي يفترض أن تُديره “عصبة الأمم”. ويضاف إلى ذلك إن تفكك الإمبراطورية الروسية سهّل أمام أميركا نشر نفوذها واسعاً في آسيا، وقد استهلته منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد مدة غير متطاولة كثيراً من انهيار الإمبراطورية الصينية التي شكلت أضخم قوّة عالمية في القرن التاسع عشر، وقد بلغ الاقتصاد الصيني آنذاك نصف حجم الاقتصاد العالمي. ويضاف إلى ذلك أيضاً أن أميركا بعد الحرب العالمية الأولى عاشت فترة الانطلاقة الأولى من تمدد نفوذها بالقوة الناعمة في أوروبا. وبقول آخر، لم تكن أميركا بحاجة إلى “عصبة الأمم” في دوائر نفوذها الاستراتيجي الأساسي، فنأت بنفسها عن نظام عالمي في توازن القوى، لم يستطع الساسة الأميركيون إقناع الشعب الأميركي به أيضاً.
وحاضراً، ثمة خيوط وظلال كثيرة تحضر من تلك المحطات التاريخية ، مع التشديد على إنه في الاستراتيجيا لا يشكّل التاريخ دليلاً إرشادياً مباشراً، لأن تاريخ العالم يفور بالتغيير الدائم، بل أنه ربما لا يفعل سوى ذلك، ما يجعل التجارب التاريخية صالحة كخبرات، وليس كنماذج. [إن صلاحيتها لاستنباط قوانين صارمة وحتمية على غرار ما فعله ماركس في تطبيق الديالكتيك المباشر على التاريخ وتطوّره، موضع نقاش نقدي كبير].
وفي ظل رئاسة دونالد ترمب، عانت أوروبا من سير بريطانيا في مسار معاكس لما كانته بالنسبة إلى توازن القوى الكبرى منذ الحربين العالميتين، بل منذ ما بعد الحروب النابوليونية. وقد جرى ذلك في ظل رفض ترمب بوضوح الآلية الأساسية التي صنعتها بلاده بعد الحرب الثانية، ما يعرف بـ”النظام الدولي المتعدد الأطراف”، على رغم آراء سائدة غربياً من أن كل ذلك النظام انسجم تماماً مع هيمنة أميركية مديدة. وتذكيراً، لقد رعا “النظام الدولي المتعدد الأطراف” الهيمنة الأميركية في المعسكر الغربي أثناء الثنائية القطبية في مرحلة “الحرب الباردة”، من سقوط هتلر وصولاً إلى انهيار “جدار برلين” ثم الاتحاد السوفياتي. وكذلك رعا النظام الدولي المتعدد الهيمنة الأميركية الآحادية، بما في ذلك قيادتها المطلقة للغرب، في ظل العولمة الأميركية [كانت نيوليبرالية في معظمها] منذ أعلن الرئيس جورج وولكر بوش (الأب) ولادة “نظام عالمي جديد” في سياق حرب تحرير الكويت (1990).
وعلى الرغم من ذلك، رفض ترمب ذلك النظام الدولي وعمل على إضعاف حلف الناتو وتحويله إلى مجرد تجمع لدول خاضعة للنفوذ الأميركي المباشر، وكذلك عمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، وأحرز نجاحاً في ذلك عبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي [“بريكست”] الذي بدّل الموقع الاستراتيجي التاريخي لبريطانيا. الأرجح أن التفكك المشار إليه آنفاً في قلب النواة الغربية للنظام الدولي الحديث [بمعنى نأي أميركا وبريطانيا] عنه، قد شكّل حدثاً غير مألوف في ذلك النظام، وأقله إنه أطلق قوة لها آلياتها وتفاعلاتها التي ما زالت مستمرة، بل تسهم في صنع النظام الدولي الهجين الجديد.
وفي سياق متصل، ربما يفيد التشديد على ذلك التفكك في سياق تلمّس التشكّل المتعرج [كالعادة] لمسار نظام عالمي مبتكر يتميّز بأنه هجين تماماً، ويشدد على مفهوم الدول الوستفالية [بالإشارة إلى “معاهدة وستفاليا” (1648) التي ترسم دولة قوامها الاستقلال والسيادة]، ويحافظ على الاعتماد المتبادل بين المجتمعات والدول والشعوب، وقد بات لا غنى عنه [الاعتماد المتبادل] في كل لحظة من العيش المعاصر.
إذاً، تسهم المقاربة الأوروبية الاستراتيجية في ترجيح أن لا يقتصر النظام الدولي المتعدد الهجين على تجديد الثنائية القطبية عبر أميركا والصين، على غرار ثنائية قطبي “الحرب الباردة”. وكذلك فالأرجح تماماً أن الآحادية الأميركية لم تعد ممكنة على الرغم استمرار التفوق الأميركي الاستراتيجي [وتآكل نصيبها في الاقتصاد العالمي]. وكذلك تؤدي العلاقة مع اللاعبين غير الدُوَلاتيين دوراً استراتيجياً مهماً فيها. وتكراراً، لا شيء حاسم في المسار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في النظام العالمي المتعدد الهجين، يفوق التأثير الحاسم لروسيا.
وخارج تلك المنظومة المتماوجة في سقف النظام الدولي الهجين، قد ينفسح المجال أمام تعدد اللاعبين الإقليميين [في الشرق الأوسط، هناك 3 قوى ينطبق عليها وصف القوة الإقليمية كأمر واقع]. في المقابل، يعتمد تكريس القوة الإقليمية أساساً على تعامل النظام الدولي معها بوصفها قوة إقليمية، وخصوصاً علاقاتها الثنائية مع كل قطب من أقطاب النظام الدولي.
وفي ملمح استكمالي، يتوسع مجال المرونة الاستراتيجية، بفعل نأي أقطاب النظام العالمي الهجين عن الانقسام المستند إلى “نموذج” للدولة على غرار ما كانه الحال في الصراع بين النموذجين الرأسمالي والاشتراكي. ويعني ذلك أن محتوى النظام الهجين يتسم بمرونة تجمع الليبرالية بتنويعاتها [أميركا وأوروبا] والنظام الموجه مركزياً [الصين] والنظام المختلط المستند إلى حكم نخبة صغيرة [روسيا] وغيرها. وتشتد المرونة الاستراتيجية مع ميل لدى أقطاب النظام الدولي الهجين إلى الاتكال على منظومات من توازن القوى، خصوصاً على المستوى الإقليمي. ويساعد ذلك التوازن، غير المستند إلى نظم قيمية كالديمقراطية أو الليبرالية، على استمرار ضبط النزاعات. في المقابل، قد يصبح “الضبط” وضعاً مستمراً، فتظهر صراعات خفيضة النيران لكنها تستمر طويلاً، فتكون منطقة تبادل نفوذ مستمر. [أزمة القرم وأوكرانيا وناغورني قرة باخ كأمثلة].
النظام الدولي وأمواله و…ماركس!
هل تصبح أميركا أول قطب دولي تدفعه جائحة كورونا، ومسارات اقتصادية متشابكة، إلى التخلي عن النيوليبرالية المتوحشة، والسير نحو عقد اجتماعي جديد نوعياً، يكون أساسة استعادة قوة الطبقة الوسطى داخلياً، مع العودة إلى العولمة الاقتصادية التي يضمنها نظام عالمي هجين ومتعدد ومختلف نوعياً عن النُظُم الدولية التي سبقته؟
لا تسهل الإجابة عن هذا السؤال، لكنه ملمح جدير بالتتبع اليقظ.
وفي ظل جائحة كورونا، يلاحظ ذلك التضخم المذهل في رأس المال المالي الذي تقافز بسرعة خاطفة مع العولمة الحديثة وما بعدها. وقبل الجائحة مباشرة، حاز 26 مليارديراً ما يساوي نصف ما يملكه فقراء العالم كله. وفي نبرة غير مألوفة وكثيفة الدلالة جاءت على لسان بايدن، ورد أن الـ1% الأكثر ثراءً في أميركا قد جمعوا 4 تريليون دولار أثناء سنة الجائحة. وثمة إقرار رسمي أميركي بأن اللامساواة بلغت نقطة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي لأميركا، مع تآكل الطبقة الوسطى، وعدم تغيّر المداخيل الفعلية لقرابة 65% من الأسر الأميركية منذ نصف قرن. وفي ظل الجائحة، باتت ثروة إثنين من الأثرياء (هما المستثمر التكنولوجي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “آمازون” جيف بيزوس) تفوق ما يملكه 40% من الناس في الشرائح الاجتماعية الدنيا في أميركا. وكذلك يلفت أن بايدن استند إلى تفاقم اللامساواة كي ينادي بضرورة إعادة تشكيل الطبقة الوسطى، وكذلك رفع الضريبة على الشركات الأميركية العابرة للقارات، وإلغاء الخفض التاريخي على ثروات كبار الأغنياء التي أقرها دونالد ترمب عند بداية ولايته. ويضاف إلى ذلك، ارتفاع النبرة أميركياً وغربياً بشأن تبني فرض ضريبة عالمية على الشركات العملاقة العابرة للقارات، خصوصاً الشركات العملاقة في المعلوماتية والاتصالات المتطورة التي باتت تمسك بما يزيد عن 92% من الاتصالات العالمية، لكنها تستعمل الطابع العالمي المعولم في عملها كي تتملص من ضرائب الدول عليها. ولطالما حاول الأوروبيون فرض ضرائب على أعمال تلك الشركات، خصوصاً الخمسة المعروفة بإسم “غافام” GAFAM [“غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”آمازون” و”مايكروسوفت”].
وربما يُفترض أيضاً تأمل ظاهرة العملات المشفرة كـ”بيتكوين” و”كوينبايس” التي لم يستقر بعد وضعها في النظام المالي العالمي. إذ قد تنفجر كفقاعة مالية، لكنها قد تتحول عملة مرجعية. وبين هذين الحدين، ثمة كتلة مالية ضخمة عالمية تتحرك مع تلك العملات، ما يفرض التنبّه إلى علاقاتها مع الأوزان الاقتصادية الكبرى، من الشركات العملاقة إلى الدول الأقوى اقتصادياً، ومروراً بالتكتلات الاقتصادية العالمية.
وفي تطوّر متصل، جاءت الأزمة الاقتصادية لكورونا في وقت لم تتعافَ الاقتصادات الكبرى كلياً من أزمة العام 2008 التي برز فيها بقوّة دور رأس المال المالي في الاقتصاد العالمي، فكرست الجائحة بروز دور تاريخي متميز لرأس المال المالي. ووفق ما لاحظة المتخصص الاقتصادي توماس بيكيتي، لقد فاق معدل الربح على رأس المال المالي [متمثلاً في الأسهم والسندات والمشتقات وغيرها] نمو الاقتصاد العام، للمرة الأولى في تاريخ الليبرالية الاقتصادية. واستطراداً، لقد أسهم ذلك في زيادة الفجوة في صفوف الرأسماليين أنفسهم، بين من يملكون رأس المال نفسه وبين من يجنون الأرباح من انتاج السلع بأشكالها كافة، بما في ذلك المواد الأولية كالنفط. ولاحظ بيكيتي أن الأمر ربما لم يكن متوقعاً حتى في سياق الليبرالية الاقتصادية، لكنه مألوف تماماً في مسار أفكار كارل ماركس. وليس مصادفة أن بيكيتي سمّى كتابه المخصص لدراسة رأس المال المالي الحديث “رأس المال- في القرن 21” تساوقاً مع عنوان كتاب “رأس المال” لماركس، على رغم مآخذ تفصيلية كثيرة لبيكيتي على ماركس.
ومن المستطاع إلقاء بعض الإضاءات الجزئية على بعضٍ من مسارات تلك الظاهرة التاريخية التي باتت تهيمن على الاقتصاد العالمي حاضراً، مع التذكير بأن الرئيس جو بايدن ضمّن خطته الاقتصادية بنداً لزيادة الضريبة على الثروات الكبرى [تكراراً، الثروة] وليس أساسها كالمصانع أو الأراضي.
والأرجح أن تفسيرات تلك الظاهرة تشغل حيزاً كبيراً من نقاشات المفكرين الاقتصاديين عالمياً، ما يعني إنها تحتاج تأملاً مديداً. وقبل ذلك، يجدر التشديد على ثلاثة مقولات أساسية نَظَرَّها كارل ماركس في تتبعه الصعود التاريخي لظاهرة الرأسمالية المترافقة مع الليبرالية الاقتصادية والثورة الصناعية. لقد شكّلت الرأسمالية زلزالاً تاريخياً في التغيير، ولم يتوانَ ماركس عن مديح القدرات الهائلة التي أطلقتها والمتغيّرات التي أحدثتها في مسار الحضارة الإنسانية كلها، بما في ذلك التصنيع وتفكيك الاقطاعية والنظم السياسية المرتبطة بها، إضافة إلى عملها على بلورة الدولة الحديثة مع علاقات اجتماعية مختلفة نوعياً عما قبلها، خصوصاً وضع الإنسان والفرد في قلب مسار التاريخ ونوابض متغيراته. وضمن محاولة إلقاء إضاءات على بعض ملامح في المسار الاقتصادي للنظام الدولي الحديث، من المستطاع استعادة ثلاثة مقولات أساسية لدى ماركس، وهي مشهورة تماماً.
- في سياق السعي الثابت والدائم لأصحاب رأس المال إلى زيادة تراكم المال لديهم، يؤدي كل تقدّم في تقنيات الانتاج إلى زيادة فيه، لكن مردودها يذهب أساساً إلى مُلّاك رأس المال، وليس العاملين وقوى الانتاج. وكيفما سارت الأمور، تبقى أجور العمال ونصيبهم في الانتاج والاقتصاد الإجمالي، بما في ذلك التقديمات المتنوعة والضمانات ومدخرات التقاعد، أقل مما تضيفه الزيادة في الإنتاجية إلى رأس المال. واستطراداً، مع استمرار التطور التقني، تتفاقم ظاهرة اللامساواة والتفاوت، ما يعني أن الفجوة بين مُلّاك رأس المال وبين القوى الذي تنتجه، تستمر في الاتساع. ثمة نوع من “الفقر المضمر” النسبي، بمعنى أن نسبة الرفاه المتاحة للشرائح الوسطى وما دونها تتضاءل دوماً لدى مقارنتها بالإمكانات السريعة التوسع للرفاه لدى أصحاب رؤس المال. يكفي النظر إلى الولايات المتحدة للحصول على أحد أقوى النماذج عن تلك المقولة الماركسية. إذ لم ترتفع حصة العمال والموظفين والشرائح غير الفائقة الثراء في أميركا، خلال الخمسين سنة الفائتة الممتدة منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين. [وتوصف أيضاً بـ”الثلاثين المجيدة”، وفق ما سيصار إلى شرحه بعد سطور قليلة].
وقد ورد ذلك الرقم في غير تقرير أميركي استراتيجي، وتكرر أخيراً على لسان رئيس أميركا [بايدن] نفسه، خصوصاً في سياق عرضه خطته الاقتصادية الأشد ضخامة في تاريخ أميركا، إذ يبلغ إجمالي حجمها ما يفوق الـ 4.2 تريليون دولار. ويلفت في ذلك الرقم الفلكي، أن بايدن وضعه في سياق محاولة إعادة بناء الطبقة الوسطى في أميركا، وربطه أيضاً مع إملاءات جائحة كورونا من جهة، وإخفاقات العولمة [وكذلك محاولة إعادة الزخم إليها]. أليس مستطاعاً اعتبار ذلك مؤشراً آخر، ولو بمقدار، على وجود لمسة من ميل يساري في النظام العالمي الهجين الجديد؟
- يدفع الميل الثابت صوب زيادة تراكم رأس المال، إلى تصاعد توجه الرأسماليين إلى خفض تكلفة الإنتاج، خصوصاً الأجور والضمان، مع التقاط سريع لكل تقنية تزيد في الانتاجية مع خفض الأيدي العاملة، أو عدم زيادتها على الأقل. ومع التطور التكنولوجي، تعمل التكنولوجيا على خفض القوى اللازمة للإنتاج، خصوصاً الأيدي العاملة وأجورها وضماناتها. ويعتبر ذلك في أساس ظهور البطالة، سواء أكانت ثابتة أو متحركة مؤقتة. ومع العولمة التي ترافقت مع تبلور الاقتصاد الرقمي المعلوماتي، كظاهرة نوعية تاريخياً، بدت مسألة الاستغناء عن الأيدي العاملة، أشد بروزاً. وتميل الأتمتة [بمعنى أداء الأعمال عن طريق الآلات التي يسندها الذكاء الاصطناعي] إلى زيادة خفض الأيدي العاملة، بل تُصَعِّب فرص الحصول على عمل أصلاً، لأن العمل يصبح مرتبطاً بمهارات تقنية متقدمة، بل بقدرة الذكاء البشري على التعامل مع الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى التنافس معه، بشكل أو آخر. [استطراداً، قد يصبح التقنيون هم الطبقة العاملة في زمن “الثورة الرابعة” والذكاء الاصطناعي]. وتفيد أرقام صدرت حديثاً من “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” أن 14% من إجمالي 420 مليون وظيفة [= قرابة 60 مليون وظيفة] في دولها، بات قابلاً للأتمتة. ولنلاحظ أيضاً أن دول تلك المنظمة تنتج 70% من السلع والخدمات في العالم. [تعتبر المنظمة أحد أقوى الأمدية في النفوذ الأميركي الاقتصادي، إذ تضم الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وغيرها]. وكذلك تقدر مؤسسة “ماكينزي” المالية العالمية أن 30% ساعات العمل في قابلة للأتمتة.
وربما ليس على سبيل السخرية وحدها أن بعض متابعي مسار ثورة المعلوماتية والاتصالات [التي تمهد لـ”الثورة الرابعة”]، اعتبر أن الروبوت يجسد “العامل المثالي” في ثورة الذكاء الاصطناعي. إنه يعمل بلا أجر، ولا يطالب بضمان ولا تقاعد. يستطيع الروبوت أن يقدم “القيمة المضافة” [تعبير ماركس الشهير عن الربح في عوالم رأس المال] من دون خسارة في الإنتاجية، أو بالحد الأدنى منها [أي المطلوب لتشغيل الروبوت وتجديده]. في المقابل، تحمل الكلمات السابقة وصفاً لأحد أبعاد الأتمتة وتمدد التكنولوجيا الرقمية في الإنتاج، بل ربما العمران البشري بأسره، لكنها مجرد إضاءة خاطفة على وقائع تحتاج سيولاً من النقاش والمعطيات قبل التوصل إلى استنتاجات أو رصد مسارات في شأنها.
- مع التضخم الهائل في رأس مال الشركات والمستثمرين، تتفاقم تلك الظاهرة المعروفة بـ”زيادة تمركز رأس المال”. وقد ورد آنفاً بعض ملامح تلك الزيادة المذهلة وغير المسبوقة تاريخياً. ومرّة اخرى، ربما يفيد التأمل في الاقتصاد الأميركي نفسه [قاطرة الاقتصاد الرأسمالي العالمي] الذي شهد تصاعداً قوياً في ظاهرة تمركز رأس المال [بما فيه ملكية أدوات الانتاج ووسائله] منذ الحقبة الريغانية في ستة قطاعات أساسية فيه [ الانتاج الصناعي، البيع بالتجزئة، الخدمات، تجارة الجملة، المواصلات وإنتاج المعدات والأدوات المختلفة]، وهي تؤمن وظائف 80% من الأيدي العاملة في أميركا. ويعمّق الظاهرة نفسها، أن حصة العمال في إجمالي الدخل القومي الأميركي انحدر منذ 1982، من نصف إجمالي القيمة المُضافة إلى قرابة الثلث في 2012.
وضمن ذلك المسار، من المستطاع القول بإن الاقتصاد- القلب في النظام العالمي شهد منذ بداية النيوليبرالية الريغانية- التاتشرية إلى العولمة الآحادية الأميركية ما قبل مشارفة العولمة الآحادية الأميركية على ختامها، ظاهرة تمركز هائل في رأس المال طاول معظم قطاعاته [ربما ما عدا الزراعة أساساً، وما يتصل بها]، مع تقلص حصة الجمهور الواسع في مجمل الاقتصاد، ما يمكن اعتباره مساراً تقليدياً في توصيف كارل ماركس لمسار الاقتصاد الرأسمالي! وفي سياق مماثل، شهد الاقتصاد العالمي ظاهرة تمركز رأس المال مذهلة، بل فاقت كل ما سبقها في أشكال الانتاج والاقتصاد، لدى شركات المعلوماتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي. ولعله جدير بالتأمل أيضاً أن انطلاقة العولمة الأميركية في تسعينيات القرن العشرين، ترافق مع إفراد بورصة جديدة نوعياً، هي بورصة “نازداك”، مكرسة لشركات الإنترنت والمعلوماتية. وبعد وقت غير طويل، حدث تداخل بين تلك البورصة وأسواق المال التقليدية كـ”داو جونز”، ما يعتبر من المؤشرات على اندماج الاقتصادين الرقمي والتقليدي، في مُرَكّب اقتصاد حديث متداخل. ولعله مثير للإعجاب أن ذلك الوصف الذي قدّمه ماركس في عصر الثورة الصناعية الأولى وطبّقه على إنتاج السلع والأدوات الملموسة بأنواعها، بدا محتفظاً بكثير من حيويته ونبضه في توصيف الاقتصاد الرقمي الذي ينتج أنواعاً من السلع الملموسة كأجهزة الكومبيوتر والخليوي والروبوت وغيرها [إضافة إلى الخدمات]، مضافاً إليها تلك السلع النوعية المرتبطة بالتقنيات الرقمية، التي توصف بأنها سلع ومنتجات وخدمات رقمية وافتراضية، بالمعنى التقني السائد في المعلوماتية والاتصالات لمصطلح “افتراضي” Virtual.
ولعله واضح أيضاً أن التسارع في تمركز رأس المال قد تعزز بسرعة فائقة، بتأثير جذب مزيد من الأموال والأرباح الى القطاع الخاص الذي تملكه قلة صغيرة. والأرجح أن ثمانينيات القرن العشرين شهدت بداية الصعود المذهل لحجم رأس المال مترافقاً مع تحويل كميات ضخمة منه إلى أسهم وسندات، خصوصاً مع فك التساوق النسبي بين ما يعود إلى قوى الإنتاج [خصوصاً الأجور والتقديمات والضمان]، وبين نمو الانتاج. وفي أميركا، لم ترتفع الأجور الفعلية على مدار العقود الأربعة التي تلت “حرب النفط”، إلا بأقل من عشرة في المئة، فيما ازدادت الإنتاجية بقرابة 75%. وترافق ذلك أيضاً مع تخفيض الضرائب على المداخيل العليا، واختفاء متسارع لعقود العمل التقليدية المتصلة بزمن “العقد الجديد” مع ضماناتها المتنوعة. وصار صرف العمال والموظفين فائق السهولة، ما جعل انتقالهم من العمل إلى البطالة أمراً يجري من دون كلفة على رأس المال. ومع ميل أصحاب رأس المال إلى تحويله أسهماً وسندات تصبح بحد ذاتها مصدراً لمزيد من رأس المال، [خصوصاً منذ ثمانينيات القرن العشرين] تزايدت بسرعة دور البورصات، فصارت أسعار الأسهم والسندات المؤشر الرئيسي للاقتصاد، بل أمست عصبه الأساس. ووصل الأمر إلى الظاهرة التي رصدها ميشيل بيكيتي بأن المردود على رأس المال المالي أصبح يفوق، للمرة الأولى في تاريخ الرأسمالية، معدل نمو الاقتصاد نفسه! وقد لمس بيكيتي أيضاً ظهور نوع من “احتكار القلّة” [أو “الاحتكار الأوليغارشي”] مع إحكام قبضة الحفنة الضئيلة التي تدير الشركات العملاقة المعاصرة [في القلب منها، شركات المعلوماتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي]، على معظم المسار الاقتصادي، بما في ذلك رأس المال المالي العالمي الذي يشمل التأثير على الأسهم والسندات وأسعار الطاقة والموارد الخام والسلع الأولية. وفي بعض ثنايا ذلك الملمح، يبرز أيضاً جمود الحراك الاجتماعي في الاقتصاد الأميركي والغربي في العقود الأربعة الماضية، بمعنى جمود سيولة انتقال الثروات بين شرائح اجتماعية مختلفة. واستطراداً، يتحدث بعض المتخصصين عن عودة ظاهرة هيمنة قلة من العائلات على النوابض الأساسية للاقتصاد [“احتكار الأوليغارشيا العائلية”]، أو نوع من تمركز “عائلي” لرأس المال المالي. وإذ يحدث ذلك في القرن 21، فإنه يضع على محك التحدي مقولات وأفكار أساسية في قلب التنوير ومشروع الحداثة الكبير!
إذاً، ضمن تلك الرؤى، ربما يغدو مستطاعاً إلقاء بعض الضوء على مسار يتمثّل في أن الاقتصاد العالمي [في الغرب على وجه الخصوص] قد عرف قفزة نوعية ضخمة عقب الحرب العالمية الثانية، استمرت طيلة ثلاثة عقود سُمّيت “الثلاثين سنة المجيدة”. في تلك الحقبة، استطاع الاقتصاد الرأسمالي تحقيق النمو في الانتاجية مع التوسع في تشغيل القوى العاملة وتجنب البطالة والتضخم، إضافة الى الاستمرار في الابتكار، والأهم زيادة حصة قوى العمل في الاقتصاد. وترافق ذلك مع تطور صاعد في أنماط العيش والمساواة النسبية في فرص العمل وزيادة الرفاهية العامة ونمو متسارع للطبقة الوسطى، مع التوسع أيضاً في تقديمات دولة الضمان الاجتماعي في التعليم والطبابة والتقاعد وغير ذلك. وبوصف آخر، حققت الليبرالية الاقتصادية في “الثلاثين المجيدة” الحلم الرأسمالي بأن التنافس الرأسمالي هو مفتاح الرفاهية للجميع. وارتسمت معالم الاقتصاد الكينزي [نسبة إلى أفكار الاقتصادي الأميركي ماينارد كينز] في معظم اقتصادات الغرب. ويشدد مفهوم الاقتصاد الكينزي على أولوية القطاع العام وإجراءات الضمان الاجتماعي الواسع، وتحقيق التوسع في الربح والابتكار والانتاج من جهة، وحدوث توازن يأتي من التوظيف شبه الكامل للأيدي العاملة وزيادة إنفاق الدولة وملكياتها. وآنذاك، استطاعت الرأسمالية مراكمة ثروات ونجاحات خارج الغرب، خصوصاً في اليابان وسنغافورة.
مع سبعينيات القرن العشرين، انتهت “الثلاثين المجيدة” التي بدت كأنها تدحض رؤية ماركس عن الرأسمالية بصورة نهائية، لأسباب يصعب حصرها. ويبرز من بينها نهاية عصر الطاقة الشديدة الرخص، مع “حرب النفط” (1973)، وكذلك التسارع الديموغرافي في دول العالم الثالث وفشل نماذج التنمية فيها معبراً عنه خصوصاً في ما سُمّي أزمة ديون دول العالم الثالث التي لم يستطع الاقتصاد الرأسمالي إيجاد حل لها، وقد نشأت أساساً من معطيات تشمل هيمنة المركز الغربي وتناميه على حساب اقتصادات الأطراف العالمثالية فيه. وآنذاك، لم يستطع ما سُمّي بـ”نادي باريس” إيجاد حلول لأزمة الديون العالمثالثية، إلا عبر تخريجات باتت مألوفة ومتغلغلة في الاقتصاد العالمي كإعادة هيكلة الدين، وترتيبات دفع فائدة الدين، بدل سداد الدين نفسه وغيرها. ويندرج في قائمة أسباب نهاية “الثلاثين المجيدة”، ذلك التغيّر المالي الذي حمله تخلي الدولار عن التغطية الذهبية ثم تحوّله قيمة مرجعية بديلة للذهب ومهيمنة على عملات العالم، وما إلى ذلك. وتطول لائحة العوامل التي تسببت في نهاية “الثلاثين المجيدة”، وتحتاج إلى تحليل متخصص.
وأيّاً كانت الأمور، سرعان ما برز مصطلح “الركود التضخمي” في وصف الاقتصادات الليبرالية الغربية، خصوصاً في أميركا إبان ختام سبعينيات القرن العشرين. وفي المسار الرأسمالي التقليدي، قد يكون مستطاعاً امتصاص التضخم عبر آليات تشمل التوسع في الاستثمار والتوظيف، لكن ركود سبعينيات القرن العشرين ترافق مع تسارع في البطالة، وتدنٍ واضح في القدرة الشرائية للعملات وبالتالي، تقلص الاستهلاك العام.
لم يكن الحل لدى النظام الليبرالي سوى الـ”نيوليبرالية” التي بدأت في وقت متقارب في الغرب مع التوجهات المحافظة المعروفة التي ترتبط خصوصاً بالرئيس الأميركي رونالد ريغان ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر. في أميركا، بدأ تضخم مذهل في الدين العام، مدفوعاً بـ”معادلة ريدمان” التي طرحت أن الولايات المتحدة تستطيع الاستفادة من فرادة كونها المالك الوحيد للدولار، الذي لم يعد ملزماً بتغطيته ذهباً، ما يطلق يدها في طباعته، بمعنى زيادة رأس المال المالي بسرعة قصوى. واستطراداً، لا يكون تضخم الدين عائقاً للاقتصاد، بل يحفزه، شريطة أن يذهب خصوصاً إلى مؤسسات إنتاج السلع والخدمات في القطاع الخاص. وبقول آخر، اختار الاقتصاد العالمي، بدفع من قاطرته الأميركية الأساسية، أن يميل لمصلحة الانتاج ومالكي رأس المال، على حساب قوى العمل. واستكمالاً لتلك الآلية، توجب أن تتخلى الدولة عن القطاع العام وتقلصه، وتزيد اعتمادها على الآليات الرأسمالية الأساسية المتمثلة في القطاع الخاص، وتالياً تقليص التأثير عليه عبر القطاع العام. ويضاف إلى ذلك، وفق وصفة باتت ذائعة الصيت، تقليص بنى الدولة وتوظيفاتها، الذي فاقمه (التقليص) خفض الضرائب [وهي المداخيل الأساسية للدولة]، وإطلاق عمليات الخصخصة بما في ذلك المؤسسات البديلة لبنى الدولة أو المشتراة منها، وتخفيض مركزية الاقتصاد والدولة وغيرها. ولعل الأبرز في ذلك كله هو السير نحو نهاية “العقد الجديد” الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، عبر التقشف في تقديمات الدولة وضماناتها، من الخدمات الصحية إلى صناديق التقاعد. ولم يتأخر ظهور الأثر الأعمق في تلك التبدلات الجامحة التي اجتاحت حقبة الثمانينيات من القرن العشرين، وقد تمثّل ذلك الأثر أساساً في تآكل متسارع للطبقة الوسطى في أميركا والغرب.
ثمة مفارقة يصعب تجاهلها، لكن تفسيرها يبدو أشبه بمهمة مستحيلة! وبخطوط عريضة، بدا أن صعود نموذج النيوليرالية لريغان وتاتشر قد نجح في هزيمة نموذج دولة الضمان والرعاية [ مع درجات متفاوتة من الاقتصاد الموجه] في صيغ متنوعة من الكينزية [وهي نوع من الرأسمالية أيضاً] في الغرب، وكذلك هزم الاقتصاد الموجه في النموذج الاشتراكي “الخالص” [بصيغه السوفياتية والصينية وما يشبهها] في الشرق! استدراكاً، ثمة اختزالية كبرى في تلك الإشارة، لكنها لا تفيد سوى بالإلماح إلى مدى التعقيدات التي رافقت “الحرب الباردة”. ومع سقوط نماذج أساسية في دولة الضمان والرعاية، وكلها توصف بأنها “يسارية” لكن ذلك الوصف يأتي على جهات مختلفة وبصيغ ومعانٍ متنوعة؛ لم يبق من نموذج للاقتصاد الكينزي ودولة الضمان والرعاية سوى الدول الاسكندنافية التي يوصف اقتصادها أحياناً بأنه ليبرالية اجتماعية أو ديمقراطية اجتماعية. [مفارقة أيضاً أن كثير منها تديره أحزاب الأممية الثانية، التي ناصبتها اللينينية ثم الستالينية والماوية، عداءً قاسياً]. وتستمر تلك المفارقة حاضراً في كون نموذج دولة الضمان والرعاية في البلدان الإسكندنافية يشغل حيزاً كبيراً في ما يشار إليه أميركياً باسم اليسار. ربما يكفي الإشارة إلى أن السيناتور بيرني ساندرز، وهو زعيم حزب يدعو صراحة إلى ديمقراطية اجتماعية على طريقة البلدان الاسكندنافية، يعتبر من الرموز البارزة لـ”اليسار” في أميركا.
وبالعودة إلى الهزيمة التاريخية لنموذج الاشتراكية في الكتلة الاشتراكية، يلاحظ أن صراعات “الحرب الباردة” جَرَتْ ضمن سلام ضمنه توازن الرعب النووي بين نهاية الحرب العالمية الثانية وتفكك سقوط الاتحاد السوفياتي. واستطراداً، يلاحظ أن تهاوي الكتلة الاشتراكية بين أواخر الثمانينيات ومطالع التسعينيات من القرن العشرين، مهّد لظهور العولمة الآحادية الأميركية.
عند ذلك المنعطف، ربما استلزم الأمر الإشارة إلى أن مصطلح العولمة غالباً ما يجري تداوله منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، بمعنى العولمة الآحادية الأميركية، مع تذكر آراء ترى أن العالم شهد أنواعاً كثيرة من العولمة، بما في ذلك تلك التي ترافقت مع الإمبراطوريات التاريخية أو الاستعمار الحديث.
وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي، حُفِظ السلم العالمي بفضل الآحادية الأميركية التي تعالت نبرة آحاديتها وانتصاريتها. إذ أعلن جورج بوش (الأب) ولادة “نظام عالمي” جديد، بعد نجاحه في حرب تحرير الكويت. وآنذاك، سرى وصف ذلك بأنه تكريس الـ”باكس أميركانا” أي السلام الأميركي، في تشبيه له مع الـ”باكس رومانا” للإمبراطورية الرومانية. وآنذاك، انفلتت رؤية أميركية مفاداها أن العالم يتطوّر عبر مجرد تبني النموذج الأميركي، والعمل على التماهي والتشابه معه. إنها حقبة تنظيرات فرانسيس فوكوياما الشهيرة عن “نهاية التاريخ” [بمعنى أن انتصار الرأسمالية على الاشتراكية ينهي كل أنواع الصراع بين الأنماط الاقتصادية والسياسية والثقافية للشعوب كلها، لمصلحة نموذج واحد تمثله أميركا أساساً].
في المقابل، لقد شكّل زمن العولمة الآحادية الأميركية حقبةً لكل أشكال معارضتها، ويمتد ذلك من حركات مناهضة العولمة في الغرب والعالم الثالث، ويشمل تحذيرات صامويل هنتغتون بشأن تجاهل إفقار الداخل الأميركي مقابل ثراء نخب معولمة في بلدان العالم الثالث [وهو سياق وضع فيه نظرته القاسية حيال العالم الإسلامي وثقافاته]، ولا ينتهي ذلك عند تصاعد الإسلاموية وغيرها من أشكال الأصوليات المتمسكة بالهوية واعتبارها موضع تهديد من قِبَل نمط آحادي في العولمة وغيرها. ولعل لحظة ضربات الإرهاب 11/9، عبّرت عن كثافة لحظة العولمة بما في ذلك الكثافة الشديدة في مقاومتها عبر هجمات سبتمبر.
في وصف موازٍ، لقد أدى الاختلال الساحق في موازين القوى العالمي إلى سيطرة آحادية أميركية، أتاحت للولايات المتحدة، خصوصاً في ولايتي بيل كلينتون، نشر العولمة المعاصرة. بدت العولمة كأنها الحل المنشود لأزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، لكنها نشوة لم تدم طويلاً.
إذ نجحت العولمة في الدفع بالاقتصاد الصيني إلى مرتبة عالمية متقدمة، وفي إبراز ظاهرة “النمور الآسيوية”، وفي رفع الهند من اقتصاد راكد متخبط إلى سادس اقتصاد عالمياً، وجعلت من البرازيل المتخبطة دوماً في الحداثة الرأسمالية، ثامن اقتصاد عالمي. وأطاحت جنوب أفريقيا بنظام الأبارتهيد العنصري، وارتقت باقتصادها إلى مراتب عالمية متقدمة. وخرج عشرات الملايين من البشر في العالم من الفقر والقائمة طويلة.
وفي المقابل، جرّت العولمة تناقضات من نوع آخر. ارتفعت النمور الآسيوية لكنها اصطدمت بتضخم رأس المال في المركز الغربي إلى أمدية معولمة أيضاً، فاستطاعت مجموعة صغيرة من مضاربي البورصة في “وول ستريت” أن تطيح بالعملات الوطنية للنمور الآسيوية بين ليلة وضحاها. ولعل ذلك سجّل قفزة نوعية في مدى تحكم رأس المال المالي المعولم [ودوماً عبر عملة الدولار] في العملات العالمية، أو بالأحرى بالمصائر الاقتصادية للدول وشعوبها.
من ناحية اخرى، اعتمدت العولمة في اقتصادات المركز الغربي، خصوصاً أميركا، على تحفيز الشركات العملاقة العابرة للقارات على الاستثمار في اقتصادات “البلدان الأطراف”، خصوصاً تلك التي تجمع بين وجود وفرة غزيرة في اليد العاملة الماهرة المدربة والمتطورة تقنياً وعلمياً، مع انخفاض كلفة توظيفها وتشغيلها، خصوصاً مع نشر “الوصفة” المعروفة لـ”صندوق النقد الدولي” عن تقليص ضمانات العاملين وخفض التأمينات الاجتماعية والتقديمات الصحية والتقاعدية وغيرها. وبدا ذلك الانتقال واضحاً في الصناعات التي تُنتج السلع بأنواعها، فيما بقيت الخدمات ورؤوس الأموال في المركز الغربي. مع الوقت، انتقل معظم الاستثمار من المركز إلى الأطراف. والأرجح أن الصين [وبدرجة أقل الهند] تقدم نموذجاً عن ذلك. في المركز، حدث إفقار ناجم عن انتقال الصناعات إلى بلدان الأطراف. في أميركا، ظهر ما يسمّى “حزام الصدأ” وهي الولايات التي كانت تكتظ بالمصانع، لكن شركاتها هاجرت مع العولمة إلى الصين وغيرها، فباتت تعاني البطالة والإفقار النسبي.
إذاً، مرّة اخرى فضلت الرأسمالية العالمية مصالح رأس المال على القوى العالمة، أثناء عملية تجديد الانتاجية في سياق العولمة. وإذ فشلت العولمة في إنقاذ القوى العاملة في المركز الغربي الذي واصل رأس المال فيه تضخمه إلى مستويات فلكية [مع زيادة أيضاً في اللامساواة]، تولّد سخط أميركي [وغربي] ضد العولمة شكّل أحد روافد صعود الشعبوية التي أوصلت الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، مطلقاً خطاباً معادياً للعولمة من جهة، وداعياً إلى خفض كبير للضرائب على الثروات الكبرى [بدعوى تحفيزها على الاستثمار في أميركا]، وإعادة الصناعات إلى أميركا ودول الغرب.
واستناداً إلى ذلك، من المستطاع القول إن مشهد العولمة دخل إلى تعقيد مذهل مع كل تلك التناقضات التي لم تسرد الكلمات السابقة سوى لمحات منها. ويعبّر عن ذلك التعقيد أن “منتدى دافوس” استضاف الرئيس الصيني تسي جين بينغ في 2016 باعتباره من رموز العولمة، على الرغم من ابتعاد نظامه السياسي والاقتصادي عن الليبرالية والديمقراطية التي يفترض أن العولمة تروج لها، في وقت كان قلب الاقتصاد الليبرالي بصدد هجر العولمة عبر انتخاب الرئيس ترمب المعادي لها. وفي 2020، استقبل المنتدى نفسه الرئيس بينغ نفسه وكرمه كرمز للعولمة، في وقت بدا المركز الأميركي ساعياً إلى التخلص من الرئيس المعادي للعولمة، لكنه على وشك استقبال رئيس يصر على اعتبار الصين العدو الوجودي للولايات المتحدة وليبراليتها وديمقراطيتها!
في عودة مكثقة إلى اللحظة الحاضرة التي ربما يروق للبعض وصفها بأنها نهاية العولمة التي رافقت الآحادية الأميركية، [وبداية لنظام عالمي جديد يكون هجيناً ومتعدداً] فالأرجح أن متغيّرات الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الاقتصادات الأضخم، أثناء جائحة كورونا، دفعت نحو استعادة ملامح عدّة من الاقتصاد الكينزي. وبرزت لمسة من ذلك التوجه مثلاً في حِزم تريليونية لدعم الاقتصاد، وقد ذهب شطر كبير منها إلى الجمهور مباشرة، ولم يقتصر الأمر على دعم الشركات كما جرى في التعافي من أزمة 2008 المالية. وثمة مثل آخر في عودة مباشرة للدولة إلى اقتصاد الشركات عبر شراء أسهم الشركات الكبرى، بل أحياناً شراء سندات الدولة نفسها، وهو خروج على كل قواعد المال في الرأسمالية الليبرالية والنيوليبرالية. والأرجح أن كورونا فرضت بقوة الأمر الواقع نوعاً من الاستعانة بالدولة وملكياتها في الاقتصاد، بعد عملية إقصاء متدحرجة منذ ثمانينيات القرن العشرين مع ريغان وتاتشر، والخصخصة واللامركزية وتقليص القطاع العام وغيرها. في ظل جائحة كورونا، بات حتى صندوق النقد الدولي يتحدث عن البعد الاجتماعي في اقتصادات الدول.
خاتمة: نحو ابتكار “يومي” لنظام عالمي هجين
في خلاصة مكثفة، الأرجح أن ثمة ولادة متدرجة ومتعرجة [كالعادة؟] تجري تحت الأعين وكل يوم، يتبلور فيها نظام دولي هجين ومتعدد ربما تصعد فيه وئيداً لمسة يسارية شبابية، إضافة إلى تصاعد دور الشعوب حتى في ملامح سلبية كالشعبوية الغربية المتسربلة بعودة العنصرية والعرقية. وفي ظل النظام الهجين، تنمو مرونة استراتيجية قد تساعد في صعود دول إقليمية وربما تفيد في ضبط الصراعات، خصوصاً المتعلقة باللاعبين غير الدُولاتيين [كالإسلاموية المسلحة] لكن استمرار الاستقرار والتوازن يشكّل محكها الفعلي. الأرجح أن ثمة مثل ومحك بارز على ذلك يتمثّل في أفغانستان والانسحاب الغربي منها، الذي يتوقع اكتماله في 11/9 كي يترافق مع بداية الحرب على الإرهاب. هل يسجّل نهايتها أيضاً؟
ومن الأمثلة على تلك الولادة المتعرجة والمتدرجة، تكريس أميركا صيغة الدبلوماسية في التعامل مع الصين مع وصفها أيضاً بأنها تشكّل تحديّاً وجودياً للولايات المتحدة. ومن الأمثلة أيضاً ذلك الدور المتزايد التأثير [بل الحاسم] لروسيا في ذلك النظام ومنظومات “توازن القوى” المتصلة به في أرجاء العالم. ومن الأمثلة على تلك الولادة نفسها، عودة أميركا إلى الشراكة مع أوروبا بعد محاولة ترمب تفكيك الاتحاد الأوروبي، خصوصاً عبر تنفيذ حليفه البريطاني مشروع الخروج من الكتلة الأوروبية [بريكست]، مع التذكير بأن علاقة طرفي الأطلسي مع روسيا تؤدي دوراً مصيرياً في تبلور النظام الدولي الهجين والمتعدد. في ذلك المعنى، يشكل تعاطي أقطاب النظام الدولي مع إيران وملفاتها، نموذجاً لآليات النظام الهجين ومحكاً له، خصوصاً مع تكرس إيران كقوة إقليمية فاعلة، وما يعني ذلك من تفاعلاتها مع منظومة توازن القوى التي تتصل بها.
وكذلك تشمل أمثلة تلك الولادة التاريخية تكريس التحدي البيئي بوصفه غير قابل للتأجيل، مع ملاحظة علاقته الخاصة بالطاقة التي هي معطى استراتيجي أساسي.
ومن الأمثلة نفسها أيضاً يأتي تخبط النظام الدولي المتعدد الأطراف ومؤسساته حيال ظاهرة العملة الرقمية “بيتكوين” بما لا يقل عن تخلخله في مواجهة جائحة كورونا وظهور مصطلح “حرب الكمامات” في بدايتها و”حرب اللقاح” قرب نهايتها، وتمدد خطوط القومية الشعبوية بين البداية الوبائية والنهاية المأمولة!
الأرجح أن العالم يعيش تغييراً عميقاً، بل إن من يتابع المجريات العامة، لا يفوته على الأغلب تلك الفورة في النقاشات حول تجديد صيغة النظام العالمي، وهي متمددة عبر ضفتي الأطلسي بما لا يقل عن الإشارة إليها في بكين وموسكو. واستطراداً، لا يصعب التفكير في أن الانتقال إلى نظام عالمي هجين ومختلف عن كل الصيغ السابقة، بل ولادته من رحم آليات ومؤسسات وشبكات القوى في الصيغ السابقة عليه، يشكّل تحدياً نوعياً [بقول أكثر حداثة، تحدياً يتطلب قفزة كمومية] في التفكير، بهدف ابتكار شبكة توازن قوى دولية واسعة ممتدة عبر العالم. ولعل ذلك يكون في بلورة نظام دولي هجين وبأقطاب متعددة ليس بالضرورة أن تكون متساوية في الوزن، ولا تمتلك مضموناً واحداً، بل يتسع بمرونة لليبرالية والنظام الاقتصادي الموجه ونظام الأوليغارشيا السلطوية أو المالية أو الحزبية، وصولاً إلى التمحور حول حاكم واحد، ضمن شبكة معولمة واسعة من الاعتماد المتبادل بين الدول والشعوب. وكالعادة، الأرجح أن المحك الأساسي للنظام الهجين والمتعدد، يتمثّل في قدرته على إدارة الأزمات بما يضمن الاستقرار والتوازن والسلام. هل ينجح؟


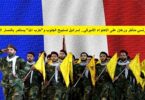





Leave a Comment