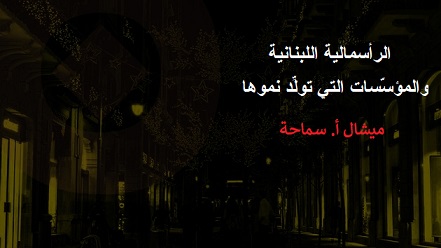أشرنا في المقال السابق إلى أهمية المقاربة المؤسساتية (Institutional approach) مقارنة مع التحليل الاقتصادي القائم على دراسة السوق فقط في الفكر الاقتصادي الطاغي (Mainstream Economy, The Market and the Methodological Individualism)، خصوصاً في بلد مثل لبنان حيث الرأسمالية فيه كما الدولة هما في طور التشكّل، والأسواق فيه غير مكتملة.
لا يتطرّق هذا المقال إيضاً إلى النقاش الفكري بين مختلف المدارس الاقتصادية (الأرثوذكسية منها وغير الأرثوذكسية)، على أهميته. الهدف من هذه المقالات هو تسخير مختلف الأدوات التحليلية والمنهجيات العلمية في فهم النموذج الرأسمالي اللبناني وديناميات نموّه وتركيبة المؤسسات التي تقف وراءه، أو بالأحرى، التي كانت تقف وراءه تاريخياً بعد انهياره. هذه المقاربة المنفتحة (Eclectic) لا يجب أن توضع في خانة المقاربات التوفيقية بالمعنى السلبي للكلمة، بل هي محاولة نظرية تأخذ بالاعتبار خصائص البناء الرأسمالي غير المكتمل والعناصر الاجتماعية والاقتصادية السابقة للرأسمالية التي تحملها جينات الاقتصاد اللبناني.
للتذكير فقط، هذه المقاربة المؤسساتية، تعتمد كثيراً على وحدة العلوم الاجتماعية وخصوصاً التاريخ، وعلى المنهج المقارن، لدراسة النماذج الرأسمالية (The Variety of Capitalism).
تطوّر المقاربات الاقتصادية في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية
نظرياً، تعتبر السوق بالمعنى الفالراسي Walrasian القائم على التنافسية الحرة والمكتملة أن المؤسسات هي بشكل ما عائق لعمل نظام الأسعار Price System/Mechanism، الذي من خلاله يمكن الوصول إلى الحالات والتوازنات الأمثل اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من دون العودة إلى تدخّل الدولة كمؤسسة منظمة ومخططة مركزياً. لا ترى هذه المقاربة ضرورة لأي مؤسسة أخرى إلا إذا كانت تأتي في سياق الحفاظ على الملكية الخاصة وحسن تنفيذ العقود Private Contract ، أي على حسن عمل الأسواق. مع الوقت، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت فكرة تدخّل الدولة من خلال مؤسساتها أكثر قبولاً في الغرب لتصحيح اعوجاجات السوق (الاحتكارات مثالاً) أو توفير السلع العامة ومخرجات الأسواق التي لا تخضع لنظام السعر وجاء هذا التطوّر في النظرة إلى الأسواق ودور الدولة بانسجام كامل مع الميل الكبير للسياسات الكينزيانية وإعادة بناء الدول والاقتصاديات الأوروبية المدمّرة.
هذه الفترة الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ومنتصف السبعينيات تقريباً، شهدت على توليفة (أو تسوية) بين أهمية السوق كمؤسسة مركزية في الاقتصاد وباقي المؤسسات التي تشكِّل وحدة منسجمة وقادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الاجتماعي. وكانت هذه الرؤية سائدة في الغرب كما في نظريات التنمية الاقتصادية في العالم غير الصناعي أو في طريق النمو. هذه هي حقبة الثلاثين الذهبية ودولة الرعاية بكل أبعادها، خصوصاً في الغرب .
تجدر الإشارة إلى أن نموذج النمو الاقتصادي كان قائماً على ديناميات داخلية وطنية بشكل أساسي، وبالتالي فإن الاقتصاد الكلي كان يعبر عن توازنات سياسية واجتماعية واقتصادية وطنية، تنعكس من خلال التركيبات المؤسساتية الخاصة والعامة، والصراعات الاجتماعية أو التفاوض (نقابي وحزبي). وكانت مؤسسات دولة الرعاية هذه تولِّد النمو وحسن عمل الأسواق وتوزيع الثروة تحت مظلة الدولة المركزية.
بدأ كل ذلك يتغيّر في السبعينيات من القرن الماضي تحت عوامل ثلاث: أولاً، من خلال أزمة الطاقة التي تحوّلت إلى أزمة اقتصادية تضخمية في الغرب، وثانياً من خلال تطوّر الصناعة والتجارة العالمية، الذي سيوصلنا إلى بدايات العولمة ولبرلة التجارة (الاقتصاديات المفتوحة)، وثالثاً ترافق كلّ ذلك مع صعود النظريات الاقتصادية الجديدة (النقدية)، التي بدأت تفرض نفسها بين النخب وعلى مستوى الخيارات السياسية. بالطبع، هناك ترابط جدلي بين العوامل الثلاث، ولكن على المستوى النظري، كان للنظريات النقدية (Monetarism) الأثر الأكبر في تعميق فكرة “لا جدوى من السياسات الكلية ” وبالتالي لا جدوى من التخطيط المركزي.
هذا التحوّل غير البسيط الذي أعطى استقلالية كاملة للمصارف المركزية (السياسة النقدية) عن الدولة وحكوماتها وساهم في تراجع تدخّل الدولة في الاقتصاد (السياسات الاقتصادية والمالية) وتوقف التخطيط المركزي، أدّى إلى تحولات نحو سياسات العرض مع مقاربات ميكروية قائمة حصراً على إعطاء الإشارات للاعبين الاقتصاديين، أفراداً وشركات، لزيادة الإنتاج وخلق وظائف عمل وتعظيم الثروة والرفاه. وأعاد هذا التحوّل للسوق مركزيتها في الفكر الاقتصادي وجعل من “الشركة” نقطة محورية في الحلول والسياسات، التي كانت موجودة قبل الحرب العالمية والتي عادت بقوة مع التحولات المذكورة من بعدها.
عودة “المقاربات المؤسساتية “، على هوامش العولمة وما بعد الحقبة الصناعية في الغرب
كانت العولمة تتطور بسرعة بعد الحرب الباردة، وكان تحرير الأسواق والتجارة العالمية والخصخصة كلمات لها وقعها السحري. رافق ذلك التطور التكنولوجي قفزات للناتج العالمي خصوصاً مع صعود التصنيع في آسيا والصين تحديداً. وكان ذلك بذاته تحدياً للنظريات والمقاربات المؤسساتية Institutionalism لا سيما مع المحاولات التي سادت لتوحيد وتنميط المقاربات الاقتصادية التي تتمحور حول السوق (One Way Doing).
وعلى الرغم من قوة دفع العولمة وديناميتها الاقتصادية الليبرالية، ظلت الكثير من البلدان غير قادرة على اللحاق بركب النمو. فجاءت أفكار اللحاق وتقصير الفجوات بين البلدان لتشير من جديد إلى أهمية القدرات الاجتماعية والعناصر الذاتية الكامنة في كل مجتمع (أي المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) في تطوّر الإنتاج واستحواذ التكنولوجيا وبناء الرأسمال البشري والاجتماعي خصوصاً في عالم الجنوب.
فالمؤسسات ليست خارجة عن الاقتصاد والسوق ولاعبيه، بل هي جزء أساسي منه، وتؤثّر على التوازنات القائمة والاستراتيجيات المتبعة من اللاعبين، وتصيغ شكل التحفيزات وتحدّد قواعد اللعبة وحدودها. وهذا يعني أنها تحدّد بشكل ما الفرص والمخاطر وتعطي إشارات للاستثمار للتوجّه باتجاهات معينة وللاعبين باتجاهات التعاون والمنافسة ضمن أطر ليست بالضرورة محكومة بالسوق ومنطقها فحسب.
فلا مجال للتطرق إلى المؤسسات والشركات والمنظمات بشكل منفصل عن الاقتصاد وفضائه الكلي وأشكاله المؤسساتية التي تحدّد مسار النمو الاقتصادي للبلدان. لا يمكن حصر مسارات النمو الاقتصادي الطويلة بعملية حسابية، على الرغم من أهميتها وتعقيداتها، ولكن يجب مقاربتها من خلال تحليل للمؤسسات بمنهج المقارنة كما يقول آوكيAoki . هذه المقاربة التي تربط مستوى المنظمات والشركات (ميكرو) مع مستوى المؤسسات الوطنية (الماكرو)، هي التي تمد التحليل الاقتصادي بالكثير من المقاربات الغنية والقادرة على فهم خصائص كل نموذج رأسمالي في كل بلد، ما يساعد على تشكيل فهم أفضل لأشكال النمو الذاتي الدفع وطبيعة المؤسسات التي تمدّه بقوته وترابطه.
أين لبنان من كل هذا التطور في المقاربات الرأسمالية؟
أتى تأسيس لبنان الكبير بعد أن رسم “دوره” الاقتصادي تقريباً في الحقبة الأخيرة من الخلافة العثمانية تحت تأثير الصعود الاقتصادي الأوروبي وتمدد استراتيجيات توسّعه الاقتصادي في المشرق العربي. فبين الانفتاح العلمي والثقافي على العالم من خلال الإرساليات، وزراعة/صناعة الحرير في جبل لبنان، بالإضافة إلى تطوير مدينة بيروت وخطّ بيروت – دمشق من خلال مرفأ المدينة على البحر الأبيض المتوسط، كانت الرأسمالية اللبنانية قد بدأت تأخذ هويتها وتثبت دورها المتمحور حول الخدمات والوساطة التجارية والمالية. كانت الصناعة قليلة (وريثة صناعات الحرير) والعالم الزراعي مخلّع في جبل لبنان بعد مجاعة الحرب العالمية الأولى، لكن مع المحافظات الجديدة، كان الجزء الأكبر من سكان لبنان ما زالوا يعيشون من الزراعة وفي المناطق الريفية (مع ضعف تاريخي بزراعة الحبوب ودخول زراعة التبغ لاحقاً).
قد تكون الحقبة الزمنية الممتدة من دخول الحرير إلى جبل لبنان وصولاً إلى العام 1952 (نهاية ولاية الرئيس بشارة الخوري وبداية ولاية الرئيس شمعون) ومروراً بفترة الانتداب الفرنسي، هي حقبة رأسمالية واحدة في تاريخ الرأسمالية اللبنانية الناشئة تدريجياً. واعتقد أن هذه الفترة شكّلت محددات للمؤسسات الرأسمالية لدولة لبنان على الرغم مما أصابها من تحولات لاحقة.
دائماً حسب تصنيفات المدرسة الفرنسية التي تطرقنا إليها في المقال السابق، هناك خمس مؤسسات أساسية يمكن من خلالها تصنيف النموذج الرأسمالي لأي بلد (بالإضافة إلى مؤسسة سادسة في الحالة اللبنانية):
الدولة ومستوى تدخلها: خلال كل هذه الفترة بقيت فكرة الدولة ضعيفة وفي طور البناء السياسي مقارنة بوزن الجماعات الطائفية والسياسية والمناطقية. وكان دورها الاقتصادي يكمن في إدارة الحفاظ على الدور نفسه بشكل أساس، خصوصاً بعد 1920. وكان لبنان كل ما اقترب (جبل لبنان ولبنان الكبير) من الاستقلال كلما أصبح أكثر ليبرالية والدولة أقل تدخلاً في التخطيط بما يتلاءم مع دور الوساطة. ففي حقبة القائمقاميتين والعثمانيين، ومن ثم الانتداب الفرنسي، كان هناك تدخل أكبر مثلاً في المسائل الزراعية واستعمالات الأراضي والتنظيم المدني. هذه الرؤية لدور الدولة في الاقتصاد سيعبّر عنها لاحقاً بمقولة laisser-faire, laisser-passer وبعض أفكار المفكّر ميشال شيحا.
الأسواق ومستوى تنافسيتها: طبيعة الأنشطة الاقتصادية (الحرير مثلاً) والتجارية (الوكالات الحصرية) والوساطة المالية وملكية الأراضي والماضي الإقطاعي الذي يجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى حجم السوق المحلي الصغير؛ كلها عناصر دفعت باتجاه تشكل أسواق غير تنافسية وفي كثير من الأحيان احتكارية، وبالتالي شكّل ذلك عائقاً لتطور رأسمالي متطور وأبقى على الاقتصاد غير المهيكل مكوناً أساسياً حتى يومنا هذا. وهذا ما يفسر جزئياً هجرة الكفاءات من لبنان. فمن الصعب جمع مستوى تعليمي متقدم مع بنى متخلفة للسوق من دون أن يؤدّي ذلك إلى صراعات اجتماعية.
مستوى الانفتاح على العالم والتجارة معه: منذ نظام الامتيازات ووصولاً إلى إنشاء لبنان الكبير (إذا ما استثنينا الحربين العالميتين)، كان الدور الاقتصادي للبنان يتطلب أقصى مستويات الانفتاح على العالم، مثله مثل أي جمهورية تجارية عبر التاريخ. وهذا ما يجعل اللعبة السياسية والاقتصادية تتأثر دائماً وإلى حدّ كبير بالخارج وتوازناته، وجعل نموه مرتبطاً بإدارة الدور والحفاظ على انفتاحه وتهيئة الظروف الداخلية للجذب والاستثمار. قد يكون مرفأ بيروت تكثيفاً لهذا الانفتاح، بالإضافة إلى المصارف والحركة التجارية. سرّع هذا التوجه والاختلاف في المسارات الاقتصادية في الانفصال الجمركي مع سوريا في العام 1950، ودفع مع صعود البترول إلى إنشاء قانون السرية المصرفية الذي ثبّت دور لبنان المنفتح على الخارج.
النقد والنظام المالي وتمويل الاقتصاد: استبدلت الليرة العثمانية بالجنيه المصري لفترة وجيزة، قبل أن تدخل سلطة الانتداب العملة الموحدة لسوريا ولبنان المرتبطة بالفرنك الفرنسي في العام 1920. أما في العام 1924 فقد بدأ لبنان بطبع عملته الخاصة قبل أن ينفصل عن العملة المشتركة مع سوريا في العام 1939. ولكن بقيت الليرة اللبنانية مرتبطة بالعملة الفرنسية حتى العام 1949، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية حين ربطت بالجنيه الإسترليني. وحتى عامي 1963-1964، سنة تأسيس المصرف لبنان المركزي (قانون النقد والتسليف)، بقيت وظيفة صكّ العملة شأن سلطة انتداب أو منوطة بمصرف خاص وهو بنك سوريا ولبنان. وهذا ليس أمراً ثانوياً إذا ما ربطنا هذه الوظيفة بسيادة الدولة المطلقة على نقدها وسياستها النقدية والمالية. فالمسار التاريخي لتطور العملة اللبنانية قام على ديناميتين: الأولى، تطوّر البناء السياسي للبنان وتأكيد استقلاله عن سوريا وبداية تباعد المسارات الاقتصادية. وثانياً، الارتباط الضعيف بين لعبة النقد وبناء الدولة وسيادتها بحيث وجِهت عملية تأسيس المصرف المركزي بمعارضة كبيرة من المصارف. هذا ويقوم النظام المصرفي بتمويل الاستهلاك والشركات الكبرى بشكل أساسي وخدمة الثروات الكبرى، مع غياب تام لأي وسائط مالية أخرى (بورصات) لتمويل الاقتصاديات الصغيرة والشركات بناءً على جدوى المشاريع ومشاركة المخاطر. وتميز القطاع المصرفي اللبناني في بدايات القرن الماضي بمستوى عالٍ من المحافظة وارتبط عضوياً بالقطاعات الخدماتية الأساسية حيث المخاطر شبه معدومة.
أسواق العمل والمؤسسات التي يشتمل عليها: في مقابل تطور التعليم في هذه الحقبة، إلا أن أسواق العمل بقيت متخلفة. يمكن التأريخ لبدايات الحركة النقابية مع الانتداب الفرنسي. لكن على الرغم من تطور المدن والنزوح الريفي إليها والتطور النسبي لعلاقات العمل في الرأسمالية اللبنانية الناشئة، لم يبصر قانون العمل النور إلا في العام 1946 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 1963. وكانت أكثرية اليد العاملة تعمل في القطاع الزراعي غير المهيكل وقطاع الحرف والمهن الصغيرة. وهذا يشكل عنصراً سلبياً لتطور الرأسمالية في لبنان ولكنه كان مفيداً للدولة من حيث عدم اضطرارها للعمل على خلق نمو قادر بدوره على خلق وظائف عمل كافية، ومدّ سوق العمل بيد عاملة رخيصة نسبياً (ميزة تنافسية للبنان في هيكلية تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى المستوى المنخفض من الضرائب) طوال الحقبة الاقتصادية وصولاً إلى نهاية الحرب الأهلية. هذه العناصر بالإضافة إلى المجاعة والطبيعة الاحتكارية للأسواق أدت إلى “الدينامية الكبرى للهجرة اللبنانية” التي اعتبرها المؤسسة السادسة في النموذج الاقتصادي اللبناني.
هذه محاولة أولية لقراءة وفهم الرأسمالية اللبنانية الناشئة حتى العام 1952، وفهم الهندسة المؤسساتية لنموذج نموها وتطورها. في المقالات اللاحقة، سنتطرق بعمق أكبر لهذه المؤسسات ومستويات ارتباطها ببعضها البعض، وتطورها التاريخي (القطع والوصل في مسار تطور الرأسمالية اللبنانية) مقارنة مع أمثلة أخرى من العالم.
1 شباط 2023
ميشال أ. سماحة: اقتصادي، وخبير في التنمية والحوكمة. درس الاقتصاد والتنمية والعلوم السياسية، وعمل في العديد من المؤسّسات والمنظّمات الدولية.