كتب بول طبر
منذ نشوء لبنان الكبير عام 1920، تأطر الخطاب السياسي السائد في لبنان، لدى الحكم والمعارضة (أو المعارضات)، حول محاور أساسية هي في المحصلة لا تنتج سوى كل ما يؤدي إلى تعطيل مهمة بناء وطن مواطنة وديموقراطية (بما هي نظام يقوم على سيادة المواطنين، مراقبة ومحاسبة السلطة، حكم القانون، فصل السلطات) وعدالة إجتماعية. وبقي هذا الخطاب متحكماً بالمشهد السياسي العام في لبنان إلى حين انفجار انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019. أسوق هذا الكلام دون إغفال أن “خطاب السلطة” والقوى التي تقف وراءه تمكنت عند محطات أساسية من تاريخ لبنان الحديث من رفع مطالب مهمة في قاموس بناء الأوطان والعمل على إنجازها، إلا أنها سرعان ما بددت هذه الإنجازات بحكم مصالحها وتكوينها الأهلي.
إتسم “خطاب السلطة” منذ البداية بتعيين المشاكل التي يعاني منها لبنان واللبنانيين وحصرها بخيارين أساسين: إما الحفاظ على الهوية اللبنانية للكيان اللبناني (لبنان ذو وجه عربي، لبنان فينيقي، إلخ.) وعلى سيطرة الجناح المسيحي على مفاصل الدولة لضمان تلك الهوية، وإما تحسين شراكة “الإسلام السياسي” في الحكم وتكريس الهوية العربية للبنان وما يستجر ذلك من انخراط للبنان في محاور عربية وفق موازين القوى الداخلية والأقليمية المحيطة. تجلت تلك المحاور في البداية خلال معركة استقلال لبنان عام 1943، ومن خلال “الميثاق الوطني” كما ظهرت خطوطه العريضة في البيان الوزاري لأول حكومة ما بعد جلاء الإنتداب الفرنسي من البلد برئاسة رياض الصلح. ومن ثم جاءت “ثورة 1958” التي أسفرتْ عن تحسين نسبي في موقع شراكة “الإسلام السياسي” (السني) في السلطة من جهة، ولجم اندفاعة “المارونية السياسية” نحو الغرب الرأسمالي على صعيد تموضع لبنان على خريطة المحاور السياسية عربياً ودولياً، من جهة أخرى. ومع هزيمة 67 وسقوط الحكم الشهابي، احتدم التناقض بين قوى المحورين المذكورين أعلاه مشحوناً بتصاعد الحركات المطلبية والطلابية، وصولاً إلى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 وحتى عام 1990. وكان من أهم نتائج اتفاق الطائف (1989) داخلياً الذي أعلن النهاية الرسمية للحرب الأهلية في لبنان، أنه كرّس دستورياً وسياسياً تراجع نفوذ المحور اللبناني-المسيحي “اللاعروبي”، بالمعنى “القومي” لكلمة عروبي، وتقدم على حسابه المحور المقابل لـ “الإسلام السياسي”، وإنما بقيادة شبه حصرية لقوى “الشيعية السياسية”، بعد أن تم نزعها من “السنية السياسية” التي تخلت تدريجياً عن مشروع “القومية العربية” بعد سقوطها على يد الناصرية والبعثية في العراق وسوريا.
ومن أهم تداعيات الأحداث والتطورات الآنفة الذكر أن قوى ما أسميناه بالمحور “اللبناني-المسيحي” قد بددت فرص مهام بناء هوية وطنية لبنانية جامعة ومستقلة، بسبب تمسكها وإصرارها على تلازم تلك الهوية بالهوية “المسيحية-المارونية”، كما ساهمت قوى المحور “الإسلامي-العربي” في ذلك الهدر عن طريق رفضها المطلق لفكرة الهوية الوطنية اللبنانية، أكانت شاملة مبنية على المواطنة أم “مطيّفة”، وذلك من منطلق “إسلامي-عروبي” ملتبس.
وفي خضم هذا الصراع، لم تتم فقط التضحية، إن لم نقل التهميش، بقضايا ومطالب إجتماعية توحيدية، كحقوق العمال والمزارعين في حياة كريمة ، وتأمين سياسات رعائية لجميع المحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم “الأهلية”، وعلى رأسها الإنتماءات الطائفية والزبائنية، بل جرى أيضاً تبديد فرص بناء دولة مواطنة ودولة سيِّدة وديموقرطية تقوم على المراقبة والمحاسبة وتطبيق القانون وفصل السلطات وتداول السلطة. كل ذلك كان يجري باسم الدفاع عن “لبنان” (إقرأ لبنان الممسوك من زعامات المارونية السياسية) و”حقوق المسيحيين”، في مقابل رفع مطالب أو “حقوق المسلمين” والانخراط في الصراع العربي-الإسرائيلي (الذي أصبح مؤخراً صراعاً بين نفوذ “محور الممانعة” و”محور السلام مع إسرائيل”).
ومع الإنجاز التاريخي لتحرير جنوب لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي في 25 أيار عام 2000، ومن بعد ذلك خروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 بعدما دخله عام 1976، تكررت العملية نفسها على يد قوى المحورين المذكورين أعلاه، إذْ تم آنذاك تبديد هذين الإنجازين على مذبح “حقوق الطوائف” وتناتشها للسلطة والنفوذ. واستكمل هذا التبديد إقليمياً تارة باسم “السيادة”، وباسم “تحرير فلسطين” تارة أخرى.
ميزة انتفاضة ١٧ تشرين وأهميتها خصوصاً كما تجلت في الأشهر الأولى من انطلاقتها، تكمن في ان المنتسبين إليها والمشاركين فيها خرجوا على “بردايم” السلطة المتمثل بالمحورين أعلاه ومن خطابه الذي يقوم على ثنائية إقصائية: إما ان تكون سيادي أو تكون قومجي بلبوس ديني، خصوصاً مع تعاظم دور حزب الله وايران في البلد. أما السياديون الذين يحصرون المشكلة الاساسية بموضوع غياب السيادة الوطنية، فانهم يشيحون النظر عن مساوئ النظام السياسي الطائفي – الاهلي، وتعطيله لمهمة بناء دولة مواطنة ودولة ديموقراطية، وعن النظام الاقتصادي والمشاكل العديدة التي يفرزها هذا النظام. ويقوم القومجيون والاسلمجيون بالوظيفة والدور نفسيهما، وانما باسم الاهداف “القومية” والشعارات الوطنجية المتعلقة بمقارعة الامبريالية واسرائيل.
ميزة انتفاضة ١٧ تشرين انها جعلت من بناء دولة غير طائفية وخاضعة للمراقبة والمحاسبة، دولة القانون وفصل السلطات، دولة المواطنة وحقوق المواطن بدل دولة المحاصصة والرعايا، القضية المركزية في حراكها ونضالاتها، وبذلك كشفت زيف شعارات السياديين والقومجيين- الطائفيين اذْ أظهرت ان المعسكرين بالتكافل والتضامن لا يريدان المساس بالنظام والقواعد التي يقوم عليها هذا النظام.


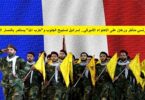





Leave a Comment