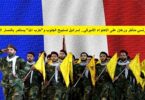لنحاول إلقاء ومضات سريعة على النقلة النوعية في الإسلامويَة المعاصرة في المنطقة التي مثلتها حركة اردوغان تجاه ليبيا. في الرؤية المباشرة، هناك أولاً (وربما أخيراً أيضاً؟) غاز المتوسط، وذلك الحقل الأسطوري الضخامة المسمى “ليفايثان”. لنتذكر أن مركزه في مصر ويربط شواطئ الدول العربية المطلة على المتوسط (وبعضاً من برها)، وقبرص ومالطة واليونان وقطاع غزة. تتمدد إسلاموية عبر تلك الجغرافيا التي رُبِطْ سقوط الرئيس الراحل محمد مرسي برسم حدود لليد التركية فيها. (تذكيراً، رُبِط سقوط الرئيس مبارك بها، خصوصاً صفقة الغاز المستباح مع إسرائيل التي تتفرد بتعمق حصصها في “ليفايثان” والسبق في الاستفادة منه إلى حد استنفاذ حقلين صغيرين فيه، وعقد صفقات كبرى مع الاتحاد الاوروبي حوله، واليد الأميركية العليا في استخراجه و…القائمة طويلة. وماذا عن غزّة؟).
لنعد إلى الإسلاموية، المنطقة في لحظة مكثفة لتقاطع مساحاتها التركية والعربية. لا يصعب تأمل جغرافيا مصالح الغاز في ذلك التقاطع، لكن اختزالها في تلك الزاوية وحدها خطأ ضخم. هل يكفي القول بأن حركة “الاخوان المسلمين” تأسّست في سنة سقوط الخلافة العثمانية رسمياً في 1928؟ ربما أكثر أهمية الإشارة إلى أن حزب “العدالة والتنمية” وصل الى السلطة في تركيا، مع طرح أردوغان على الغرب فكرة استراتيجية عن توافق الإسلام مع الديمقراطية. تصادف أن حدث ذلك قبيل هجمات الإرهاب في 11/9/2001 التي تلاها “الحرب على الإرهاب” كأفق لازال مرتسماً بقوة في الحركة الاستراتيجية الأميركية. هل ثمة من يريد الإشارة الى علاقة “الربيع العربي” مع الطرح الأردوغاني، أو المفاوضات الأميركية مع حركة “طالبان”؟ تجري المفاوضات بعد تعمّق علاقة روسيا مع طالبان (وكذلك باكستان في ظل الرئيس عمران خان) مع ملاحظة قبول أميركي نسبي (ضمن تَبَدْلٍّ في النظام العالمي) بحصة استراتيجية لروسيا في الشرق الأوسط الذي تشمل خريطته المنطقة العربية وباكستان وتركيا وإيران؟ وتدور تلك المفاوضات في قطر صاحبة العلاقة المميزة مع الإسلاموية المعاصرة. ما علاقة ذلك بخريطة الغاز، وكون قطر وروسيا (وإيران: الأضخم في الغاز اقليمياً والمتقاطعة حقولها مع قطر والعراق) بلداناً أساسية عالمياً في طاقة الغاز الصاعدة لتحل تدريجياً محل البترول؟ ماذا عن الحراك اللبناني الذي برزت الإسلاموية بقوة، خصوصاً صعود شقها السني الساعي، على اقل تقدير، للعب دور الوزن المقابل للشق الشيعي من الإسلاموية المعاصرة؟ سؤال ليس سهلاً ترسّم آفاقه.
التوليف التركي- العثماني ورفض “الإنسانية”
لنعد إلى شيء من الرؤى والتاريخ المنبثّان خلف الحركة الأردوغانية. لنبدأ من اللحظة المكثفة التي جسَّدَها سقوط الإمبراطورية الإسلامية العثمانية، بعد حراك استراتيجي أوروبي لتقاسم الجغرافيا السياسية لإرث الخلافة التي سمًاها الغرب لعقود طويلة “الرجل المريض”. ظهرت تركيا على يد مصطفى كمال آتاتورك، مترافقة مع معاهدة “سايكس بيكو” ودولها في الشرق الأوسط. في الحرب الباردة، حوصرت تركيا أتاتورك في الأناضول، وحمل انفتاحها على أوروبا إشكاليات الحداثة وتعقيدات الهوية الأوروبية. مع انهيار الاتحاد السوفياتي، برزت مجموعة دول تبحث عن موقعها في عالم صعب. وفي بعضٍ منها، بدا كأن التاريخ قذف بدور يبحث عن بطل.
وفي رؤى أردوغان، هناك “العالم التركي” المكوّن من بلاده مع تركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان (معظمها مراكز للغاز، خصوصاً حول بحر قزوين الذي يجمعها مع غاز أفغانستان). وتجمعه ديموغرافيا عرقية مع إثنيات في تتارستان (روسيا) وتركمانستان الشرقية (الأيغور في الصين)، وكذلك روابط مع مسلمي أوروبا الوسطى (بلغاريا والبوسنة ومقدونيا وألبانيا). في تبسيط مُخلّ، 3 هويات تتفاعل في العالم التركي: الكمالية العلمانية والقومية التركية والإسلام. وبدأ “التوليف التركي- العثماني” في البروز منذ خمسينيات القرن العشرين، مع خسارة الأتاتوركيين الانتخابات البرلمانية للمرّة الأولى، واضطرار السلطة الى إعادة فتح “مدارس إمام خطيب”، والجرأة ثقافياً على الكمالية وعلمانيتها التي توصف تركيّاً بـ”الحركة الإنسانية”، في إشارة الى فكر الحداثة غرباً (بدءً بالنهضة والتنوير). وحدث تداخل معقد ومتناقض بين فئات مثقفة متخالطة، تقاطعت تدريجياً على وصف “الحركة الإنسانية” بأنها مضرّة للأمة التركية بمفهومها التاريخي، وللإسلام أيضاً الذي اعتُبر أنه يطبع الشخصية التركية ما يوجب ضمّه إلى القيم الوطنية. انخرطت الدولة الكمالية نفسها في هذا التفاعل المتناقض، وصارت جزءاً من التوليف بطريقة تسمح بالتمسّك بالمؤسسات الكمالية وشخصية أتاتورك، مع الاستمرار في اعتبار “الحركة الانسانية” تمزّقاً في تاريخ تركيا. انخرط مثقفون علمانيون ومستنيرون في نقد ما بعد حداثي لعلمانية أتاتورك، مستخدمين أدوات فكر مابعد الحداثة، خصوصاً نقد المركزية الأوروبية (وتالياً، النظر إلى علمانية أتاتورك باعتبارها استلاباً أمام تلك المركزية)، إضافة إلى إعادة النظر في الدين الإسلامي، ما ولّد توليفاً عبر عنه شعار مكثّف “الدين جوهر الثقافة، والثقافة شكل من الدين”. وكذلك نُظر نقدياً إلى مفهوم الفرد في ثقافة المركزية الأوروبية، وقيل ان وجود الفرد في ثقافة تركيا وتراكيبها، لا يتطابق بالضرورة مع مفهوم الفرد في الثقافة الأوروبية. حدث تطوّر كبير في الفكر الديني الذي هجر الرؤى التقليدية للصوفية النقشبندية (تُسمى “جماعة اسكندر باشا”)، ليتبنى مشارب أخرى مستقاة من سيد قطب وأبو الأعلى المودودي والإمام الخميني ومطهري وبهشتي. وكخلاصة، ساد الفكر الديني حالٌ من النقد الصدامي للعلاقة مع الغرب، يلاقي تقاطعاته مع نقد العلمانية وتجربة الغرب في الدول الوطنية والقومية. (هل يصعب التفكير في المرادفات العربية لتلك الأفكار؟).
وبطرق متعرجة، تبلوّر في الخيال العام وذاكرته في تركيا توليف بين قومية تركية (وطورانية) تتفاعل مع ديموغرافيا الشعوب التركية (مكّنت أيضاً من تجاوز الشرخ السني– الشيعي، خصوصاً في أذربيجان الشيعية)، واستعادة الإسلام عبر التجربة العثمانية ما سمح باستعادة أبعاد الجغرافيا- السياسية للعثمانية، مع التمسّك بوطنية تركية تسمح بعدم الانجراف وراء الأهواء المتطرفة للنزعتين القومية والإسلامية معاً، وبالتمسك بمؤسسات الدولة الكمالية وأطرها ودوائرها الاستراتيجية مع نقد “التجربة الإنسانية” لمرحلة أتاتورك.
هل تعطي تلك الومضات إضاءة ما بالنسبة لحركة أردوغان في ليبيا، بعد أكثر من قرن ونصف على خروج آخر جيش عثماني منها؟
[author title=”احمد مغربي” image=”http://”]كاتب لبناني[/author]