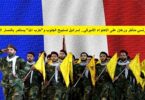على الشاشات، كرّت صور تظاهرات “السترات الصفراء” في شوارع باريس، وبرزت صور الشانزلزية بالحواجز المرتجلة والنيران المشتعلة والقبضات المكوّرة والأيادي التي ترفع الحواجز وترمي الشرطة بالحجارة، وصراخ أجيال متمازجة، فحواه الاحتجاج على النظام الفرنسي المستمر منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتداول المتناوب- ولكن اللامتساوي- بين اليمين واليسار. لم يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الربط بين حركة “السترات الصفراء” واليمين الشعبوي الذي استطاع ماكرون بالتحديد ان يمنع مرشحته مارين لوبن من الوصول إلى تسلّم السلطة! ولم يأنف اليمين المتطرف الشعبوي من تبنّي التظاهرات، لكنه تنصّل من العنف المباشر الذي رافقها، ما أشّر أيضاً على حقيقة ربما بات صعباً تجاهلها في أوروبا والغرب: صعود تيار الشعبويّة يستند إلى ثقافة منتشرة اجتماعيّاً، بل أنها “ثقافة بديلة” بمعانٍ كثيرة. وسواء وصلت إلى السلطة أم لا، فإنها صارت ظاهرة مكرسة في اللحظة الراهنة من المسار الثقافي لأوروبا [لنتذكر صعودها المدوي في السويد وإيطاليا، إضافة إلى المجر ومجموعة من دول أوروبا الشرقية]، بل الغرب عموماً مع تذكّر صعودها في بريطانيا البريكست، وكذلك نجاح الشعبوية الأميركية في إيصال مرشحها غير التقليدي [دونالد ترامب] إلى سدّة السلطة في الولايات المتحدة.
والأرجح أن ظاهرة بمثل ذلك الاتساع يصعب حصرها في المجال السياسي وحده، ولا حتى الاقتصادي والاجتماعي، بل لا يصعب القول بأن الشعبويّة ظاهرة تتعلّق أساساً بالثقافة العامة المعيوشة في الحياة اليوميّة للناس. ومع تذكّر أنه صار مألوفاً في العقود الأخيرة، النقاش بشأن مأزق الحداثة [وهي المشروع الكبير للغرب منذ عصري النهضة والتنوير]، خصوصاً منذ “مانيفستو ما بعد الحداثة” الذي أطلقه المفكر الفرنسي فرانسوا ليوتار في مطلع السبعينات من القرن العشرين. مفارقة أن منعطف ما بعد الحداثة ارتسم في شوارع باريس أيضاً، قبل خمسين سنة، عبر “ثورة الشباب” في العام 1968، بل أن مشاهد من تظاهرات “السترات الصفراء” كرّرت مشهديّات من تلك الثورة التي أعلنت تمرداً كبيراً على نظام الحداثة الغربي كله، في العالمين الاشتراكي والرأسمالي آنذاك.
ماكرون يستغيث بالتقدميّين!
بعيد حراك الشعبويّة في الشانزليزيه، لم يتأخر الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو تلميذ سابق للفيلسوف الفرنسي بول ريكور [رائد الهيرمونطيقا= التأويليّة]، في مناشدة “التقدميين والمستنيرين” النهوض لمقاومة الشعبوية [تذكير بأنه ركّز كثيراً على استعادة حداثة عصر التنوير]، المعبّرة عن نفسها في تيارات قومية مناهضة للعولمة. وما لم يقله ماكرون صراحة، هو العلاقة المعروفة بين الشعبوية والدين، بالأحرى التجدد الديني. في أميركا، أفصحت تلك العودة عن نفسها منذ عهد الرئيس جورج بوش (الإبن)، وتيار “المحافظين الجدد” الذين طالما تباهوا بأنهم من تيار “المولودين مجدّداً”، وهو تعبير عن تيار تجدد التديّن، خصوصاً الإنجيلي- البروتستانتي، فيما يعتبر التجدّد الديني تياراً قويّاً في الشعبوية الأميركية. ولا أقل من الحديث عن تأييد ولايات “حزام التوارة” القوي لترامب الذي يعتبر نائبه مايكل بنس أقرب إلى رجل دين انتقل من الكاثوليكيّة الى التجدّد البروتستانتي- الإنجيلي.
وهناك مفارقة أوضح. قبل تظاهرات الشعبويّة، كان ماكرون نفسه أول رئيس فرنسي يعيد تقبّل لقب من الفاتيكان بوصفه حامياً للإيمان الكاثوليكي. وتذكيراً، علمانية الحداثة في فرنسا تميّزت بشدّة منازعتها مع الدين، فيما تميل علمانية أميركا تاريخياً إلى إبعاد الدولة عن الدين.
إذاً، في قلب مأزق الحداثة الغربي [نقرأ أيضاً مشروع العقلانية الكبير، منذ ديكارت]، يبرز خيط استعادة الدين بوصفه قيماً وثقافة مجتمعيّة واسعة وفاعلة في الحياة اليوميّة، وهو ما ساد الظن طويلاً بأنه المحل الذي نجحت قيم الحداثة والعقلانيّة في الحلول فيه.
لم تصف الكلمات السابقة سوى نثرات من مشهدية فوّارة تحتاج وصفاً طويلاً. والأهم أنها تطرح تحدّيات بوجه الحداثة العربيّة والإسلامويّة المعاصرة، خصوصاً لجهة إطلاق حوار أساسي بينهما، وهو أمر الأرجح أن الطرفين لم يخوضا فيه بشكل مُجدٍ فعليّاً. ومن تلك التحدّيات:
- ما هو موقف الحداثة العربيّة [يميناً ويساراً] من مأزق الحداثة الأوروبيّة والغربيّة؟ كذلك ما هي قراءة الإسلامويّة المعاصرة له؟ لطالما اعتبرت الحداثة العربيّة الغرب نموذجاً، بأشكال متعددة، بل أن تحديها له بالكاد يخرج قليلاً من دائرة السياسة والسلطة والدولة ومظاهر التحديث. في المقابل، ناصبت الإسلامويّة حداثة الغرب العداء، على رغم أنها تقرّ له بميزات تكاد تنحصر في دائرة السياسة والسلطة والدولة، إضافة إلى التقدّم العلمي والتقني. المفارقة أن الغرب كان دوماً الملاذ المفضل للإسلامويّين، بل أن شطراً منهم يميل بقلبه مع الشعبوية الغربيّة [الدين والعداء للعولمة] التي ترفضه، بل تحتج دوماً بأنها رد على وجوده في الغرب!
- لطالما اشتكى المفكر الإسلامي محمد أركون من تميّيز الغرب ضد الإسلام من جهة، وانتقد الاستشراق بأنواعه سواء التقليدي أو “التحرري” على غرار كتابات المفكر اليساري كلود كاهن الذي كتب طويلاً عن تاريخ الإسلام من نشأته إلى المرحلة العثمانيّة. وكانت إحدى شكايات أركون البارزة هي عدم قدرة الحداثة والإسلامويّة العربيّة كليهما معاً، على الاستفادة من التطوّر في الفكر العالمي، لتجديد النظر إلى الإسلام وتاريخه ونصوصه ومدارس فقهه وطرائقه في الفكر وغيرها. مثلاً، تأسّست الدولة- الأمة في أوروبا على حماية حرية المعتقد [وتالياً الرأي] وسيلةً إنسانيّة لإنهاء الصراع الديني في أوروبا. ولم تهتم الحداثة العربيّة بالتدقيق في تاريخ الانفصال بين السنّة والشيعة، على رغم أنه لم يتكرس مذهبيًاً إلا في القرن الثالث عشر، فيما كان قبل ذلك صراعاً سياسياً. وكذلك لم تعمل الاسلامويّة المعاصرة بشكل فقهي على صنع صيغ فكرية تجعل من ذلك الانشطار مدخلاً لتصوّرها عن دولة تحمي المعتقدات. وكذلك أشار المفكّر وائل الحلاق تكراراً إلى أن إصرار الإسلامويّة [سنّة وشيعة] على استعادة نماذج الماضي في الحكم، يؤدي إلى استعصاء فكرة الدولة الحديثة عنها، بمعنى أنه حتى قولها بالدولة المدنيّة يبقى فارغاً، ما لم يستكمل بمفهوم المواطنة الحقوقيّة المستقل عن الدين، وهو أساس الدول المعاصرة. والأسئلة لا تنتهي.
- [author title=”أحمد مغربي” image=”http://”]كاتب لبناني[/author]