كتب محرر الشؤون العربية
منذ 25 من الشهر الماضي باشر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالعديد من الإجراءات الاستثنائية التي جاءت في سياق انفجار الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي عاشتها البلاد، وعبرت عن نفسها صراعاً محتدماً بين مكونات وقوى النخبة السياسية الحاكمة. وكان الصراع الذي استغرق العام الماضي تقريباً، قد تجسّد أكثر ما تجسَّد في الصراع المفتوح بين الرئيس سعيّد من جهة أولى، وكل من رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي من جهة ثانية. وهو الصراع الذي سرعان ما انضوت فيه الكتل والقوى السياسية والنقابية.
وتعود جذور وأسباب هذا الصراع إلى نتائج ما توصلت إليه انتخابات العام 2019 من ظهور أغلبية برلمانية منقوصة، ورئيس دولة جاء من خارج المنظومة الحزبية القائمة، مستنداً إلى مناخات شعبية معاديةٍ للأطر الحزبية القائمة، ما عنى استمرار الأزمة وتفاقمها في مختلف المراتب والمستويات. واذا كانت مناقشات البرلمان وما شهدته من مواقف واشتباكات كلامية حادة، هي الأكثر دلالالة في ضوء طروحات ومواقف مختلف القوى، الا أن مناخات الانقسام والتشرذم شملت مختلف دوائر الدولة والمجتمع. يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، والتي تفاقمت مؤخراً مع الموجة الأخيرة من تفشي جائحة كورونا، وما قادت إليه من ضحايا وخسائر بشرية وإصابات، عبرت عن عجز القطاع الصحي عن الإحاطة بها والتعامل معها واحتوائها. وقاد تفشي كورونا مع ما سبقه من صراع سياسي إلى شل القطاع السياحي على نحو شبه كامل. وقطع شرياناً حيوياً من شرايين الاقتصاد في قطاع الخدمات الذي يعتمد على تدفق السياح الاوروبيين إلى البلاد، وإدخالهم عملات صعبة البلاد بأمس الحاجة إليها. وقد نجم عن ذلك انهيار في الاقتصاد التونسي العالق في أزمةٍ مستفحلةٍ مع غياب الإصلاحات المطلوبة، وهو ما يعبّر عنه تطوّر حجم الدين العام الذي ارتفع من 45% من الناتج القومي العام 2010 إلى حوالي 100% في هذا العام.
وانفجار الأزمة على النحو الذي أملى الاجراءات الاستثنائية جاء ليعبر عن الصعوبات التي تواجهها تجربة “ثورة الياسمين” في الانتقال الديمقراطي السلمي السلس الذي أطلقته بعد إطاحة نظام زين العابدين بن علي بداية العام 2011. وسجل فرادة تونسية مثلت الاستثناء الديمقراطي، بالقياس إلى ما شهدته الانتفاضات العربية من تحولات دموية دراماتيكية. قادت إما إلى تسلم العسكر زمام الأمور كما حدث في مصر والجزائر، أو الغرق في الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية كما أصاب اليمن وسوريا والعراق. وبالأصل، فان تجربة تونس الديموقراطية كانت تعاني من حصار خانق. فعلى حدودها الشرقية تشهد ليبيا صعوبات بالغة في اعتماد مسارات سياسية تعيد بناء مؤسسات الدولة الواحدة، نتيجة تفكك البنية الأهلية الداخلية وتدخل القوى الدولية والاقليمية الخارجية في الكبيرة والصغيرة. وعلى حدودها الغربية الجزائر، حيث هناك الصعوبات التي تعيشها البلاد في اعتماد خط تغيير فعلي بعد سقوط محاولات تجديد نموذج حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبروز مقاسمة للسلطة السياسية يقف وراء مراكز قواها الفعلية المؤسسة العسكرية الممسكة بزمام الأمور فعلياً وإن من وراء ستار باهت. وهو ما يذكر بفترات الحكم السابقة على الانتفاضة الجزائرية. ثم هناك الوضع الدولي المشدود في غضون الأعوام السابقة إلى علاج مضاعفات وباء كورونا على الاقتصادات الاوروبية، وتخصيص الموارد لانتشاله من الهوة التي أسقطه فيها الشلل. وكذلك الموقف الاميركي في اطار تحوله من الترامبية إلى إدارة بايدن وسياساته الخارجية بالعلاقة مع الحلفاء التقليديين والأولويات الآسيوية والاوروبية المعتمدة في أجندته. ويضاف إلى ذلك كله توافر وجود قوى داخلية لا يستهان بنفوذها، تُحسب على قائمة قوى الثورة المضادّة التي تطمح إلى جذب تونس إلى مدارها، ووضعها في سياق حسابات فئوياتها ومنازعاتها الدولية والاقليمية. اختصاراُ يمكن القول إن التجربة التونسية الواعدة تعرضت من الاقليم والداخل إلى ضغوط أنظمة الاستبداد العربي المقيم من جهة، والاطراف الداخلية المعادية لأي انتقال ديمقراطي يضع البلاد على سكة الحداثة العربية ويجنبها مرارة التجارب المجهضة.
وبناءً عليه، أثارت اجراءات سعيّد كل المكنونات التي عرفها التونسيون لجهة العودة إلى سلطوية مراحل إدارة البلاد في عهدي زين الدين بن علي ومن قبله الحبيب بورقيبه. إذ ليس أمراً بسيطاً تجمع هذا الكم من السلطات في يد الرئيس دون سواه، وإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، ما يعني أن هناك شروعاً في اعتماد آليات تصب في المحصلة في عملية تغيير قواعد الحياة السياسية في البلاد. الأمر الذي يتطلب تعديلات دستورية تجعل من النظام السياسي نظاماً رئاسياً كامل المواصفات، وعلى حساب المؤسسات السياسية التمثيلية والاجرائية التنفيذية. وهو ما من شأنه أن يشكل ارتداداً على التجربة الديموقراطية اللتي أرستها الثورة منذ اندلاعها، وخلال المراحل والممرات التي عبرتها رغم سيل الصعوبات والظروف القاسية.
والواقع أن القوى والأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية التونسية ساهمت إلى هذا الحد أو ذاك في تعميق الأزمة. ولا سيما حزب النهضة الاسلامي الذي تمحور جل طموحه على الامساك بمفاصل البلاد، وتحقيق أكثر مما حصل عليه في صندوقة الانتخابات من نتائج. لكن الأكثر دلالة من ذلك كله، ما يتردد من مسؤوليته عن الاغتيالات التي شهدتها تونس، والتي ربطتها المعارضة بشخص راشد الغنوشي رئيس السلطة التشريعية، من خلال إشرافه على جهاز أمني سري يتبع له، تولى تنفيذ مثل هذه المهام القذرة، ولم تنجح التحقيقات الرسمية في حينه بوصولها إلى الكشف عن هوية الفاعلين الحقيقيين. وقد أعيد فتح هذا الملف مؤخراً مع المطالبات القانونية بحل حزب النهضة ومحاكمته كتيار اسلامي له دوره في تعقيد الحياة السياسة التونسية وايصالها إلى المفترق الخطير الذي بلغته. ولعل معضلة النهضة وسواه من تيارات اسلامية مشابهة تكمن في أمرين: أولهما اعتبار مشاركتها في التجربة التونسية مدخلاً لمصادرة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقابي والحياة الديموقراطية في البلاد . وثانيهما ما أفرزته هذه المشاركة من ظهور أجهزة بيروقراطية استشرى فيها الفساد، وتحوّلت إلى جماعاتٍ ريعيةٍ تنهب مقدّرات الدولة، وتشلها عن تقديم الخدمات للمواطنين الفقراء ومن أبناء الطبقة الوسطى، وبالتالي علاج المعضلات المستفحلة في الاقتصاد والمجتمع.
ومما لاشك فيه أن الاستقطابات السياسية الحادة في غضون الفترة المنصرمة أدت إلى تعدد مراكز القوى وتعطيل قدرات الحكومات، ما جعل الأوضاع دوماً تسير من سيء إلى أسوأ. وأذكت الصراعات بين القوى العلمانية والاسلامية التي كانت تنتهي دوماً بمصالحات هشّة وتوافق على وضع دستور 2014 موضع التطبيق، الذي أسّس لنظام هجين ومختلط، منح الرئيس بموجبه مسؤولياتٍ أساسية، مقابل إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة. الأمر الذي نجم عنه صراع جديد بين الرئاسات، وغياب دور الدولة في التخطيط التنموي المراعي للتوازنات الطبقية والمناطقية والقطاعية، مقابل جنوح مجموعاتٍ وقوى حزبية إلى الابتزاز والسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة من أجل تلبية مصالحها الفئوية، وتمتين علاقات المصالح القائمة بينها وبين قوى المال والأعمال وشبكات الفساد، ما زاد من حدّة معاناة الفئات الوسطى والفقيرة، وعزوفها عن التفاعل مع متطلبات الانتقال الديمقراطي. لذلك ارتفعت أصوات من داخل الأحزاب القائمة، تطالب قياداتها بالتنحّي، وإفساح المجال أمام قيادات شابة جديدة، وألقت باللائمة على سلوكها وتصرّفاتها وتحالفاتها التي أفضت إلى النكوص عن مسار الانتقال الديمقراطي المنشود.
لم يتجسّد الصراع السياسي التونسي بين أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، بل في صراع المواقع والصلاحيات بين مؤسسات الحكم الثلاث، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة. واتسم المشهد العام بتوازناتٍ ضعيفة وهشّة، وصراع يومي على المحاصصة والفئوية، والاختلافات على المواقع والصلاحيات بين المؤسسات الثلاث، الأمر الذي أتاح صعود ظواهر شعبوية، بوصفها تعبيراً عن فشل النخب الحاكمة في تلبية متطلبات حاجات العامة، كونهم المتضرر الأكبر من الأزمات السائدة.
رغم كل ما سبق، يمكن القول إن الأمل يبقى معقوداً على القوى السياسية والنقابية الحيّة في المجتمع التونسي التي ترفض وضعها بين خيارين أحلاهما مرُّ هما: الديكتاتورية وحكم الفرد أو الفوضى الأهلية. إن هذه القوى هي المؤتمنة على استكمال عملية الانتقال الديمقراطي، واستعادة الدعم الشعبي من خلال إيلاء همومه السياسية والمعيشية الاهتمام الذي يستحق. وبالتالي العمل على تحقيق مطالبه في الحياة الكريمة، وبما يحمي تجربة تونس من الانزلاق عن مساراتها الديموقراطية أو العودة إلى الوراء نحو أشكال من التسلطية والديكتاتورية والفوضى الأهلية.


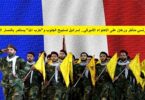





Leave a Comment