واشنطن: إيلي يوسف*
بعيدا عن المناكفات السياسات الحزبية الضيقة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن القول بقليل من الحذر، إن مساءلة الرئيس الأميركي جو بايدن والتشكيك بمكانته وبقراراته، وحتى بمستقبله السياسي وحزبه الديمقراطي، ما كانت لتطرح في هذه الفترة القصيرة من عهده الرئاسي، لولا “التخبط” الذي ظهرت فيه عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
لعل الإجماع يكاد يكون كاملا بأن صورة أميركا تعرضت للخدش في ظل الارتباك الذي عانته إدارة بايدن، مع صور الفوضى التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في مطار كابل أو المطارات الأميركية التي كانت تستقبل قوافل المرحّلين الأفغان. لكن من بين الأسئلة الرئيسية المطروحة الآن، سواء في الولايات المتحدة أو لدى الحلفاء والخصوم معا: هل كان خطأً تمسك بايدن بموعد 31 من أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الانسحاب، أم كان كلفة ارتضاها في هذه المرحلة المبكرة، ليتجنب خسارات كان من الممكن ان تكون كلفتها أكبر في مرحلة متقدمة من عهده؟ وهل ما جرى يعكس انزياحا أميركيا رئيسيا، يؤشر إلى عهد جديد دخلته سياسات الولايات المتحدة على قاعدة الشعار إياه… “أميركا أولا”، في علاقتها ونظرتها نحو مصالحها في العالم؟
نعم، لقد خلف الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد الحملة العسكرية السريعة التي شنتها حركة “طالبان”، وأحكمت فيها قبضتها على عموم البلاد، أسئلة كثيرة أخرى طرحت وسيطرح غيرها الكثير. وقد يحتاج الامر إلى أشهر أو إلى سنوات، لمعرفة ما سترسو عليه المعادلات الجديدة التي بدأت ترتسم على الأرض. إذ إن الارتباك لم يصب إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية وحدها، بل أصاب خصومه السياسيين في الداخل، وحلفاءه وخصومه الخارجيين على حد سواء.
وفي حين يراهن أنصار الرئيس بايدن على “ذاكرة الأميركيين القصيرة”، وانجذاب الرأي العام عادة للسياسات الداخلية، للحكم على أدائه، فإن الانقسام داخل تيارات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يظهر وجهات نظر أكثر جذرية تجاه السياسة الخارجية. وهي انقسامات حقيقية تشير إلى ان المؤسسة السياسية الأميركية بضفتيها، لا تزال تبحث عن صيغة موحدة حولها، خلال ابتعادها عن الأزمات الدولية والإقليمية التي طبعت شراكاتها مع حلفائها الأوروبيين، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.
بين بايدن وترمب
في مراجعة سريعة لما أنجزه بايدن خلال الأشهر السبعة التي انقضت من عهده، يمكن القول إنه لا يزال ملتزما بشكل لافت بأجندة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب. إذ نفذ الانسحاب السريع والكامل من أفغانستان الذي تفاوض عليه العام الماضي مع حركة “طالبان”. وأبقى على التعريفات الجمركية كلها ضد الصين، وكذلك على واردات البلاد من المعادن. أيضا واصل بايدن سياساته التي تسمح بالترحيل السريع لطالبي اللجوء بحجة الاخطار الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.
من ناحية أخرى كان بايدن قد خطط أيضا للحفاظ على الحد الأقصى السنوي المنخفض الذي وضعه ترمب لقبول اللاجئين عند 15 ألفا، ورفعه إلى 62 ألفا، فقط، بعد احتجاج التيار اليساري. وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الشهر الماضي، ان إدارة بايدن دعمت انتهاء صلاحية بعض التأشيرات، وأيدت متطلبات أكثر صرامة للبطاقة الخضراء، ودعمت رفض الإقامة الدائمة لآلاف المهاجرين القانونيين، ودافعت عن عدد من قضاة المحكمة الذين عينهم ترمب في ملف الهجرة. كما اتُهمت إدارة بايدن بانتهاك الحماية للأطفال المهاجرين المحتجزين لدى الحكومة، تماما كما فعلت إدارة ترمب. وحتى قراره بإلغاء سياسة “البقاء في المكسيك” ألغتها المحكمة العليا التي كان ترمب قد مددها لعام واحد وانتهت في 31 أغسطس/آب. كما حقق بايدن هدف ترمب المتمثل في صفقة إنفاق ضخمة على البنية التحتية بقيمة تقارب 4 تريليون دولار، وواصل سياسة الانفاق المفرط وزيادة العجز. كما أنه لم يتخل عن دعم أصدقاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج ووافق على مواصلة صفقة الطائرات لدولة الامارات بقيمة 23 مليار دولار، وأعطى موافقته على مواصلة مد خط الانابيب الروسي إلى ألمانيا، لكنه فرض عقوبات على روسيا بسبب هجماتها الإلكترونية على “المصالح الأميركية”. ولم يرفع سياساته المتشددة عن كوبا، التي رفض قادتها الجدد الانضمام إلى مظلة المصالح الأميركية، رغم اليد التي مدّها إليهم أوباما قبيل مغادرته منصبه. كما لم يُعد بايدن بلاده ببساطة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ورغم عودته إلى منظمة الصحة العالمية، إلّا ان استجابة إدارته لمشاركة فائض اللقاحات التي تفوقت في اختراعها الولايات المتحدة، والمواد الخام مع العالم، كان بطيئا. وتجاهل نداءاتها بأن الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح يمكن ان تنتظر قليلا، حتى يتم تلقيح المزيد من شعوب العالم لوقف تحور الفيروس على الأقل.
ولكن لماذا هذا الانتقاد لسياسات بايدن؟ وهل السياسات الشعبوية، اليمينية واليسارية، هي المسؤولة عن هذا الاختناق الذي يقسم المجتمع الأميركي؟
مما لا شك فيه أن قصوراً لوجستيا قد وقع خلال تنفيذ الانسحاب من أفغانستان. وسقوط 13 جنديا أميركياً في الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش في الأيام الأخيرة، عزز من الانتقادات. لكن قلما شهدت الولايات المتحدة انقساماً داخلياً أمام خطر خارجي يداهمها، وتعالت فيها الدعوات لعزل الرئيس. وعلى سبيل المثال، لم يدع معارضو الرئيس ريغان إلى إقالته، عندما سقط نحو 240 جنديا أميركيا في التفجير الانتحاري قرب مطار بيروت عام 1983.
“أميركا أولاً” والعالم؟
أغلب الظن ان الهجمات المكثفة التي يتعرض لها بايدن اليوم، تعود إلى الحزبية الضيقة ومحاولة التركيز على “الصفات” الشخصية ومقارنته بترمب. فالجمهوريون اليوم بغالبيتهم، مغرمون بأسلوبه في مهاجمة المؤسسات والإدارة عبر تغريداته وكلامه العنيف، وخصوصا دفاعه عن البيض. لكنهم غافلون أو على الأقل لا يريد قادتهم الاعتراف بالتحولات العميقة التي تشهدها السياسات الأميركية منذ أكثر من عقد، والتي بدأت مع عهد باراك أوباما، واستمرت مع ترمب، وها هي تتعزز وتتوضح بشكل أكبر مع بايدن.
وفيما لا تزال رؤية “أميركا أولاً” للرئيس ترمب، الذي أبرم الاتفاق مع طالبان كجزء من تعهده بإنهاء “الحروب الأبدية”، قوية في معظم أركان الحزب الجمهوري وقاعدته، لا تزال بعض الأصوات المؤثرة تستمر في تبني نهج تدخل قوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقبة بوش و”حربه على الإرهاب”.
في بداية أغسطس/آب، عكس استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي بي إس نيوز”، مدى الارتباك والتشويش لدى قاعدة الحزب. وأوضح الاستطلاع ان 94 في المئة من الناخبين المؤيدين لترمب، يعارضون سياسات بايدن، بينهم 86 في المئة يعارضونه بشدة. كما أعلن 61 في المئة منهم أنهم لا يوافقون على الانسحاب الذي تفاوض عليه ترمب من أفغانستان. حتى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي قال الأسبوع الماضي، إن “الطريقة الوحيدة التي نريدها هي أن يكون هناك قوات في أفغانستان للتأكد من عودة الأميركيين بأمان”. وبعد ذلك بدقائق قليلة، اقترح مكارثي أنه كان سيقوم “بفحص وصيانة قاعدة باغرام الجوية” شمال كابل، كموقع أمامي دائم “للنظر في الأفق” لردع أي نشاط إرهابي في المستقبل. وهي خطوة قال مسؤولو البنتاغون إنها تتطلب نشر آلاف أخرى من القوات على الأرض لحماية القاعدة. ويوم الثلاثاء الماضي قال مكارثي إنه سيذعن لما تقترحه قيادة البنتاغون بشأن وجود عسكري طويل الأمد في أفغانستان. وفي نهاية المطاف أضاف: “علينا أن ندع الجيش يتخذ هذا القرار”. ورغم ان مكارثي الذي تولى منصبه عام 2007 كمؤيد قوي لبوش، وحافظ على علاقات وثيقة مع شخصيات ممن روجوا لرؤيته عن الإرهاب في واشنطن، قد غادر تلك السياسات، إلّا ان الارتباك الجمهوري يتبدى أكثر في مجلس الشيوخ، حيث يتبنى البعض نهج الصقور التقليدي الذي جسده السيناتور الراحل جون ماكين. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، الذي اصطدم بترمب بشأن تلك الرؤية، لا يزال يدعو إلى دور “أكثر قوة” في الشؤون الخارجية وانتقد بشدة تعامله وبايدن مع أفغانستان. وقال يوم الثلاثاء في بيان إن “هذه المعركة لن تنتهي لمجرد أن سياسيينا يريدون التخلص منها”.
لكن نبرة بايدن القوية يوم الثلاثاء وتحديه منتقدي انسحابه، للدفاع عن الإبقاء على الوجود الأميركي في أفغانستان، والخسائر التي قد تلحق بأفراد الخدمة، اعتبرت مؤشراً على الأرجح لإدارة الانقسامات وتأجيجها بين الجمهوريين، إذا واصلوا انتقاده. لكن تصريحات لافتة للنائب الجمهوري مات غايتز من فلوريدا، وأحد مؤيدي ترمب، أشارت إلى التبدلات التي يشهدها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، في النظر إلى كيفية “تغيير العالم” و “تعميم الديمقراطية”، التي قال بايدن انها ليست مهمتنا. قال غايتز: “إذا كان هناك أي شيء، فإن إخفاقاتنا الأخيرة في أفغانستان تظهر الإخفاقات المنهجية لبناء الدولة”. “كان من الممكن أن نبقى في أفغانستان خمسة أيام أخرى، أو خمسة أسابيع، أو خمسة أشهر، أو خمس سنوات، ولن نغير النتيجة النهائية”.
وفيما يدعم الناخبون الديمقراطيون بايدن لأنه أعاد “الهدوء والاستقرار إلى واشنطن”، وأوقف “تهشيم” المؤسسات الديمقراطية، وألغى العديد من سياسات ترمب في مجالات مثل تغير المناخ والحقوق المدنية والاستجابة للفيروس. إلّا أن خيبات الأمل أصابتهم أيضاً وخصوصاً لدى الجناح اليساري، في العديد من سياساته، في ظل احتفاظه بالعديد من السياسات الشعبوية لسلفه، كالحمائية التجارية والإنفاق الكبير وحتى في سحب القوات، التي لطالما طالبوا بإلغائها حتى من قبل ظهور ترمب.
خسارة الانتخابات النصفية “تقليد” رئاسي
بيد ان خيبات الأمل تلك قد لا تكون هي السبب المباشر عن احتمال خسارة الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفية العام المقبل. فالتجارب والشواهد التاريخية التي توضح كيفية اشتغال “النموذج الأميركي” في تداول السلطة، تظهر أن غالبية الرؤساء كانوا يخسرون الغالبية، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، بعد عامين من بداية عهودهم. هكذا خسر كلينتون وبوش الابن وأوباما وترمب الغالبية في مجلس النواب بعد عامين من رئاستهم. ويردّ البعض هذا “التمرين” الانتخابي الذي يقبل عليه الاميركيون، إلى أصول وتقاليد عقائدية بروتستانتية، أرساها المؤسسون الاميركيون الأول. فالسلطات الهائلة التي يمنحها الدستور الأميركي للرئيس، قد تمنحه سلطات هائلة ومطلقة، وهو ما لم يرده المؤسسون. لذا سعوا إلى تقليص تلك السلطات وتشتيتها عبر منحهم مجلسي الشيوخ والنواب سلطات كبيرة ومعطلة في سن القوانين وإقرارها.
لذا كان الانسحاب من أفغانستان، الذي تعرض لانتقادات شديدة، تحديا كبيرا وخطيرا للديمقراطيين وخطتهم للتركيز على القضايا المحلية. لكنه كشف في المقابل عن مدى فشل الجمهوريين في طرح رؤية واضحة للعالم، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية والتدخل العسكري، بما يتجاوز إدانتهم الموحدة لبايدن. ولعل هذا الامر يكشف عن تحولات استراتيجية لا بد من مراقبتها مستقبلا، في ظل قلة “الكتابات الأميركية” والنظريات الجديدة التي سيجري اعتناقها، مع مغادرة الولايات المتحدة سياساتها الكولونيالية التقليدية المتأثرة بالفكر الأوروبي، الذي هيمن على العقل الغربي والعالمي لقرون، وكان الاميركيون قوته العسكرية المقاتلة منذ 100 سنة وحتى اليوم.
أوروبا الخاسر الأكبر
عاشت أوروبا “شهر عسل” مع واشنطن بعد وصول بايدن إلى السلطة. ومن “قمة بروكسل” الأطلسية خلال يونيو/ حزيران الماضي، وأيضاً من قول رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، لبايدن أمام وسائل الإعلام: “عادت أميركا إلى الساحة العالمية.. إنها أخبار رائعة لتحالفنا وأخبار رائعة أيضا للعالم”. تراجعت الحماسة في ضفة الأطلسي الاوروبية، بعدما ظهر أن بايدن لم يتراجع عن سياسة “أميركا أولاً”، مع احتفاظه بالترويج لعلامته التجارية الخاصة من الشعبوية الاقتصادية، والإبقاء بشكل كامل على قائمة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية التي فرضها ترمب.
حتى المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتنقل الاميركيين والأوروبيين في ظل جائحة “كوفيد-19″، عكست احباطاً أوروبياً واسع النطاق من رفض بايدن رفع حظر السفر العقابي المتعلق بالوباء على مواطني الدول الأوروبية. ولعل السخط الأوروبي من المعاملة غير العادلة في مواجهة الوباء، ليس إلّا عينة بسيطة عن تنامي السخط والتشكيك بحلف شمال الأطلسي (ناتو) نفسه. وهنا يقول فرانسوا هايسبورغ، كبير مستشاري أوروبا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قد يُنظر إلى الامر على أنه “تصويت أوسع بعدم الثقة في الإدارة الأميركية”.
ولعل الطامة الكبرى التي خيمت على العلاقات الأميركية الأوروبية، تكشفت في المداولات على استيلاء طالبان المفاجئ على أفغانستان والتعامل الفوضوي مع الانسحاب الأميركي، الأمر الذي زعزع ثقة الأوروبيين بقرارات بايدن وأولوياته. فقد ضغط القادة الأوروبيون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بايدن لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب. لكن الرئيس الأميركي لم يتزحزح، مصراً على إنجازه لإنهاء أطول حرب أميركية: “لم يعد لها أي مبرر”. واختتم خطاباته لتبرير إصراره على قرار الانسحاب يوم الثلاثاء، بنبرة فيها الكثير من الحدة، تجاه الداخل والخارج معا.
بالنسبة إلى الأوروبيين لا سيما في البلدان التي استثمرت في دعم مهمة الناتو في أفغانستان، كانت احداث الأسابيع الماضية اختباراً داخلياً لمناعة الحلف ولحقيقة الأهداف الأميركية مستقبلاً. وفي حين أعرب المسؤولون الأوروبيون عن مخاوفهم بشأن المحنة الإنسانية في أفغانستان، فضلاً عن احتمال حدوث تدفقات جديدة ضخمة من اللاجئين الأفغان، فإنهم شكوا أيضاً من غياب التشاور الحقيقي مع إدارة بايدن. ولعل تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بغداد عندما قال “إن فرنسا باقية في العراق مهما كان القرار الأميركي”، وقيامه بجولة استعراضية في أحياء بغداد ومدينة الموصل، تعكس تلك المخاوف من أن يكون أي انسحاب أميركي جديد من المنطقة على حساب الأوروبيين، فضلا عن تذكيرها باستعراضات المستعمرين الأوروبيين الأوائل وزياراتهم لمستعمراتهم.
ونقلت “واشنطن بوست” عن كونستانزي شتيلزنمولر، الخبير في الشؤون الألمانية في معهد بروكينغز، قوله لصحيفة “وورلد فيو” بلهجة عتاب: “نحن لسنا جزراً. قرارات حلفائنا لها عواقب على حلفائهم… هناك انطباع بأن الناس يضعون السياسة في فراغ عندما لا يكون هناك تنسيق”.
أكثر من ذلك، أضاف الشعور بالكارثة جرّاء ما جرى في أفغانستان، إلى المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة، حول حاجة أوروبا إلى سياسات استراتيجية أكثر استقلالية عن واشنطن. وهو ما عبر عنه أرمين لاشيت، المرشح الديمقراطي المسيحي لخلافة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عندما قال في مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي: “يجب أن نعزز أوروبا بحيث لا نضطر أبداً إلى ترك الأمر للأميركيين”. وبينما وصف الانسحاب من أفغانستان بأنه كان “أكبر كارثة يعاني منها (الناتو) منذ تأسيسه”، تساءلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي “هل اعتقدنا فقط أنه كان علينا أن نتبع الولايات المتحدة ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في الليل؟”
لقد كانت الحرب في أفغانستان أول مهمة في تاريخ حلف الناتو تطبيقا للمادة الخامسة، من بند الدفاع الجماعي للحلف. لكن تجاهل بايدن لتبعات الانسحاب على الحلف، قد يترك أثاراً مدمرة على مكانة أوروبا. وحسب شتيلزنمولر “ما سيتغاضى عنه الناس هو أن جيلاً كاملاً من الغربيين، بما في ذلك عسكريون ودبلوماسيون ومسؤولو استخبارات وصحفيون، مروا بأفغانستان. هذه هي أكثر مهام الناتو شرعية، وهي المهمة الأكثر أهمية في فهمنا لأنفسنا”.
وقال بنجامين حداد، مدير مركز أوروبا في المجلس الأطلسي، “بالنسبة لدول مثل ألمانيا وبريطانيا، التي استثمرت بكثافة في أفغانستان، في رأس المال السياسي والقوات والأموال، كانت العملية تتعلق بالتزامهما تجاه الناتو والتحالف”. وأضاف، “هذا هو السبب في أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة كان بمثابة صدمة حقيقية لهذين البلدين لأنه يشير إلى تحول في أولويات الولايات المتحدة، أعمق من الشخصيات والخطابات الرئاسية”. وكتب ستيفن والت في فورين بوليسي، “هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً للغاية. كانت أوروبا محور السياسة الخارجية للولايات المتحدة في معظم القرن العشرين وخاصة خلال الحرب الباردة، لكن انهيار الشيوعية وصعود الصين وآسيا وحروب ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، وحملات مكافحة الإرهاب، حولت أولويات الولايات المتحدة إلى أماكن أخرى”. وأضاف، “ترمب كان أول رئيس أميركي يصيغ هذه الأفكار بشكل علني، والآن تخشى النخبة الأوروبية أن هذا ربما لم يكن مجرد انحراف”. وينهي حداد بالقول، إن دور بايدن “يجب ألّا يثير الخوف في أوروبا. دعونا نذهب إلى أبعد من” أميركا عادت” ونجري محادثة صريحة بين الحلفاء حول ما لا يريد الأميركيون فعله بعد اليوم، حيث يتعين على الأوروبيين تحمل المسؤولية”
*عن جريدة الشرق الأوسط في 4 / 9 / 2021


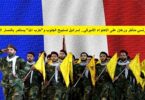





Leave a Comment